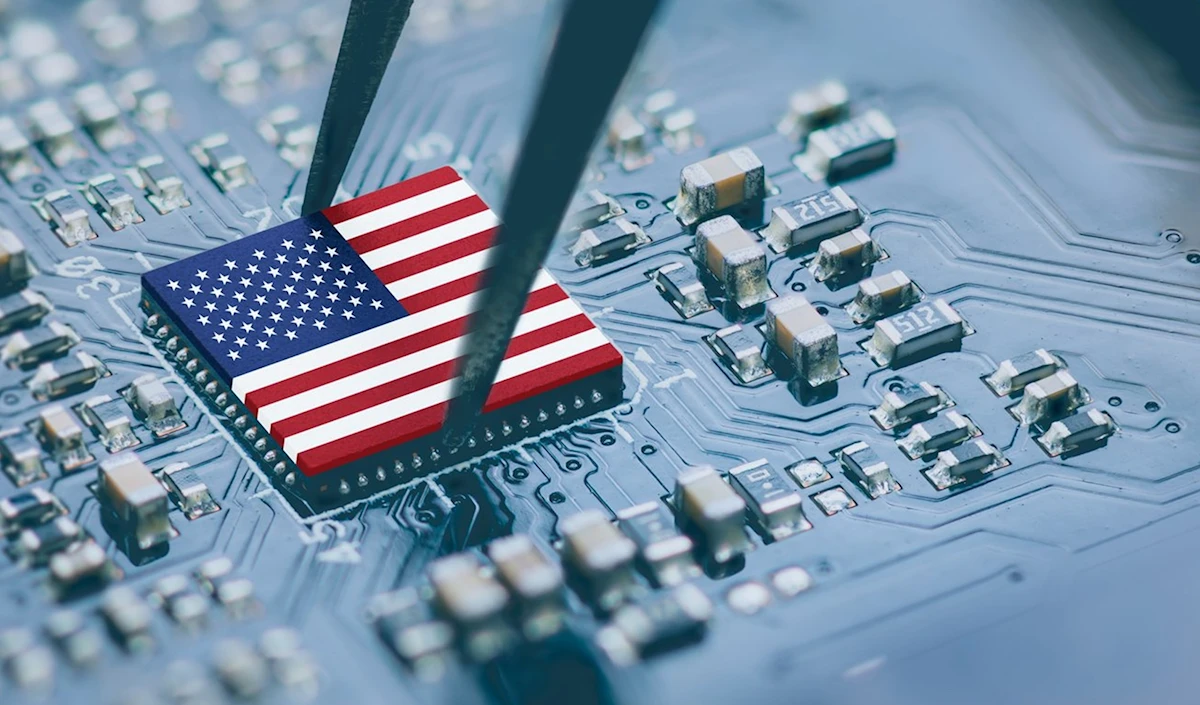علي عواد/ جريدة الأخبار
تفرض الشركات الأميركية حضورها على البنية الرقمية العالمية، من الشرائح والمعالجات إلى البرمجيات والمنصّات التي تشكّل حياة البشر اليومية. وتشهد السنوات الأخيرة تحوّلًا متسارعًا يدفع دولًا ومجتمعات إلى البحث عن استقلال تقني يحدّ من هذا النفوذ
من المفهوم أن يصف بعضهم التكنولوجيا بأنّها آخر ما تبقّى للبشرية من عالم السحر، فهي أحد أهمّ مسارات الارتقاء المادي التي يسلكها الإنسان لفهم العالم والإفادة من موارده وبناء عمارة المعرفة في الوعي البشري. وهي، بالتوازي، أداة يمكن توظيفها للهيمنة ومختلف أشكال الشرّ والاستغلال.
عبر التاريخ، سعى معظم الذين وصلوا إلى تكنولوجيا متفوّقة أو اكتشفوها أو طوّروها قبل غيرهم، إلى استثمارها في توسيع رقعتهم الجغرافية وتعزيز مواردهم وتثبيت سلطتهم وفرض أفكارهم.
لذلك، ما نشهده اليوم من هيمنة شركات التكنولوجيا الأميركية على معظم مفاصل العالم الرقمي بكلّ انعكاساته ليس حدثًا طارئًا في السياق التاريخي. وفي عالم صار مدمجًا بالرقمنة الأميركية في غالبية جوانبه، ومع إدارة أميركية متحالفة مع «إخوان التكنولوجيا» (تسمية تُستخدم للإشارة إلى مجموعة رجال وادي السيليكون الذين يشكّلون دائرة النفوذ الأكبر في صناعة التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي: بيتر ثيل، جيف بيزوس، إيلون ماسك، مارك زاكربيرغ وغيرهم.)، يحضر السؤال الكبير: هل يمكن للشعوب والحكومات أن تتحرّر من هذه القبضة؟
يمكن تقسيم التكنولوجيا الرقمية إلى جزأين: برمجيات وأجهزة. في الأجهزة، تمسك الولايات المتحدة بمفاتيح التصنيع المتقدّم عبر الشركات التي تتحكّم بالشرائح الإلكترونية، ومعها سلاسل الإمداد التي تمتد من مصانع تايوان وكوريا الجنوبية وصولًا إلى المختبرات البحثية في كاليفورنيا.
في البرمجيات، تسيطر الشركات الأميركية على الأنظمة الأساسية التي تُبنى فوقها حياة البشر اليومية: أنظمة التشغيل (ويندوز، ماكنتوش، آي أو أس...)، تطبيقات التواصل الاجتماعي، محركات البحث، خدمات الحوسبة السحابية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
هذه الهيمنة المزدوجة، أجهزة وبرمجيات، جعلت أيّ محاولة للتحرّر الرقمي مسألةً معقّدة. فالمجتمعات التي تتخيّل أنّها تستطيع بناء استقلال رقمي عبر تطوير «تطبيقات محليّة» أو «منصّات وطنية»، غالبًا ما تكتشف أنّ بنيتها التحتية مرتبطة حتى العظم بشركات أميركية تتحكم بالمعايير، والتوزيع، والبرمجيات المغلقة، وحتى بطريقة الاتصال نفسها.
الأهمّ من ذلك أنّ الولايات المتحدة حوّلت التكنولوجيا إلى أداة جيوسياسية: التحكم بالمعالجات، ومنع التصدير، وإدراج الشركات على لوائح العقوبات، كلّها أدوات تهدف إلى بسط النفوذ العالمي عبر بوابة التكنولوجيا.
اللافت أنّ إدارة ترامب الحالية ــــ نتيجة حلفها مع أقطاب وادي السيليكون ـــ تدفع بهذا المنطق إلى أقصاه: سباق محتدم مع الصين لحسم مستقبل الذكاء الاصطناعي، وضغوط على الشركات الأميركية لتوجيه تطوير النماذج بما يتوافق مع «القيم الأميركية»، وتوسيع النفوذ الرقمي إلى أقصى مدى ممكن.
ضمن هذا المشهد، يصبح سؤال التحرّر أصعب. فالدول التي تحاول بناء نماذج ذكاء اصطناعي محلية تصطدم بندرة المعالجات، ونقص الكفاءات، وغياب بنية البيانات. فما الذي يمكن فعله؟
المصدر المفتوح
الحقيقة أنّ العالم الرقمي حلّ هذه المشكلة منذ منتصف القرن الماضي عبر ما يُسمى «المصدر المفتوح». تخيّلوا أن تشتروا سيارة يمكنكم قيادتها، غير أنّه لا يُسمح لأحد بفتح غطاء المحرّك، فلا يستطيع السائق تغيير نوع الزيت، أو معرفة نوع المحرّك وكيف يعمل، أو حتى تعديل نظام امتصاص الصدمات. هذا المشهد يعبّر عمّا يحدث في عالم البرمجيات.
صُنعت البرامج والتطبيقات التي يستخدمها الناس حول العالم عبر كتابة أسطر برمجية وضعها مبرمجون أو شركات، ويجري التعامل معها عبر الواجهة فقط: أزرار، خانات للكتابة، قوائم وغيرها. غير أنّه لا يمكن لأيّ مستخدم أو مبرمج الاطلاع على الشيفرة التي بُني عليها البرنامج، أو تعديلها، أو فهم كيفية عمله من الداخل.
بدأت فكرة النظام المفتوح في خمسينيات القرن الماضي، عندما طلب بعض المبرمجين والباحثين إجابة عن سؤال بسيط: لماذا تُعامل البرمجيات على أنّها أسرار صناعية مغلقة فيما هي نتاج معرفة إنسانية مشتركة؟ ظهرت هذه الفكرة داخل الجامعات والمختبرات البحثية حيث كان المبرمجون يتبادلون سطور البرمجة بحرّية، ويعدّلون عليها، ويطوّرونها مع بعضهم. من هنا تأسّس مفهوم «البرمجيات الحرة»، وتطوّر لاحقًا إلى ما نعرفه اليوم باسم «المصدر المفتوح».
أساس المصدر المفتوح مبدأ واضح: «الشيفرة ملكٌ لمن يستخدمها». بدلًا من التعامل مع البرنامج مثل سيارة لا يمكن فتح غطائها، يمنح النظام المفتوح حقّ رؤية الأسطر البرمجية، وفهم بنيتها، وتعديلها بما يلائم حاجات المجتمع أو المؤسسة أو حتى الفرد.
يتحوّل المستخدم إلى مشارك فعليّ في تطوير الأداة، ويصبح البرنامج دائم التطور بفعل مشاركة آلاف العقول حول العالم.
بدائل برمجية مفتوحة المصدر
في مجال البرمجيات، تتوافر بدائل مفتوحة المصدر لكلّ شيء تقريبًا. بدلًا من نظام التشغيل «ويندوز» التابع لشركة «مايكروسوفت»، يمكن تنصيب نظام «لينكس»، وهناك مئات التوزيعات المبنية عليه التي تناسب مختلف الأذواق والحاجات.
بالنسبة إلى برامج «الأوفيس»، يتوافر «ليبر أوفيس»، وبدلًا من تطبيقات شركة «أدوبي» مثل فوتوشوب وبريمير وغيرها، يمكن استخدام «غِيمب» و«دافنشي ريزولف». حتى ألعاب الفيديو المصمّمة للعمل على «ويندوز» تعمل غالبيتها على «لينكس». والجدير ذكره أنّ نسبة لا يستهان بها من مراكز البيانات حول العالم تستخدم «لينكس» في الخوادم والحوسبة السحابية نظرًا إلى استقراره الشديد.
الأجهزة
في مجال الأجهزة، يظهر المصدر المفتوح بصورة مختلفة لكنه يحافظ على الفكرة نفسها: إتاحة التصميمات والمكوّنات للجميع. هناك مبادرات تعمل على تصنيع حواسيب وهواتف تعتمد معايير مفتوحة تمنح المستخدم قدرةً أكبر على فهم الجهاز وصيانته وتطويره. ويتقدّم هذا المسار بخطى بطيئة لأنّ الثقل الحقيقيّ في عالم الأجهزة يتمثل اليوم في دخول الصين على خطّ منافسة الولايات المتحدة.
صناعة الشرائح عملية بالغة التعقيد جزّأتها الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي بين حلفائها. تُطوّر التصاميم داخل المختبرات الأميركية، والماكينة التي تُستخدم في تصنيع الشرائح تُنتجها شركة ASML الهولندية، والتجميع الفعلي يجري في تايوان، والمكوّنات تأتي من دول متعددة أبرزها اليابان والصين وأوكرانيا.
صنعت هذه المعادلة شبكة مترابطة تُعدّ واحدة من أدقّ سلاسل الإمداد الصناعية في العالم. تتحرك الصين داخل هذه الشبكة عبر بناء منظومتها الخاصة لتقليل الاعتماد على الخارج. توسّع الشركات الصينية استثماراتها في تصميم الشرائح، وتعمل على تطوير معدات إنتاج بديلة، وتدعم مصانع محلية قادرة على الوصول إلى تقنيات تصنيع أصغر حجمًا.
يترافق ذلك مع دعم حكوميّ هائل يهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحساسة مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات والحوسبة الفائقة. يتّخذ هذا المسار بُعده الجيوسياسيّ لأنّ التحكم بصناعة الشرائح يعني التحكم بقاعدة القوة التكنولوجية العالمية.
الدول التي تنتج الشرائح تملك قدرة أكبر على حماية بنيتها الرقمية، وإطلاق منتجاتها الصناعية، واستقلال قرارها التقني. يمكن اليوم بناء حواسيب وخوادم ومراكز بيانات من أجهزة صينية بالكامل، وفوقها تثبيت البرمجيات المفتوحة المصدر، وهو أمر لم يكن ممكنًا قبل سنوات قليلة. صحيح أنّ مستوى التكنولوجيا لن يكون مماثلًا لمثيلاته الأميركية، إلا أنّه قريب جدًا منها، ما يعني أنّ الهوّة فعليًا ليست كبيرة.
هذا التطوّر يفتح الباب أمام دول كثيرة ترغب في استقلال تقني أوسع، ويمنح الصين قدرةً أكبر على تقديم بدائل جاهزة تمنح المستخدم مرونة في العتاد والبرمجيات، وتُضعف احتكار الشركات الأميركية لسلسلة الإمداد الرقمية.
ابتعاد عالمي عن التكنولوجيا الأميركية
يشير تقرير «التكنولوجيا السيادية، عالم متشظٍّ» الصادر عن Bain & Company إلى أنّ العالم يدخل مرحلة ما بعد العولمة، إذ تتحوّل التكنولوجيا من محرّك للنموّ الاقتصادي إلى أداة جيوسياسية تعيد تشكيل موازين القوى الدولية. ويرى التقرير أنّ الدول تتجه بسرعة نحو بناء قدرة «سيادية» في الذكاء الاصطناعي والشرائح الإلكترونية بهدف تحصين نفسها من هيمنة الدول التكنولوجية الكبرى.
توضح الدراسة أنّ السيادة الرقمية أصبحت جزءًا من «الأمن القومي» ووسيلة لحماية الدول من إمكانية استخدام الولايات المتحدة أو الصين أدواتهما التكنولوجية بمنزلة سلاح سياسيّ أو اقتصاديّ.
إلى ذلك، يكشف تقرير «وورلد أوف أوبن سورس أوروبا 2025»، الصادر عن مؤسسة «لينكس فاونديشن أوروبا»، إلى أنّ القارّة بدأت فعليًا نقل بنيتها الرقمية نحو البرمجيات المفتوحة المصدر بوصفها ركنًا أساسيًا من مشروع «السيادة الرقمية».
شمل التقرير عيّنة من 316 مشاركًا من شركات تقنية (39 في المئة) ومؤسسات صناعية (42 في المئة) وجهات أكاديمية وحكومية (19 في المئة)، وتُظهر نتائجه أنّ استخدام المصادر المفتوحة أصبح واسعًا داخل أوروبا. تشير الأرقام إلى أنّ 14 في المئة من المؤسسات صارت «نشطة جدًا» في المساهمة بالمشاريع المفتوحة، و28 في المئة مساهمة بدرجة متوسطة، فيما تعتمد 30 في المئة على المصدر المفتوح في عملياتها اليومية. ويطرح التقرير إنشاء صندوق سيادة تكنولوجية أوروبي لتجميع الاستثمارات وتوجيهها نحو مشاريع مفتوحة المصدر، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة القارّة على «التحرّر من مركزية التكنولوجيا الأميركية».