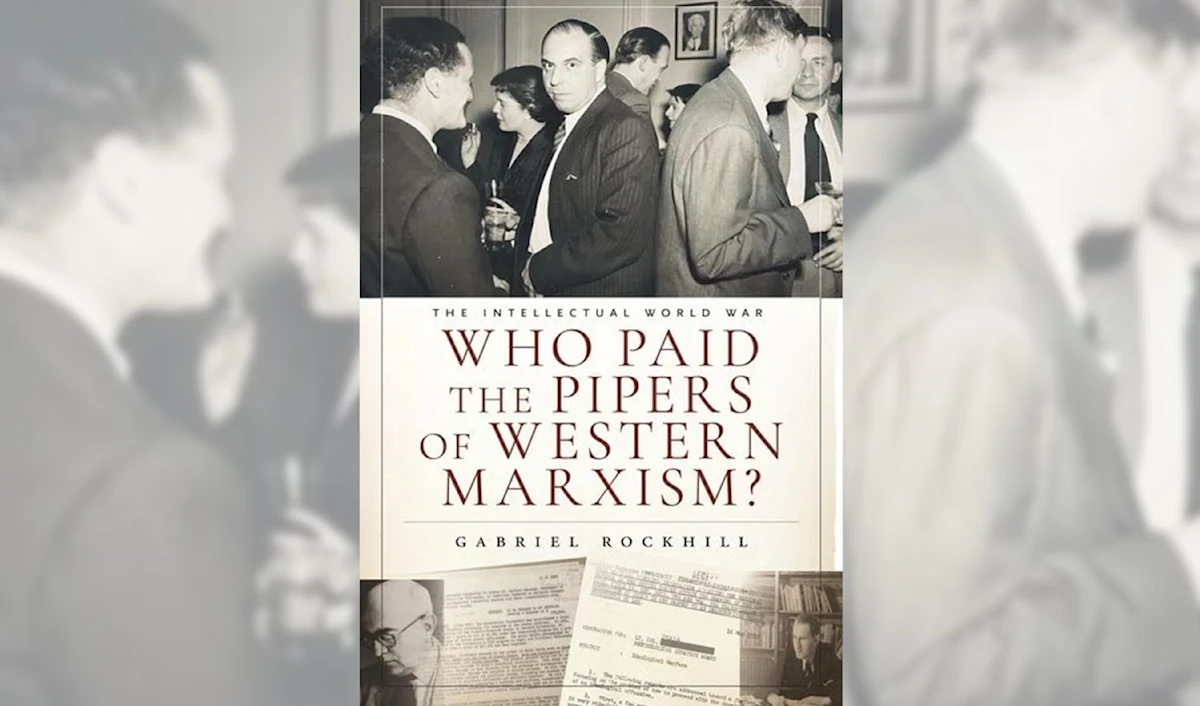سعيد محمد/ جريدة الأخبار
في المشهد الفكري المعاصر، نادرًا ما يظهر مصطلح جديد يمتلك القدرة الفورية على التقاط جوهر تجربة جماعية مضطربة مثل مصطلح كوري دوكتورو «إنشيتيفيكيشن» (Enshittification) الذي عنون به كتابه الصادر حديثًا عن «دار فيرسو». هذا المصطلح، بفظاظته المتعمدة وصراحته اللاذعة، يتجاوز مجرد توصيف ظاهرة تحول المنصات الرقمية من جنات غنّاء للمستخدمين إلى جحيم من الإعلانات والمحتوى الرديء وسوء الإدارة ليقدم تشخيصًا دقيقًا لآلية الفشل المتأصلة في قلب رأسمالية المنصات الرقمية المعاصرة في سعيها الدائم إلى تعظيم الربح.
يطرح دوكتورو وجهة نظر مفادها أنّ «الإنشيتيفيكيشن» ليست خطًا تقنيًا أو انحرافًا عن المسار الصحيح من قبل شركات جشعة، ولا هي نتاج سوء إدارة عارض. إنها النتيجة المنطقية والحتمية لنظام اقتصادي مصمم لخدمة هدف واحد: تعظيم الربح على حساب كل قيمة أخرى، بما في ذلك القيمة التي بنى عليها النظام نجاحه الأولي. هذا هو بالضبط ما وصفه كارل ماركس بـ «تناقضات رأس المال». فالمنصات لا «تختار» أن تصبح سيئة؛ إن السوق يجبرها على ذلك في سعيها اللامتناهي إلى تعظيم الأرباح لرأس المال.
المراحل الثلاث لتراكم رأس المال الرقمي
يشرح الكتاب عملية «التردي» هذه ببراعة جراحية، مقسمًا إياها إلى ثلاث مراحل حتمية تتوازى مع آليات تراكم رأس المال واستخراج فائض القيمة.
أولًا: حشد «البروليتاريا» الرقمية تبدأ المنصة حياتها كـ «رأسماليّ معطاء». إنها تقدم خدمة ممتازة، وغالبًا ما تعمل بخسارة، مستخدمةً رأس المال الاستثماري كوقود. الهدف في هذه الأثناء ليس الربح، بل «التراكم الأولي». في هذا السياق، فإنّ «الأرض» التي يتم الاستيلاء عليها هي الفضاء السيبراني المتمثل في اهتمام المستخدمين، وبياناتهم، وشبكاتهم الاجتماعية.
في هذه المرحلة، المستخدمون هم «البروليتاريا الرقمية». إنّهم العمال الذين ينتجون القيمة الأساسية للمنصة (البيانات، المحتوى، التفاعلات) مقابل «أجر» هو الخدمة الجيدة المجانية. المنصة تدعم المستخدمين، وتجعل تجربة الاستخدام خالية من الاحتكاك وممتعة، لجذب المليارات إلى «مصنعها» الرقمي.
تاليًا: دعوة البرجوازية الصغيرة بمجرد أن تمتلك المنصة «وسائل الإنتاج» (الجمهور الهائل وبياناته)، فإنها تفتح أبوابها لطبقة ثانية: «البرجوازية الصغيرة الرقمية». هؤلاء هم المبدعون، والمعلنون، والشركات الصغيرة، والمطورون الذين يعتمدون على المنصة للوصول إلى الجمهور.
تلعب المنصة هنا دور «مالك الأرض»، ويصبح هؤلاء «مستأجرين». في البداية، تكون شروط الإيجار ممتازة. تقدم المنصة لهم وصولًا سهلًا ورخيصًا إلى جماهيرهم، ما يسمح لهم ببناء أعمالهم وتكوين سبل عيشهم داخل «الحديقة المسورة» للمنصة.
المرحلة الثالثة: «الإنشيتيفيكيشن» واستخراج الريع، حيث يظهر وجه رأس المال الاحتكاري الحقيقي. بعدما أصبح كلا الطرفين أسرى - المستخدمون أسرى لشبكاتهم الاجتماعية وبياناتهم، والشركات أسيرة لجمهورها وقنوات توزيعها - تبدأ المنصة في تغيير القواعد.
المستخدمون هم «البروليتاريا الرقمية»
لا يعود الهدف بعدها «النمو»، بل «الكشط». تبدأ المنصة باستخلاص «الريع» من كلا الطبقتين. بالنسبة إلى الشركات (البرجوازية الصغيرة)، يتم خنق وصولها إلى جمهورها الذي بنته بنفسها، وإجبارها على الدفع للمنصة مقابل استعادة هذا الوصول. وبالنسبة إلى المستخدمين (البروليتاريا)، يتم تخريب تجربة الاستخدام. يُستبدل المحتوى الذي طلبوه بالمحتوى المدفوع، وتُغرق واجهاتهم بالإعلانات، وتُصمّم الخوارزميات ليس لخدمتهم، بل لخدمة من يدفع أكثر. وبلغة ماركس، يتم استخراج «فائض القيمة» من المستخدمين (عبر بيع انتباههم) ومن الشركات (عبر ابتزازها للوصول).
ليست «إنتروبيا»: إنه «التردّي» المُتعمَّد
أخطر خطأ قد نقع فيه هو تفسير هذا التدهور على أنه شكل من أشكال «الإنتروبيا» (Entropy). فالإنتروبيا، كمفهوم فيزيائي، تصف الميل الطبيعي للأنظمة للانتقال السلبي نحو الفوضى. الغرفة النظيفة مثلًا (المنصة في المرحلة الأولى) تصبح فوضوية (المنصة في المرحلة الثالثة) إذا تركت لنفسها من دون تدخل. هذا التفسير يعفي أصحاب المنصات من المسؤولية، ويصوّر التردي كقانون طبيعي حتمي.
تحليل دوكتورو، المدعم بالنظرية الماركسية، يثبت العكس تمامًا. فـ «الإنشيتيفيكيشن» ليست عملية سلبية، إنها عملية نشطة ومُصمَّمة وتتطلب طاقة هائلة. هذا هو المفهوم الماركسي «لإهمال رأس المال الثابت» أو ما يمكن أن نسمّيه «التردي الفيزيائي المُتعمَّد».
المنصة هي «رأس مال ثابت» (مصنع رقمي). في عالم الصناعة التقليدي، قد يختار الرأسمالي، في سعيه إلى تعظيم الربح، عدم صيانة الآلات أو المصنع، وتشغيلها بأقصى طاقة حتى تنهار، مستخرجًا كل قطرة ربح قبل أن يتخلى عنها.
هذا بالضبط ما يحدث في العالم الرقمي. التشبيه الأفضل هو سلوك «مالك العقار الآيل للهدم»؛ فالمالك يختار بوعي عدم إصلاح السباكة، ويختار بوعي إطفاء التدفئة، لتقليل نفقاته وزيادة إيرادات الإيجار. المبنى يتردى «فيزيائيًا» ليس بسبب الإنتروبيا، بل بسبب قرار اقتصادي مُتعمَّد.
عندما تصبح نتائج بحث غوغل أسوأ لأنها مليئة بالإعلانات والروابط المدفوعة، فهذا ليس «عطلًا» سلبيًا. إنه قرار هندسي نشط تطلب آلاف الساعات من المبرمجين والمديرين لتصميمه وتنفيذه. وعندما يملأ فايسبوك «التايم لاين» بمقاطع فيديو قصيرة مقترحة بدلًا من منشورات عائلتك وأصدقائك، فهذا ليس «انجرافًا» نحو الفوضى. إنه «تردٍ فيزيائي» مُخطط له لواجهة المستخدم، مصمّم لخدمة أهداف الربح، وليس أهداف المستخدم.
النضال من أجل «مشاع رقمي»
يقدم دوكتورو حلولًا تركز على الإصلاح البنيوي بدلًا من الثورة الكاملة، أهمها مكافحة الاحتكار، وهي الأداة الديموقراطية الاجتماعية الكلاسيكية لكبح جماح رأس المال عبر تفكيك القوة المركزة التي تسمح بحدوث «الإنشيتيفيكيشن» في المقام الأول، والتوافقية التشغيلية الحل الأكثر جذرية، كونها تحديًا مباشرًا لمبدأ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الرقمية. وتعني أن يكون المستخدم قادرًا على مغادرة فايسبوك مثلًا، والذهاب إلى منصة منافسة (أو تعاونية)، مع أخذ بياناته وشبكته الاجتماعية معه، والاستمرار في التواصل مع أصدقائه الذين بقوا على فايسبوك.
هذا الحل الأخير يحوّل القيمة الأساسية للمنصة من «ملكية خاصة» للشركة إلى «مشاع رقمي» يمتلكه المستخدمون. إنه يقول: «أنتم تملكون الأكواد، لكننا نحن (العمال/المستخدمون) نملك الشبكة التي بنيناها بعملنا». إنه يكسر حالة «الأسر» التي هي شرط ضروري للمرحلة الثالثة من «الإنشيتيفيكيشن».
بيان ضد الحتمية الرأسمالية
تكمن القوة الحقيقية لكتاب «إنشيتيفيكيشن» في أسلوبه السهل، إذ يظهر للقارئ سريعًا أن استخدامه للغة «سوقية» وصريحة ليس ضعفًا، بل هو إستراتيجية نقدية؛ ورفض ساخر من اللغة الخشبية والمعقمة التي تستخدمها شركات «وادي السيليكون» (مثل «تحسين القيمة» أو «إشراك المستخدم») والتي تخفي آليات الاستغلال، ويمنح «البروليتاريا الرقمية» و«البرجوازية الصغيرة الرقمية» لغة مشتركة، ومصطلحًا يسهل تداوله لوصف قمعهم المشترك ويخلق أساسًا لـ «وعي طبقي» رقمي. «الإنشيتيفيكيشن» نقد ثقافي يستند إلى التجربة الحية لـمليارات المستخدمين الذين يشعرون بأن الفايسبوك أو إكس أو تيك توك يزداد سوءًا، وتشخيص ماهر لمرض حتمي في النظام الرأسمالي، يكشف أنّ «الفوضى» التي نعيشها على الإنترنت ليست «إنتروبيا» سلبية، بل هي «تردّ» موجه ومُصمَّم هندسيًا. إنه ليس مجرد «عطل» في النظام... إنه النظام يعمل كما هو مُصمم له تمامًا.