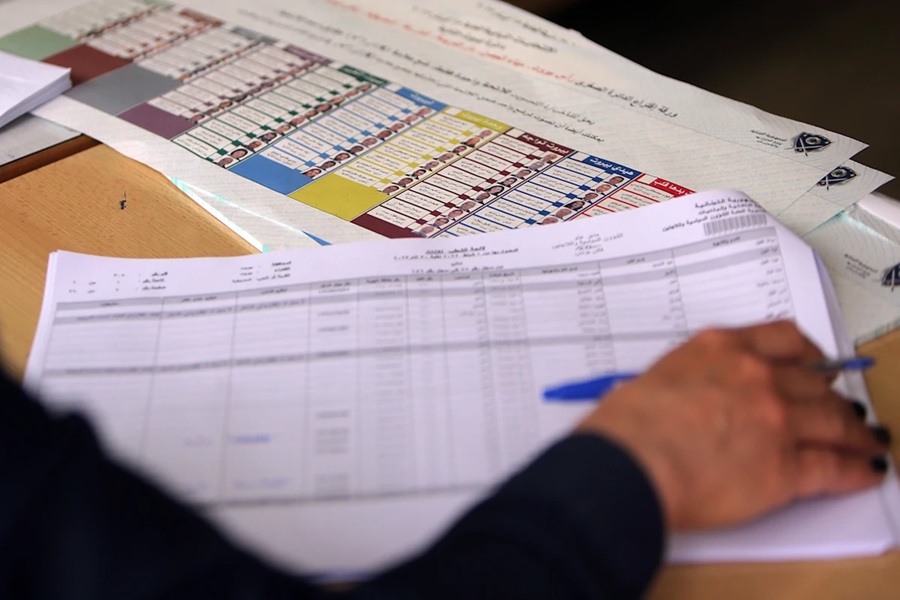فاطما خضر/ جريدة الأخبار
يفكّك حسن أوريد في كتابه «فخّ الهويّات» صعود الخطابات الهويّاتية في العالم العربي وأوروبا، من الشعبوية إلى الإسلاموفوبيا. ينطلق من تجربة المهاجرين ليحلّل كيف تحوّلت الهويّة إلى أداة صراع، تُغذّي الانقسام وتُبعد المجتمعات عن أسئلة العدالة والمواطنة
في ظل بيئة عربية وعالميّة تشهد صراعات هُويّات فرعيّة حادّة (طائفية، وعرقية، وإثنية، وجهُويّة، وغيرها)، وتصاعدًا للشعبوية والخطابات الانفعالية التي تستخدم الهُويّة كسلاح سياسي من أميركا إلى أوروبا؛ يقدّم الكاتب والباحث المغربي حسن أوريد كتابه «فخّ الهُويّات» (نوفل، الفاضل للنشر/ 2025).
كتابٌ جاء على إثر سؤال صحافي استنكاري وجّهته صحافيّة له حول المهاجرين المسلمين في أوروبا، ورفضهم الاندماج في مجتمعاتها؛ ما دفعه إلى بحث موضوعي وأكاديمي، مستندًا إلى خبرته الشخصية كابن مهاجر، وإلى مراجع متنوعة وثَّقها في الكتاب، وإلى متابعته لأزمات كبرى مرّت بها الجالية في فرنسا كنموذج لبحثه.
دور العولمة
يستعرض أوريد تاريخ مصطلح «الهُويّة»، الذي ظهر حديثًا مرتبطًا بمفهوم الهُويّات السياسية، وازداد شيوعًا مع صعود العولمة التي أسهمت في دفع خطاب الهُويّات، ومع نهاية الحرب الباردة، وسقوط جدار برلين (1989). تحوّل الصراع بعده من محدّد الاقتصاد إلى العامل الثقافي، ومن صراع الطبقات إلى صدام الهُويّات.
هكذا أدّت صدمة الحداثة والاستعمار وتراجع المشاريع الكبرى (كالقومية واليسار) إلى فراغ سياسي وفكري، ملأته الهُويّات الفرعية التي تقدم شعورًا بالأمان والانتماء.
سرعان ما انتشر الخطاب الهُويّاتي في أوروبا والعالم، لكن النُّخب السياسية وأصحاب المصالح استغلّته، وحوّلته إلى فَخ، يدعم تفتيت المجتمعات وإلهاءها عن القضايا الجوهرية مثل التنمية والعدالة الاجتماعية والديموقراطية؛ عبر تحويل مفهوم الانتماء إلى أيديولوجيا متطرفة تعمل على استبعاد «الآخر» وتكريس الانقسام، والتناحر، والحروب؛ ما حوّل الهُويّة إلى مأزق.
العالم العربي: قمع الهويات الفرعية
يُحلّل أوريد مصطلح «الانفلات الهُويّاتي»، ويقدّم مثالًا عليه حالة العالم العربي الذي يتسم بتنوع عرقي وديني ولغوي هائل. ففي فترة النضال ضد الاستعمار، قُمعَت الهُويّات الفرعية كالقبلية والاثنية والدينية لمصلحة مشروع قومي عربي موحّد، فرضته الدولة الوطنية بعد الاستقلال. وغذّى هذا القمع التاريخي لاحقًا الانفجار والانفلات الهُويّاتي العنيف الذي شهده العالم العربي، حيث تحوّلت الهُويّات المكبوتة إلى بؤر صراع طائفي واثني مزق النسيج الاجتماعي.
بعد الاستقلال، أنكرت دول عربية (كالمغرب والجزائر) الهُويّات الفرعية (كالأمازيغية)، لمصلحة فرض هُويّة عربية إسلامية موحدة، واعتبرت المطالب الثقافية «جهُويّة» أو «قبلية». وفي بلدان أخرى، مثل لبنان، أدّت الطائفية المؤسَّسة إلى حرب أهلية. وهكذا تحوَّلت قضايا الهُويّة من مناقشات فكرية إلى شؤون أمنية حسّاسة تتحكّم فيها الأجهزة الأمنية.
أدّت الطائفية في لبنان إلى حرب أهلية
مع تنامي الضغط الشعبي وتزايد الأحداث الدامية، شهدت قضايا الهُويّة انفراجًا نسبيًّا، كما في اعتراف الجزائر والمغرب بحقوق الأمازيغ الثقافية. لكنّها فشلت في بلدان أخرى شهدت ما عُرف بـ «الربيع العربي»، الذي انطلق كحركة موحّدة تُطالب بالديموقراطية، وإنهاء أنظمة الاستبداد، لكنّه تحوّل بسرعة وبدعم خارجي إلى ساحة لتصارع الهُويّات، ما أدى إلى حروب أهلية وتدخلات خارجية وإضعاف الدولة الوطنية لمصلحة ميليشيات طائفية واثنية، واستشراء الفساد والعنف والتطهير العرقي، ما هدَّد النسيج الاجتماعي برمته.
صناعة العدو أو «نظرية الكراهية»
من النقطة الأخيرة، ينتقل أوريد إلى مناقشة فكرة «صناعة العدو»، ما تُعرف أيضًا بـ «نظريّة الكراهيّة». لا توجد هُويّة جماعيّة من دون عدو فعلي، أو مُتخيّل. ومن هُنا يتعيّن إنشاؤه وتضخيم خطره بما يُعزّز الهُويّة الجماعية، ويحوّل التوترات المجتمعية والاقتصادية إلى كراهية موجَّهة نحو مجموعة محدّدة، تُستخدم كـ «كبش فداء» لتفريغ الإحباطات العامة، والفشل الذريع في بناء دولة مواطنة.
يبدأ العمل على خلق «صور الاستعداء»، بأشكال متدرجة، بدءًا من العنف الرمزي (كالازدراء والتنميط الإعلامي) إلى العنف المادي (كالتمييز والاضطهاد). وتُغذّى هذه الصور عبر إعلام يركّز على أحداث عنيفة معيّنة لتعميم صورة سلبية، وقوانين أمنية تستهدف فئات بعينها.
في المقابل، تتبنى المجموعة المستهدفة «خطاب المظلومية» كرد فعل على الاضطهاد، بينما يرفض الخطاب المهيمن هذه الصفة ويرى فيها تهديدًا أو ميزًا إيجابيًا.
الإسلاموفوبيا في أوروبا
ثمَّ يطرح الكاتب مصطلح «الانكفاء الهُويّاتي»، انطلاقًا من مصطلح «العدو الحميم»، الذي يأخذ في الغرب صورة الإسلاموفوبيا. تعدّ الإسلاموفوبيا من الظواهر المجتمعيّة المُتفشية في أوروبا، التي هدّدت العيش المشترك، وأفضت إلى الانكفاء (الانكماش) الهُويّاتي، وغذّت صدام الحضارات، وخلقت توترًا في العلاقات الدوليّة.
وُظفت كعدوٍّ داخليّ وحّد المجتمعات الغربية التي تعاني أزمة هُويّة وجودية بسبب التحولات الديموغرافية والهجرة وتراجع القيم. لكن بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، لم تعد الإسلاموفوبيا مجرد خوف من الإسلام، بل أيديولوجيا مؤسَّسة ومنظَّمة، تتبناها نخب سياسية وإعلامية وأكاديمية قائمة على أحكام مسبقة وإقصاء، تختزل المسلمين في كتلة واحدة رغم تنوعهم. وهكذا أصبح المسلمون كبش فداء لأزمات داخلية عميقة.
سرعان ما أصبحت الإسلاموفوبيا تُصَنَّع عبر آليات إعلامية وأكاديمية، بمساهمة بعض المسلمين الذين يضفون شرعيةً زائفة على حملة تهدف إلى تعزيز فكرة تفوّق الحضارة الغربية وخوفها من «الاستبدال الكبير» والغزو الديموغرافي المزعوم. واستغلَّت التيارات اليمينية المتطرفة هذا الخطاب لترويج مخاوف تاريخية وثقافية ودفع سياسات تقييدية ضد المسلمين.
القضية الفلسطينية في قلب أوروبا
بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، أجّج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة التوتر في المجتمعات الأوروبيّة، حيث سوّقت إسرائيل بأنّها تخوض حربًا حضاريّة باسم الغرب والتمدّن، ما أسهم في تأجيج التنافر ما بين الجاليات ذات الأصول العربية والإسلامية، والجاليات اليهودية وأعطى زخمًا للإسلاموفوبيا، وفي الوقت نفسه لمعاداة الساميّة. وهكذا أصبح الصراع الخارجي مُضخِّمًا للانقسامات الداخلية، فشهدت الملاعب الرياضية حركات شغب واستفزازات، وأُلغيت محاضرات جامعية، وشهدت الشوارع انقسامات ومظاهرات.
تحوّل «العلمانية» إلى أيديولوجيا
يخصّص الكاتب فصلًا كاملًا لمناقشة كيف تحوّلت «العلمانية» بدورها من قيمة إلى أيديولوجيا، ومن تجاوز للهُويّات إلى مرتكز للهُويّات. فقد بدأت العلمانية كمبدأ لفصل الدين عن الدولة لضمان حرية المعتقد وحياديتها، ما يضعها والهُويّة على طَرفي نقيض، لأنّها أسٌّ للمواطنة، وكابحٌ للهُويّات. لكنّها لم تعد بالوضوح الذي بدأت فيه، ولم يعد عنصر الحياد محدّدًا لها في تعاملها مع الدين، بل انتقلت من قيمة مجرّدة تحمي المواطنة إلى أداة سياسية.
في فرنسا مثلًا، وبعد سلسلة أحداث مثل قضية الفولار الإسلامي (1989)، وأحداث 11 سبتمبر (2001)، وهجوم شارلي إيبدو (2015)، ومقتل المدرس صامويل باتي (2020)، ظهرت «العلمانية الجديدة»، التي تحوّلت من مبدأ حياد إلى سياسة هُويّة حازمة لمواجهة الإسلام، بموجب قوانين، مثل: منع الرموز الدينية (2004) ومكافحة «الانفصالية»، وهكذا أُدلِجت العلمانية التي كان مدارها الفصل ما بين الدين والدولة.
يتتبع الكاتب أيضًا مصطلح «الضاحية» في فرنسا، الذي يصف حيزًا جغرافيًا واجتماعيًا وثقافيًا معزولًا، يشبه «الغيتو»، حيث تتقاطع وتتصارع الهُويّات؛ وتتطوّر هُويّة قاطنيه ذوي الأصول المهاجرة عبر ثلاثة أجيال: من انقسام الجيل الأول (جيل الآباء المهاجرين)، إلى سعي الجيل الثاني إلى الاندماج والفشل فيه (جيل الأبناء الذي ناضل من أجل المساواة)، وصولًا إلى غضب الجيل الثالث المهمَّش (وجيل الأحفاد الحالي الذي يغلب عليه الغضب والإحساس بالإقصاء).
هكذا تحوَّلت الضاحية إلى مركز لتوترات مجتمعية عميقة، ناجمة عن عناصر بنيوية متمثلة في إخفاق سياسات الدولة، خصوصًا في المدرسة والإسكان والصحة والتشغيل، وفي تمييز منهجي يعانيه السكان بسبب أسمائهم أو سحناتهم أو دينهم. وتجلى هذا الإخفاق في أحداث مثل «تظاهرات الضواحي» (2005)، وحركة «السترات الصفر» (2018)، وأخيرًا اغتيال الفتى نائل مرزوق (2023)، الذي أشعل غضبًا عارمًا وكشف عن عنف الشرطة والشرخ الهُويّاتي.
غضب «الفرنسيين من الدرجة الثانية»
لا تعتبر هذه الأحداث مجرّد انفجارات عابرة، بل تعبير عن غضب متراكم لشريحة تشعر بأنها «فرنسية من الدرجة الثانية»، محاصرة بالتمييز والإسلاموفوبيا، وترى في المؤسسات الجمهورية عائقًا أمام الاعتراف والعدالة، ما يهدد العيش المشترك.
يرصد أوريد في كتابه كذلك، تحوّل الصراع الذي شهدته فرنسا من صراع اجتماعي طبقي إلى صراع أعراق وهُويّات. بعد الحرب العالمية الثانية، تراجع الخطاب اليساري الطبقي التقليدي، وحلَّت محله تدريجًا مقاربات هُويّاتية تجسدت في ثلاث لحظات رئيسية: مرحلة هيمنة اليسار على القضايا الاجتماعية من غير تمييز طائفي - ثم مسيرة 1983 ضد العنصرية التي قادتها الجالية من أصول مغربية المعروفة بـ «البور» (Beur) - وأخيرًا أزمة الحجاب (1989)، التي حوّلت الإسلام إلى «علامة هُويّاتية مركزية» وأطلقت قطيعة ثقافية.
أدّت هذه الانزياحات بمجملها إلى إضعاف التضامن الطبقي، لمصلحة خطاب هُويّاتي يكرس الانقسامات ويفتح الباب أمام الشعبوية.
ثُمّ ينتقل أوريد لاستعراض مصطلح «المجتمع الأرخبيلي» الذي صاغه «جيروم فوركيه»، الذي يصوّر فرنسا كمجموعة من «الجزر» الاجتماعية والثقافية المتنائية رغم أصلها المشترك. ينتج هذا من «انزياح أنثروبولوجي» عميق، حيث تراجع الإطار الكاثوليكي التقليدي لمصلحة قيم فردية جديدة تتعلّق بالأسرة والجنس والموت.
يركّز تحليل فوركيه على الجالية المسلمة كمثال صارخ على هذا التمايز، حيث يلاحظ عزلة ذاتية واجتماعية تتجلّى في معدلات الخصوبة المرتفعة، والزواج الداخلي، والمحافظة الدينية، والسكن في أحياء منفصلة (الضواحي). ويرى أنَّ هذا الانكفاء الهُويّاتي هو غالبًا ردّ فعل على التمييز والإقصاء، ولكنّه بدوره يغذّي القلق الهُويّاتي لدى الفرنسيين الأصليين ويقوّض إمكانية الاندماج والعيش المشترك، ما يحوّل المجتمع إلى كتلة من الثغرات المتوترة القابلة للانفجار.
الخوف من «الأسلمة الزاحفة»
ثُمَّ يُناقش أوريد نظرية «الاستبدال الكبير» أو (الانقباض الهُويّاتي) التي تزعم أن الهجرة، خصوصًا من العالم الإسلامي، تهدّد بتبديل الهُويّة الديموغرافية والثقافية لأوروبا. تتبنى هذه النظرية خطابًا هُويّاتيًا انقباضيًا، يُغذي الخوف من «الأسلمة الزاحفة» ويُشكل رافعةً للأحزاب الشعبوية اليمينية. يستند دعاتها إلى مؤلفات وأدبيات تُصوّر المهاجرين كقوة استيطانية لا تندمج.
من جانب آخر، ينتقد أوريد هذه النظرية باعتبارها أيديولوجيا اختزالية، تتجاهل الأسباب الهيكلية للهجرة كالحاجة الاقتصادية وإرث الاستعمار، فالثورة الصناعيّة قامت على أكتاف المهاجرين. ويُجادل بأن الهُويّات قابلة للتهجين، وأن الحلّ لا يكمن في الإقصاء بل في الانفتاح والاندماج، مع معالجة جذور الهجرة عبر العدالة العالمية.
يُناقش أوريد أخيرًا «نقض الاستعمار» كتيار فكري حديث في فرنسا، يتمحور حول انتقاد الحداثة وزيغ النيوليبرالية، ويسعى إلى تفكيك المنظومة الفكرية المهيمنة، إذ يرى أن الأوضاع الحالية للأقليات، خصوصًا المنحدرين من المستعمرات، هي استمرارية للعلاقة الاستعمارية داخل المجتمع الفرنسي نفسه، حيث يُعاملون كأهالي (على أنقاض تعبير «أهالي الإمبراطورية» الذي كان سائدًا في الفترة الاستعمارية)، فالجاليات من أصول مسلمة في فرنسا، وإن كانت تحمل الجنسية الفرنسيّة، فهي فرنسيّة من درجة أقلّ، ولا تحظى بمواطنة كاملة في جمهورية تمارس تمييزًا مؤسسيًا.
أثار هذا التيار جدلًا واسعًا، حيث يهاجمه البعض كتهديد للقيم الجمهورية العالمية، بينما يراه أنصاره طريقًا ضروريًا لتحقيق عدالة حقيقية عبر الاعتراف بالتاريخ ومخلفاته الحاضرة.
هكذا يتناول أوريد الكتاب بشكل نقدي لظاهرة تصاعد الهُويّات الفرعية في العالم العربي والعالم بشكل عام، ويحذر من مخاطر انغلاق الهُويّة وتحولها إلى مصدر للصراع بدلًا من أن تكون عامل إثراء وتنوع، محذرًا من أن الانكفاء على الهُويّة الضيقة يُعيق تطور المجتمعات، ويغذّي الصراعات، وداعيًا إلى تجاوز الفخ بالانفتاح على هُويّات أوسع، مع الحفاظ على الخصوصية في إطار المواطنة الجامعة والمشترك الإنساني.