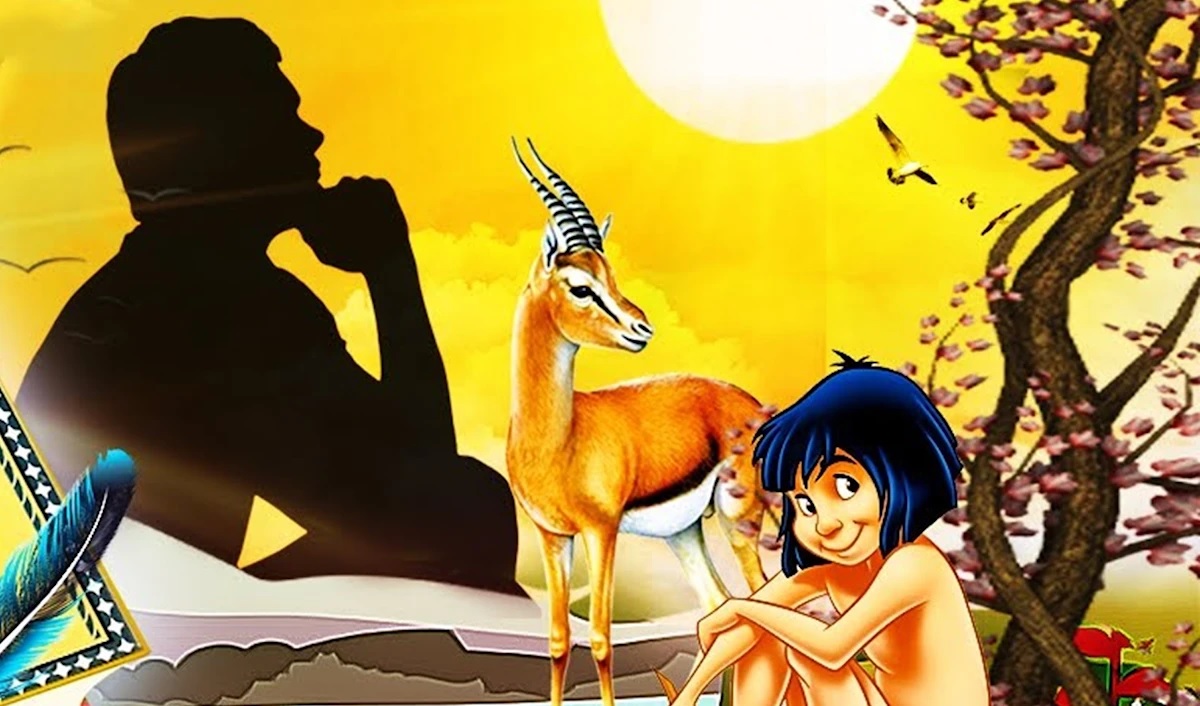محمد عبدالله فضل الله/جريدة الأخبار
أن يمتزج الأدب مع الفلسفة أو أن ترتدي الفلسفة رداء الأدب الرائق، فتلك لها قصتها بذاتها التي تحمل دلالات معرفية إبداعية قل نظيرها، متوخيةً الجمع بين السؤال الفلسفي عبر تقنيات أدبية ترتكز على المخيال الخصب، الذي يحيلك على البراعة في التوليف والنضج في التفكير إلى جانب العمق في المعنى المنبجس من ذات متعالية في اتصال متقن مع الأصالة.
من هؤلاء الذين حاولوا التوفيق بين الفلسفة والدين في عصر دولة الموحّدين الذين غلب عليه الطابع العقلاني محمد بن عبد الملك بن طفيل الأندلسي المعروف بابن طفيل (505 ـ 581 هـ/1110ـ 1185م) فيلسوف وفلكي وقاضٍ أندلسي عربي مسلم. درس على يد ابن باجة وعند وفاته سار حاكم الأندلس المنصور في جنازته.
حتى إنه أشار على ابن رشد بتلخيص فلسفة أرسطو كما يقول أبو الوليد نفسه، إذ ذكر أنَّ ابن طفيل جاءه يومًا وأخبره أنّ الخليفة ما فتئ يشكو من قلق عبارة أرسطوطاليس، أو عبارة المترجمين عنه، ويذكر غموض أغراضه، ويقول: «لو وقع لهذه الكتب من يلخصها ويقرّب أغراضها بعد أن يفهمها فهمًا جيدًا لقرب مأخذها على الناس، فإن كان فيك فضل قوة لذلك فافعل ». قال أبو الوليد: «فكان هذا الذي حملني على تلخيص ما لخصته من كتب الحكيم أرسطو طاليس ».
التجهيل موضة رائجة
هذا النص يعطينا أيضًا لمحة عن عظيم الاهتمام الذي يبديه حكام تلك المرحلة من التاريخ بالعلوم والمعارف وبوجه خاص بالفلسفة، وهو ما يترك في النفس اليوم حزازةً، فلا حكام ولا غير حكام في زماننا الصاخب بالسخافات يبدي أي اهتمام بالعلوم والثقافة وكأن التجهيل وثقافة الموضة الفارغة هي الرائجة.
أما مؤلفاته الكثيرة، فقد ضاعت خلال الفتن التي عرفتها الأندلس ولم يبقَ منها غير قصة «حي بن يقظان » هذه القصة الفلسفية التي حاول فيها كعادة كثيرين أن يوفّقوا بين الفلسفة والدين وقد ترجمت إلى كل اللغات.
هي قصة ورواية رومانسية أشبه برحلة فلسفية صوفية علمية كما يقول الباحث عمر فروخ.
أولًا لمناسبة كتابة العمل ولدوافعه تتمركز الأهمية، كون ذلك يضعك أمام المبتغى الكلي للعمل الأدبي والفلسفي ومنطلقاته، التي توالد منها وخرج منها إلى حيز الوجود. يذكر ابن طفيل أنه أقدم على تأليف هذا العمل بعدما سأله أحدهم عن أصل المعرفة الإنسانية، فيقول: «وانتهى بي هذا السؤال إلى مبلغ من الغربة لا يصفه الإنسان ولا يقوم له بيان».
هنا يتضح لنا أن السؤال الفلسفي منه، حيث السؤال مفتاح المعرفة يمثّل حيرة الإنسان تجاه الوجود ويثير حبه الدفين للحقيقة، ويستفز عقله الباحث عن دوره في تلمس الحقائق.
عقل الفيلسوف وخيال الشاعر
السؤال بطبيعته إشكالي يفتح الإنسان على تساؤلات كثيرة تحاول جميعها إثبات الوجود على قدر ما تصل إليه. هذا السؤال الذي ليس له أن ينتظر جوابًا جاهزًا أو منتجًا، بل هو يمارس فعلًا ودورًا ضمن عملية المعرفة وسلسلتها المفتوحة على الزمن.
ما يلفت إذا أردت إجالة النظر فيها أنَّ صاحبها ابن طفيل تعمّد أن يكتبها بعقل الفيلسوف وخيال الشاعر المرهف. وهذا لا يتأتى لكثيرين إلا من امتلك القدرة على ركوب مدارج المعرفة المحلّقة في آفاق الوجود، لأنك عما قليل ستعثر على مرادفات ومصطلحات، ورموز كثيفة ودقيقة لها غاية شريفة لجهة لعن الغفلة والتنبيه منها كعدو للفطرة والترقي الروحي كما لعن التقليد المميت الذي يسجن الذات الفردية والجمعية في قفص مغلق معدوم الحياة يبعدها عن فعلها ويحرمها وجودها وكمالاتها.
القصة هي أن طفلًا نشأ في جزيرة من جزائر الهند النائية تحت خط الاستواء، وهي الجزيرة التي يولد فيها الإنسان من غير أم ولا أب وفيها شجر يثمر النساء، فحصل أن حنّت عليه ظبية وألقمته حلمة ثديها وأروته لبنًا سائغًا حتى كبر وشب عن الطوق.
لم يزل يمعن النظر فيها أي الظبية بعد موتها وتشريحها حتى تمكن من فك بعض أسرار الحياة، ثم بعد طول تدبر، أثبت وجود خالق، وعلم بالضرورة أن كل حادث لا بد له من محدث.
بعد أن انكشفت له كل هذه الحقائق، قرر أن يعيش حياة زهد وتأمل. وذات يوم، قدم رجل من جزيرة مجاورة يدعى آسال، فعلمه اللغة، ودربه على الحياة الاجتماعية. واندهش هذا الرجل حين لاحظ أن حيًا قد تمكّن بمفرده من اكتشاف كل الحقائق التي تضمنتها ديانته، معولًا على الملاحظة والمراقبة والاستقراء والاستدلال، عندما علم حي بن يقظان أن عقائد الناس فوق الأرض قاسية وغير ملائمة، قرر مغادرة الجزيرة وإرشاد الناس وتعليمهم، لكنه عاد خائبًا إلى جزيرته ومملكته الطبيعية لأن الناس قد هجروه وانصرفوا عنه.
الوصول إلى الحقيقة بالعقل الخالص
هنا تتجلى البراعة في حياكة المفاهيم الفلسفية المغلقة إلى صور شعرية نابضة بالحياة ملامسة للوجدان بدفق، إذ تنطوي القصة على تصور ابن طفيل للعلاقة بين العقل والشريعة أو بين الفلسفة والدين، فجاء أسلوبه السلسل والممتع كتعبير فائق الروعة عن مغامرة العقل الإنساني في تدرجه المطلوب والمرغوب من المحسوس إلى المعقول ومن التجسيد إلى التجريد، ليدرك كل الحقائق الكونية الكبرى .
هذا المطلب الرفيع في التدرج تمخض في هذا النص الرمزي الفلسفي الأدبي الكثيف في دلالاته يقول حسن حنفي: «لا يوجد نص فلسفي كتب أربع مرات من أربعة فلاسفة مختلفين وأحيانًا مع تغيير العناوين مع بقاء المضمون مثل قصة حي بن يقظان، فهي مع أصلها اليوناني (سلامان وابسال) قصة رمزية لابن سينا (428 هـ) ولابن طفيل (581 هـ) وللسهروردي (587 هـ) وابن النفيس (687 هـ)، والموضوع واحد هو كيفية الوصول إلى الحقيقة بالعقل الخالص من دون الاعتماد على معرفة لدنية، والعقل الخالص هو العقل الطبيعي الذي يتأمل في الظواهر الطبيعية والجمادية والنباتية والحيوانية".
يشرح العنوان قائلًا «للعنوان دلالة رمزية، حي بن يقظان، فالحياة بنت اليقظة، واليقظة هي الأصل والحياة هي الفرع، فالإنسان يحيا أولًا ثم ينبثق الوعي من خلال الحياة».
رائعة فلسفية وفنية حذَّرت من المشتتات الإجتماعية التي تصيب الناس من خلال غفلتهم وتقليدهم الأعمى كأنها موجهة لنا اليوم حيث نشهد على تمزق الذات الجمعية وانغماسها في الترهات والسطحية وهجرها لأصالة التفكير والفعل الإنساني المعقلن والسوي، فمن سيكتب قصة تشتّتنا وضياعنا اليوم أو يكفي ما أفصحت عنه تلك القصة التي تشهد علينا ؟!.