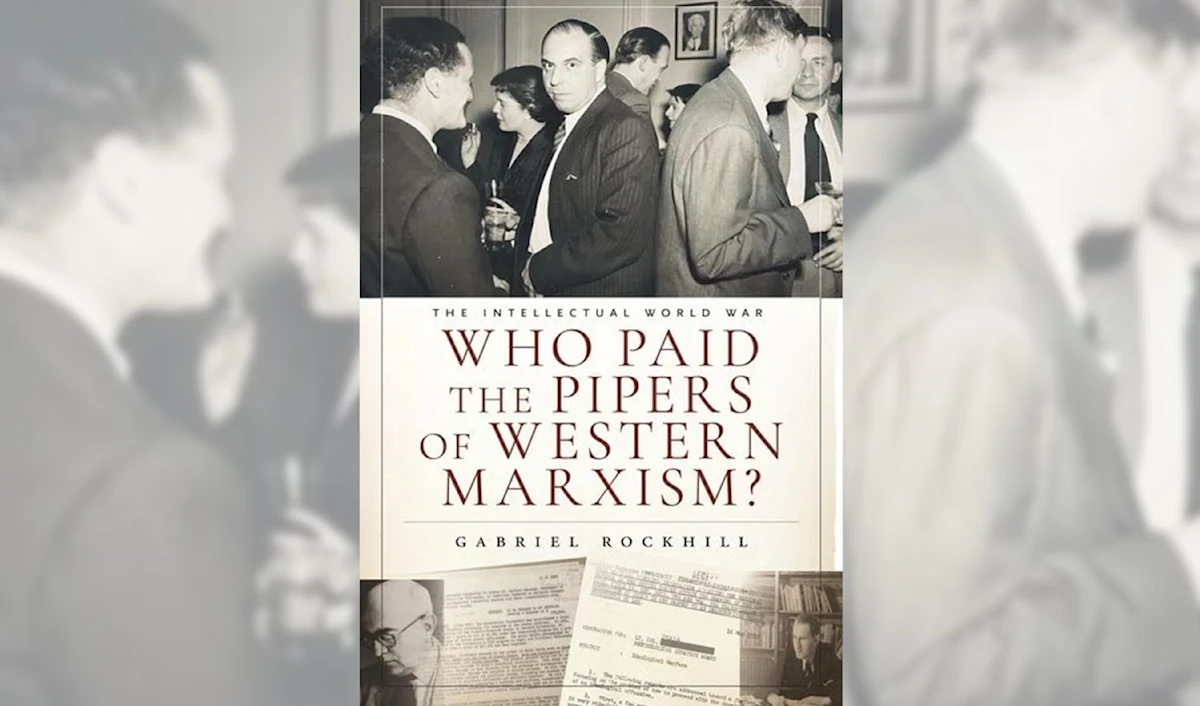زينب حمود (صحيفة الأخبار)
هناك 116 مدرسة رسمية دامجة موزعة على المحافظات الثماني، استقبلت العام الدراسي الماضي نحو 5500 تلميذ من ذوي الصعوبات التعلّمية والإعاقة، في إطار مشروع التربية الدامجة الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (اليونسيف).
من الطبيعي أن يسمع الأهالي عن المشروع للمرة الأولى، رغم مرور سبع سنوات على إطلاقه، ما دامت الجمعيات المعنية بالإعاقة والناشطون أنفسهم لا يعرفون خريطة انتشار هذه المدارس ومعايير الدمج التي تعتمدها، وما دام عدد من المدراء المشرفين على تطبيق سياسة الدمج في مدارسهم، إما ينكرون أن المدرسة دامجة أو لا ينصحون الأهالي بها، ويدعونهم إلى التسجيل في مؤسسات خاصة بالمعوقين، كما فعلت مديرة في الشمال، إذ نصحت والدة تلميذ لديه إعاقة ذهنية: «كأم، أقول لك، سجليه في مركز (...) حيث يستفيد أكثر ويتعلم صنعة».
ورغم الغموض الذي يحيط بالمدارس الدامجة، أكدت مصادر في وزارة التربية لـ «لأخبار» أن هذه المدارس تستقبل المتعلمين ذوي الصعوبات التعلمية والاحتياجات الخاصة الخفيفة والمتوسطة، إضافةً إلى بعض الحالات المتقدمة في 12 مدرسة دامجة مؤهلة لتقديم دعم متخصص أكثر شمولاً، وتعمل لاستقبال ذوي الاحتياجات الذهنية المتقدمة، واعدة بأن «تكون كلّ المدارس الرسمية دامجة بحلول عام 2030».
إنجاز عظيم أن يتم التوصل إلى سياسة الدمج الجامعة والمؤسساتية، بعد عقود من «ترقيع» الحلول وغياب التخطيط ورمي مسؤولية المعوقين التربوية والتعليمية على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية. لكن ألا تكبّر الوزارة الحجر بعض الشيء؟ كيف سيتحقق هذا «الحلم» بعد خمس سنوات؟ وكيف ستُحول المدارس الرسمية إلى دامجة لجميع التلامذة باختلاف أنواع الإعاقة ودرجاتها؟ ما هي الخطط التي تضعها على صعيد تكييف المناهج وطرق التعليم وتجهيز المدارس هندسياً، وتدريب الفرق المختصة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ممكنة بعد تقييم وضع المدارس الدامجة الحالية.
أولاً، تتكفل «اليونسيف» مع الاتحاد الأوروبي بتمويل المشروع، وتقدم جمعية HI بعض الخدمات للمستفيدين، ما يطرح علامات استفهام حول ديمومة الخطة التربوية الشاملة، وصحة ربط مصير التلامذة التعليمي بتمويل خارجي، قد يتوقف في أي وقت، ولأي سبب سياسي أو غيره، فيما الجمعيات المحلية التي تمتلك خبرة في الدمج واهتماماً خاصاً بمتابعة المشروع، تبدو مغيّبة كلياً. فبعد اللقاء الذي جمع هذه الجمعيات بالوزيرة ريما كرامي قبل ثلاثة أشهر، و«كان مثمراً وبنّاء، عرضت خلاله الوزيرة علينا الشراكة ومتابعة المدارس الدامجة، والتدقيق في عملها وإعطاء الرأي حول التعليم الدامج»، بحسب رئيسة «الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً» سيلفانا اللقيس، لم يُعقد أي اجتماع آخر، وبقيت تفاصيل المشروع طي الكتمان.
فريق العمل
أبرز التحديات التي تحيط بمشروع الدمج وتضعف فعاليته تتعلق بفريق الدعم المختص، الذي يضم مربياً تقويمياً بدوام كامل، واختصاصيين في علم النفس وعلاج النطق والعلاج الحسي الحركي بدوام جزئي. أولاً، في غالبية المدارس متخصص واحد تقع على عاتقه مهمات خارج إطار تخصصه. ويعود انسحاب المتخصصين إلى سببين: «شعورنا بعدم الجدوى في ظل الفوضى وعدم انتظام العمل»، بحسب أكثر من مختص. والثاني، والأهم، هو تراجع قيمة البدلات المادية التي يحصلون عليها. فبعد المطالبات المتكررة، وصل بدل الساعة إلى 11 دولاراً، وهو لا يوازي ربع ما يتقاضاه المتخصصون في عياداتهم الخاصة، عدا عن التأخير في صرف المستحقات بالحد الأدنى 40 يوماً ريثما يرفعها مدير المدرسة إلى الوزارة ومنها إلى «اليونيسيف».
النقص في المتخصصين أجبر الوزارة على «التنازل» في شروط اختيارهم، والقبول بالخريجين الجدد، وغير الحائزين إذن مزاولة المهنة، ما يطرح علامات استفهام حول مهنية الفريق وجودة ما يقدمه. وشكا الأهالي خلال زيارة وفد من «اليونيسيف» والاتحاد الأوروربي لإحدى المدارس الدامجة، حضور الاختصاصي النفسي مرتين في الأسبوع، «بينما يتعرض أولادنا للتنمر بشكل مستمر ولا يمكنهم انتظار المتخصص النفسي أياماً للاستماع إليهم».
وبينما تتكفل جمعية HI بتغطية كلفة العلاجات النفسية، الحسي حركية، والنطق في مراكز موزعة على مختلف المناطق، بعدما تحيل إليها الوزارة ملف كل تلميذ بحاجة إلى هذه العلاجات، تشير المتخصصة النفسية وفاء يوسف إلى «ضرورة أن تشمل سلة الخدمات التربية المختصة، ليدخل دعم الجانب الأكاديمي مع الجانب العلاجي، مثل المواكبة خارج المدرسة على لغة البريل، أو المساعدة في القراءة، وهي متابعات تربوية أكاديمية لا يمكنها تقديمها وحدها المدربة التقويمية في المدرسة».
التعليم المكيف
ويبقى أهم ما يُسأل عنه عند اختبار فعالية مشروع الدمج، ما إذا كانت المناهج قد تكيفت لتشمل جميع التلامذة باختلاف احتياجاتهم الخاصة، ووُزعت الأدوات اللازمة عليهم ليواكبوا العملية التعليمية.
بداية، هناك إيجابية، وإن ليس كما يجب، في تأمين الأدوات المطلوبة. فقد أمنت «اليونيسيف» مصعداً لطالبة لديها تقزّم لتتمكن من استخدام المقعد نفسه الذي يستخدمه أقرانها بدلاً من آخر صغير الحجم يشعرها بالتمييز، كما أمّنت لها لوحاً صغيراً يلائم احتياجاتها للمشاركة في الأنشطة مثل رفاقها.
لكن، لا يحصل تقييم رسمي متخصص لكل حالة ليخصص لها برنامج خاص، لأن التقييم مكلف، فيستعاض عنه بملاحظة أولية من قبل الفريق المختص. غير أن مناهج التعليم لم تُكيّف في المركز التربوي للبحوث والإنماء بشكل يضع الأهداف الخاصة والكفايات التعلمية لذوي الصعوبات التعلمية والإعاقات المختلفة ولا آلية تقييم الحالات الخاصة، كما إنه ليس هناك تعليم ثانوي دامج حتى الآن.
ما يحصل على الأرض هو جهود خاصة من فرق الدعم، لا يعوّل عليها إذا ما تزامنت مع جهود الأساتذة في الصفوف التي تضم حالة خاصة. ويبدو أن الأساتذة بعيدون كل البعد عن سياسة الدمج، و«ظنوا في البداية أننا مفتشون تربويون»، كما يقول أحد المتخصصين. ثم ظهرت محاولات من الطاقم التعليمي للمساعدة خاصة في الحالات السلوكية والإعاقات البسيطة، بعد الخضوع لدورات تدريبية وإرشادية. منها مثلاً تحضير امتحانات خاصة وطباعة الدروس بخط كبير.
مقابل عدم استعداد آخرين في الهيئة التعليمية للانخراط في عملية الدمج، لا سيما الأساتذة الكبار في السن الذين «لا يتقبّلون الاستماع إلى تعليمات متخصصين أصغر منهم سناً». وتبقى العقبة الأبرز أمام تجاوب الأساتذة الأجر المادي عن الجهود الإضافية، فرغم أن من واجب الأساتذة إيصال الأهداف للجميع بشكل متساوٍ، يرى هؤلاء أن «حصولهم على ذات الأجر مثل أستاذ في مدرسة غير دامجة ليس أمراً عادلاً».
تجهيز المدارس
بالاطلاع على خريطة توزع المدارس الدامجة، يظهر انتشارها في المحافظات الثماني. لكن، هناك صعوبة في الوصول إليها خصوصاً في القرى، مع ارتفاع تكاليف النقل. غير أن المدارس الدامجة الأقرب إلى أماكن سكن ذوي الاحتياجات الخاصة، ليست متاحة لجميعهم باختلاف جنسهم ولغتهم الأساسية.
فالمدرسة الدامجة القريبة إلى مكان سكن محمد في قرية شمالية، مخصصة لتعليم الإناث فقط، ونظراً إلى خصوصية المنطقة الثقافية وعدم تقبل الأهل الاختلاط بين الجنسين بعد سن البلوغ، برزت مبادرة من المتخصصة في فريق الدمج لاستقبال الذكور في صفوف الحلقة الأولى، معوقين وغير معوقين، للإتاحة للفتيان المعوقين دخول المدرسة.
لكن هذا الحل لا ينسحب على الفئات العمرية الأكبر. هندسياً، تقول الوزارة إنها «تتابع من خلال وحدتها الهندسية تأهيل المدارس تدريجياً لتأمين بيئة دامجة فعالة، عبر تجهيز الأبنية المدرسية بمنحدرات، مصاعد، حمامات مهيأة، لوحات إرشادية بارزة، وأرضيات ملموسة لتسهيل الحركة والتنقل».
لكن، على الأرض «الوضع كارثي»، كما ينقل الأساتذة في المدارس الدامجة. ويشير أحدهم إلى صعوبات تواجهها تلميذة لديها إعاقة حركية وتقزم، حيث «لا منحدر ولا مصعد في المدرسة، فيتكفل الأب بحمل ابنته على ظهره عند الدخول والمغادرة، ويقع على عاتق التلامذة في الحلقة الثالثة التطوع لحملها خلال الدوام». ويقول أستاذ آخر في مدرسة دامجة في بعلبك - الهرمل إن «أبنية المدارس الرسمية خطرة بالنسبة إلى جميع التلامذة، فكيف الحال لمن لديهم صعوبات خاصة في الحركة ويواجهون تحديات لغياب المصاعد والمراحيض المهيأة لاستقبالهم»؟
يُذكر أنه عام 2009، أظهر المسح الميداني الذي أجراه بشار عبد الصمد في «اتحاد المعوقين حركياً»، حول مدى أهلية المراكز الانتخابية لاقتراع الأشخاص المعوقين، أن أربعة مراكز فقط من أصل 1669 تتوافر فيها التجهيزات الهندسية الدنيا، علماً أن 962 من هذه المراكز مدارس، أي ما نسبته نحو 70 في المئة من مراكز الاقتراع. وعام 2015، و«بعد تصريحات مضللة من وزارة التربية تدَّعي فيها استخدام منحة من الاتحاد الأوروبي لتجهيز المدارس الرسمية، قام الاتحاد بتدقيق ميداني تحديثاً للمسح وأثبت عدم صحة تلك الادعاءات»، كما يقول عبد الصمد. ولم تحصل بعدها أي مبادرة لتمويل تجهيز المدارس وإزالة العوائق، علماً أنه، بحسب اللقيس «يبلغ المعدل الوسطي لكلفة تجهيز المدرسة الواحدة 100 ألف دولار، بين بناء مصعد وتجهيز المراحيض، وقد ارتفعت الكلفة 4 مرات عما كانت عليه عام 2009».
أخيراً، رغم تأخر مشروع التربية الدامجة، وكل ما يشوبه من ثغرات، لا بديل منه لتأمين حق كل تلميذ في الوصول إلى التعليم الرسمي، وتأمين البيئة المدرسية المكيفة لدمجه. وهذا يتطلب أولاً قراراً سياسياً، لتكون الخطة وطنية، وتسهم موازنة «التربية» في تسديد بدلات المتخصصين، وتجهيز المدارس هندسياً ولو تدريجياً، بدلاً من رهن مستقبلها للخارج.
ويمكن كذلك الأخذ بالاقتراح الذي رفعته يوسف إلى المسؤولين حول «التنسيق بين التعليم المهني والأكاديمي على صعيد الدمج، بشكل يحصل معه طلاب التربية المختصة على حصص تدريبية في المدارس الدامجة مقابل الاستفادة من خدماتهم في التعليم في الظل».
... والجامعات تستبعد المعوّقين
لا يختلف واقع الطلاب المعوقين في التعليم العالي عن أقرانهم في التعليم الأساسي. ففيما تتسابق الجامعات الكبيرة والعريقة في اختبارات تقييم الجودة، وتنظّم محاضرات وندوات لـ «تنظّر» في حقوق الإنسان، لا تزال سياسة دمج المعوقين، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لاحتياجاتهم تضمن حقهم في التعليم، خارج الحسابات.
وأظهرت دراسة بعنوان: «الإعاقة في التعليم اللبناني العالي: كشف تجارب الطلاب» أعدها الباحثون كوثر فضل الله وميشال أسمر وجمانة يريتزيان، «الفجوة بين وعود التعليم الشامل في لبنان والواقع في الحرم الجامعي في معظم الجامعات، لجهة الصعوبات في ترسيخ سياسات الدمج، والاعتماد على جهود عفوية في دمج الطلاب المعوقين بدلاً من أنظمة شمولية منظمة».
وجرت الدراسة بالتعاون مع «مركز مبادرات البحوث التعاونية في الصحة العامة»، في المعهد العالي للصحة العامة، في جامعة القديس يوسف في بيروت، ونشرت في مجلة «الحدود في التعليم» في أيلول 2025. وارتكزت على دراسة حالات نوعية لخمسة طلاب من ذوي الإعاقات الجسدية والحسية والتعلمية في مؤسسات التعليم العالي اللبنانية، مع إجراء مقابلات معهم للسؤال عن تجاربهم الأكاديمية والاجتماعية، والعوائق التي واجهوها، والإستراتيجيات الشخصية التي طوروها لتحقيق النجاح.
كشفت الحالات الخمس عن تحديات «جسيمة» في الوصول ونقص المواد المُجهزة، وعدم انتظام الدعم، تعيق مشاركتهم في الأنشطة الأكاديمية. منها ما ينقله أحد المشاركين من ذوي الإعاقة الجسدية من «عدم القدرة على الوصول إلى المختبر وبالتالي الحرمان من حضور الحصص». أو عدم قدرة طالب آخر كفيف على الوصول إلى دورة المياه في اليوم الأول لأن «الجامعة رغم معرفتها باستقبال طالب كفيف لم توفر شخصاً ليرشدني في المكان»، كما يقول.
وما حرم كثيرين من الحصول على تسهيلات، بحسب الدراسة، هو صعوبة الإفصاح عن الإعاقة خوفاً من الشفقة أو الوصمة الاجتماعية في ظلّ غياب إجراءات واضحة وسرية لإفصاح كثيرين يشعرون بالوحدة عن معاناتهم. في المقابل، تلقى البعض الدعم من بعض الأساتذة والأقران، لكنه «دعم يعتمد على حسن النية الفردية بدلاً من الآليات المؤسسية». وأظهر البعض مرونة شخصية. ولمواجهة التحديات، أنشأ الطلاب شبكات دعم، وطوّروا عادات دراسية، وأطلقوا مبادرات توعية لتثقيف مجتمعاتهم، لافتين إلى «أنها جميعها لا تُغني عن المسؤولية المؤسسية».
وتوصي الورقة البحثية باتباع نهج شامل في الجامعات تجاه الدمج، مبني على مبادئ التصميم الشامل للتعلم. وذلك عبر إعادة بناء البنية التحتية المُيسّرة تضم المنحدرات والمصاعد والمختبرات المُكيّفة والمسارات الآمنة. بالإضافة إلى دمج منهجيات التدريس الشاملة والتكنولوجيا المساعدة لتلبية احتياجات التعلم المختلفة. مع ضرورة وضع برامج انتقال وتوجيه مُهيكلة للطلاب المعوقين الذين يدخلون الحياة الجامعية. وتوصي الدراسة أيضاً بإضفاء طابع رسمي على إجراءات الإفصاح والتسهيلات التي تضمن السرية والدعم في الوقت المناسب. وتدريب إلزامي ومستمر لأعضاء هيئة التدريس والموظفين لمواجهة المواقف المُتحيزة ضد ذوي الاحتياجات الخاصة.