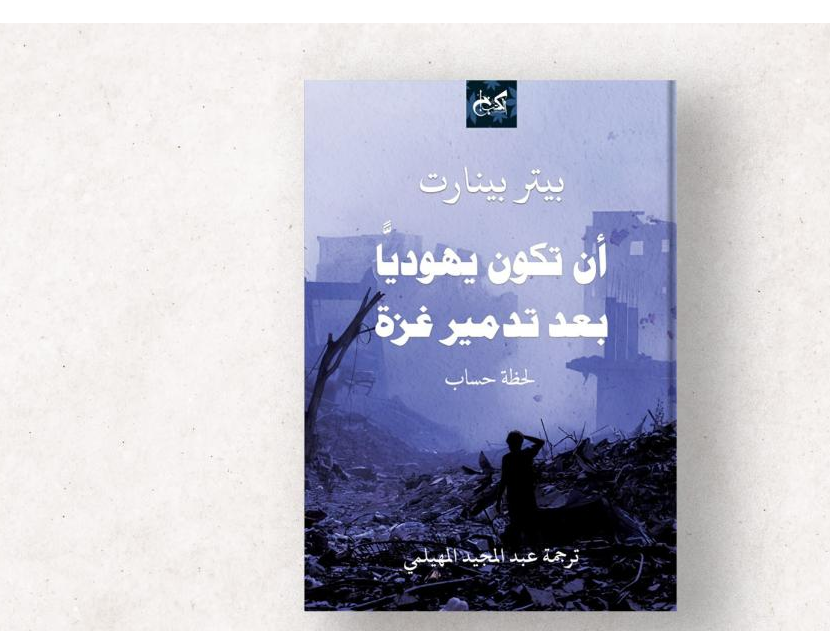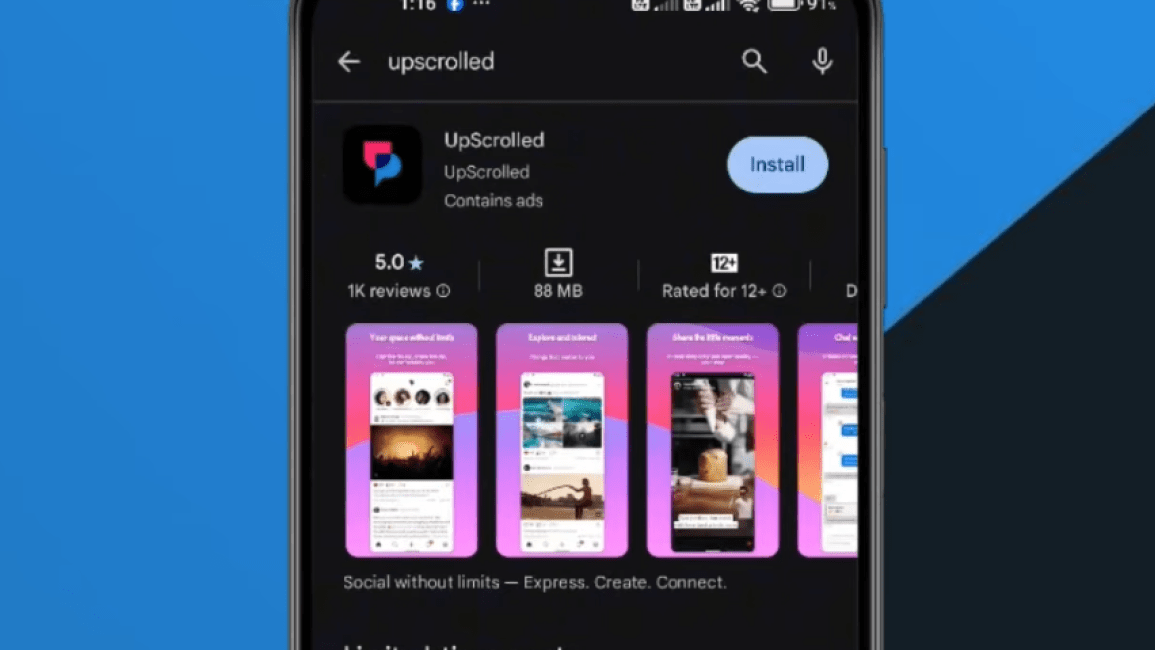عباس الصادق/ جريدة الأخبار
في سياق الهيمنة المتزايدة للنظام السعودي على الفضاءات الدينية، كما يتضح من قرارات وزارة الشؤون الإسلامية منها مثلًا منع تصوير الصلوات في المساجد، برزت أشكال مبتكرة من المقاومة الثقافية الرقمية التي تستدعي تحليلًا متأنيًا.
يشكّل منع التصوير في عدد من المساجد نموذجًا دالًا على هذه الديناميكية، إذ تحوّل المصلون من متلقين سلبيين للقرارات الأمنية إلى فاعلين إعلاميين، مستغلّين منصات التواصل الاجتماعي لإعادة إنتاج الخطاب الديني خارج السيطرة الرسمية. هذه الظاهرة التي بدأت كرد فعل عفوي، تطورت لتصبح نموذجًا مثيرًا لتحولات القوة في العصر الرقمي.
تشير الوقائع إلى تحول لافت في موازين القوّة الإعلامية، إذ انتقل المواطنون من موقع المتلقّي السلبي للقرارات إلى فاعلين إعلاميين مؤثرين. بعد قرار المنع، تحولت هواتف المصلين إلى أدوات توثيق ونشر، لتُعيد إنتاج الخطاب الديني خارج السيطرة السعودية الرسمية، في تحول دقيق لموازين القوّة الرمزية.
المصلّون... مراسلون!
هكذا، يمثّل تحوّلُ المصلين إلى «مراسلين»، إعادة توزيع دقيقة للسلطة الإعلامية، إذ يتحول الفعل الظاهري البسيط (التصوير) إلى أداة مقاومة خفية. وقد نجح المصلون في السعودية في إعادة تعريف المسجد كـ«فضاء معاش»، في تحدّ ناعم لمحاولات تجريده من بُعده الجماعي والسياسي.
تكشف هذه الممارسات التوثيقية في السعودية عن تحوّل المصلين إلى ما يشبه «الشبكة المضادة»، إذ يعمل التوزيع الأفقي للصور على تجاوز الحدود الجغرافية والرقابية. ورغم أن الدوافع الفردية قد تكون مختلطة (دينية، وعائلية، واجتماعية)، إلا أنّ التأثير الجمعي لهذه الممارسات يخلق سرديةً مضادةً للرواية الرسمية، ما يعزز استمرارية الهوية الدينية للجماعة.
في تحليل ديناميكيات المقاومة الرقمية هذه، تبرز إشكالية جوهرية في الفجوة بين الدوافع الفردية والتأثير الجمعي؛ بينما ينطلق عدد من المشاركين في الحملة التوثيقية غير المنظمة من دوافع شخصية تبدو بريئة ـــ كرغبة في مشاركة لحظات الصلاة مع الأقارب أو حفظ الذكريات الدينية ـــــ إلا أن السياق التاريخي للتوتر بين السلطة وبعض المكونات، والطبيعة القمعية للإجراءات الرسمية، يحولان هذه الممارسات العفوية إلى أدوات مقاومة ذات أبعاد سياسية. هذا التحول يحدث عبر آلية تراكمية، إذ يضفي التكرار والانتشار الجماعي طابعًا تنظيميًا يتجاوز النوايا الفردية.
إنّ صعوبة إجراء مقابلات مباشرة مع المشاركين جراء القمع تدفعنا إلى قراءة ما بين السطور، حيث نكتشف تناقضًا دالًا بين الخطاب العلني (نشر الفرحة مع الأهل) والرسالة الضمنية (نحن هنا ولن نختفي).
هذه الديناميكية تؤكد أن الممارسات اليومية، مثل التصوير العادي، يمكن أن تتحوّل في سياقات القمع إلى أشكال من «المقاومة الخفيّة»، إذ تكتسب الصورة التوثيقية البسيطة مع تكرارها دلالات سياسية تتجاوز وعي بعض المشاركين أنفسهم، ما يجعل من هذه الظاهرة حالةً دراسيةً مثيرةً لفهم تحولات المقاومة في العصر الرقمي.
من وسائل اتصال إلى أدوات تغيير
يشير التحليل إلى أنّ هذه المقاومة ـــ على الرغم من فعاليتها النسبية ـــ تبقى هشة بسبب قدرة النظام على حظر الحسابات وملاحقة الناشطين. ولتحويلها من رد فعل عفوي إلى إستراتيجية مستدامة، يتطلب الأمر تطوير آليات تنظيمية أكثر تطورًا:
1) بناء شبكات تواصل موازية ذات بنية لا مركزية.
2) توظيف تقنيات الحماية الرقمية (التشفير، المنصات البديلة).
3) الانتقال من التوثيق إلى آليات الضغط الملموسة (تقارير دولية، مقاضاة).
4) تعميم النموذج على قضايا أوسع لتعزيز الشرعية والتأثير.
إن أهمية هذه الظاهرة تكمن في قدرتها على تحويل الأدوات الرقمية من وسائل اتصال إلى أدوات تغيير، مع الحفاظ على التوازن بين التعبير عن الهوية الخاصة والمطالبة بالحقوق العامة. وهي تطرح أسئلة جوهرية حول حدود المقاومة الرقمية في السياقات القمعية، وإمكانات تحويل التكتيكات الفردية إلى حركات منظمة قادرة على إحداث تغيير بنيوي.