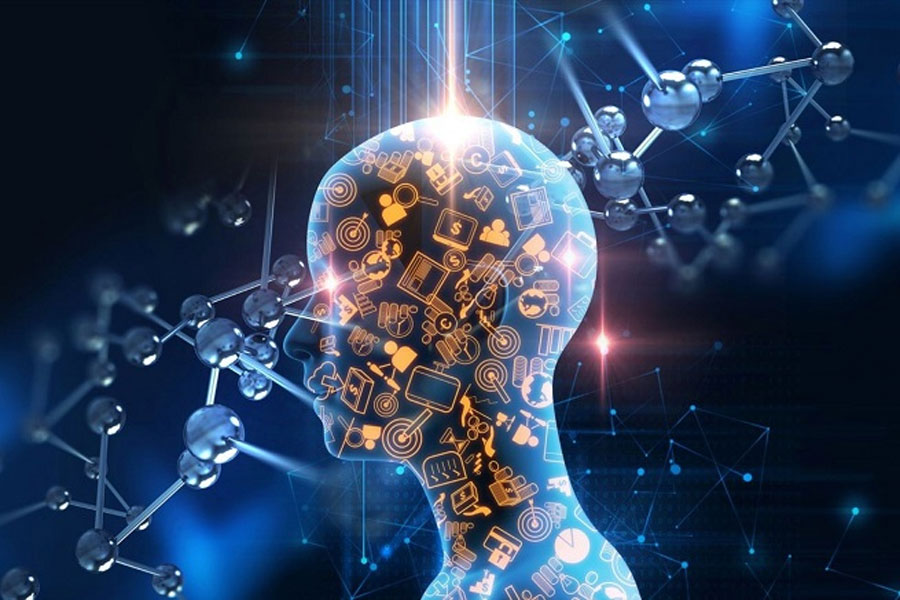د. ميلاد سبعلي (جريدة الديار)
الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرّد تقنية تزيّن أطراف حياتنا اليومية، بل بات أشبه بعاصفة تعيد رسم خرائط الاقتصاد والسياسة والثقافة والمعرفة. إنّه القوة التي يمكن أن تفتح للبشرية باباً إلى نهضة جديدة، كما يمكن أن تكون أداة لزيادة الفجوات وتفكيك المجتمعات. والعقد الاجتماعي الذي قامت عليه الدولة الحديثة، والقائم على تبادل العمل بالكرامة والأمان والمشاركة، أصبح اليوم عرضة لاهتزازات عميقة مع دخول لاعب جديد لم يكن في الحسبان: الذكاء الاصطناعي وما يرافقه من انتاج وتحليل البيانات الكبيرة.
ولعل العودة إلى الفلسفة الأولى للعقد الاجتماعي عند جان جاك روسو، بما فيها من تركيز على "الإرادة العامة" والصالح المشترك، تتيح لنا أن نفهم أن إعادة تعريف هذا العقد في زمن الذكاء الاصطناعي ليست ترفاً فكرياً بل ضرورة وجودية.
أولاً: إمكانية النهضة وتمكين الإنسان والمجتمع
حين نطل على الذكاء الاصطناعي من نافذة الأمل، يتبدّى لنا أفق يشبه البدايات الكبرى للنهضات التاريخية. فهو ليس مجرد تحسين ميكانيكي في أدوات الإنتاج، بل طاقة كامنة لتحرير الإنسان وإطلاق قدراته في كافة القطاعات والمجالات وتطوير المجتمعات ونهضتها.
• في التعليم: منصات تكيفية تولّد محتوى فردياً لكل طالب، وتفتح باب المعرفة للجميع بلا حدود.
• في الصحة: أدوات تشخيص مبكر وروبوتات جراحية دقيقة ترفع مستوى العلاج وتُعمّم الخدمة.
• في الاقتصاد والعمل: خوارزميات تدرس الأسواق وتبني توقعات دقيقة، فيما الأتمتة تتولى المهام الروتينية لتفسح المجال أمام الإبداع البشري.
• في الإعلام والإبداع: إنتاج نصوص وصور وألحان وأفلام عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعزز التعبير الفني ويمنح الجميع قدرة على الإبداع.
• في الأمن والسياسة: نظم قادرة على تحليل بيانات ضخمة ورصد اتجاهات الرأي العام والتنبؤ بالأزمات، ما يعزز قدرة الدول على الاستشراف. إضافة الى التطبيقات العسكرية والأمنية الحديثة.
• في البيئة والطاقة: شبكات ذكية لإدارة الكهرباء والاستفادة القصوى من الطاقة المتجددة، ونظم قادرة على التنبؤ بالكوارث المناخية وتقديم حلول استباقية.
بهذا الطيف الواسع، يبدو الذكاء الاصطناعي كقوة عابرة للقطاعات، تحمل في جوهرها وعداً بنهضة شاملة إذا وُضعت في خدمة الإنسان والمجتمع.
ثانياً: مخاطر التفكك والتهميش والتخلف
لكن الوجه الآخر لا يقل وضوحاً. فالتاريخ علّمنا أن كل ثورة تقنية أعادت توزيع الثروة والسلطة. مع الثورة الصناعية ظهرت طبقة العمال، ومع الثورة الرقمية برزت فئة العاملين في قطاعات المعرفة. أمّا اليوم، فالمعادلة أكثر قسوة:
• اللامساواة داخل الدول: نخبة صغيرة من المطوّرين والمالكين للبنى التحتية تحصد المكاسب، فيما تتآكل وظائف الفئات الواسعة من متوسطي الدخل، حتى تلك التي اعتُبرت يوماً عصيّة على الأتمتة.
• الفجوة بين الدول: الدول المالكة لمراكز البيانات والطاقة والبنية التحتية المتقدمة والتمويل تتسارع في إنتاج المعرفة، بينما تُترك الدول النامية مستهلكة تابعة.
• تهديد الديمقراطية: حين تحتكر شركات كبرى الخوارزميات الذكية والبيانات، تصبح قدرتها على توجيه الرأي والقرار السياسي أخطر من سلطة الحكومات نفسها.
• فقدان قيمة العمل: العمل، بما يحمله من كرامة وهوية وانتماء، مهدّد بفقدان قيمته في ظل أتمتة شبه كاملة، ما يفتح الباب لأزمات وجودية وثقافية عميقة.
ثالثاً: كيف يحدث عدم الاستقرار؟
عدم الاستقرار لا يظهر كعاصفة مفاجئة، بل يتسلل تدريجياً عبر سلسلة من الصدمات:
• سوق العمل: ملايين الوظائف مهددة بالاختفاء أو التحوّل، خصوصاً في القطاعات الخدمية، ما يولّد شعوراً بالاغتراب والإحباط لدى الأجيال الجديدة.
• البنية التحتية: مراكز البيانات العملاقة تستهلك موارد هائلة من الكهرباء والمياه، وقد تشعل أزمات في بلدان تعاني أساساً من نقص.
• الهيمنة الاقتصادية: احتكار البيانات والخوارزميات الذكية يضع الحكومات تحت رحمة شركات قليلة، وطنية أو عابرة للقارات.
• الأوضاع الجيوسياسية: الذكاء الاصطناعي أصبح محور سباق تسلح جديد؛ المعادن النادرة والرقائق والشبكات تحوّلت إلى أسلحة استراتيجية تحدد موازين القوى.
رابعاً: إعادة بناء العقد الاجتماعي وطنياً
إنّ العقد الاجتماعي الذي وُلد مع الدولة الحديثة بُني على معادلة واضحة: المواطن يقدّم عمله وجهده، والدولة تحفظ له الأمن والكرامة والحق في العمل والمشاركة في الإنتاج. لكن مع اندفاع الذكاء الاصطناعي إلى صميم الاقتصاد والمجتمع، لم تعد هذه المعادلة صالحة كما هي. نحن أمام لحظة تاريخية تستدعي إعادة صياغة العقد الاجتماعي على أسس جديدة، تعيد التوازن بين الحقوق والواجبات، وتضمن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة للتحرير والتمكين، لا وسيلة للتهميش والإقصاء.
• التأهيل والتعليم المستمر: لم يعد العلم محطة عابرة في مطلع العمر، بل أصبح رفيق الطريق من بدايته إلى نهايته، تفادياً للبطالة والخروج من سوق العمل. إنّ الجامعات والمدارس مطالبة بأن تتحول إلى منصات مفتوحة للتدريب مدى الحياة، تمنح الأفراد القدرة على اكتساب مهارات جديدة مع كل منعطف، من تحليل البيانات إلى إدارة النظم الذكية، الى الابتكارات المستقبلية، حتى لا يبقى أحد أسيراً لماضٍ تجاوزه الزمن، ويخرج من سوق العمل الى البطالة.
• إعادة تعريف الأجور والتعويض: لم يعد ممكناً أن يظل الدفع مرتبطاً بالساعات أو المهام، بل يجب أن يُعاد النظر في أساس التعويض، بحيث يركّز على الإبداع الإنساني والتفكير النقدي والتعاطف الأخلاقي، وهي القيم التي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تكرارها.
• شبكات أمان اجتماعي جديدة: في عالم قد لا يكفي فيه العمل لإعالة الجميع، يصبح الدخل الأساسي الشامل صوناً للكرامة لا ترفاً. كما أن تقليص أسبوع العمل أو اعتماد النماذج المرنة والهجينة، هو ليس مجرد تعديل في ساعات الدوام، بل إعادة اكتشاف لزمن الإنسان، حيث يتاح له أن يتعلم، ويبدع، ويتمتع بحياة أكثر اتزاناً.
• المشاركة المجتمعية: لا يجوز أن تُدار التحولات الكبرى بقرارات فوقية، ولا أن تُترك للشركات لتحدد مصير الأفراد. إشراك النقابات والمجتمع المدني والهيئات العلمية ضرورة لضمان أن تُقاس القرارات بميزان العدالة الاجتماعية لا بميزان الأرباح فقط.
• إعادة تعريف العمل: حين تهتز الوظائف التقليدية، لا بد من الاعتراف بأشكال أخرى من العطاء: رعاية الأسرة، العمل التطوعي، الإبداع الثقافي والفني. هذه ليست هوامش، بل مساهمات جوهرية في الحياة الجماعية، تستحق أن تكون جزءاً من العقد الاجتماعي الجديد.
• تسخير التكنولوجيا نفسها: الذكاء الاصطناعي ليس قدراً أعمى، بل يمكن أن يكون منصات للتوظيف العادل، وأنظمة شفافة لإدارة الموارد، وأدوات لفتح أبواب التعليم والتدريب أمام الجميع. هو التحدي وهو الحل، إذا أحسنا توجيهه.
النماذج العملية من العالم، ولو أنها ما زالت في مراحل ابتدائية، تثبت أن الأمر ليس حلماً بعيداً: فنلندا أعادت الثقة للمواطنين عبر تجربة الدخل الأساسي، آيسلندا رفعت الإنتاجية والرضا بتقليص ساعات العمل، والمملكة المتحدة حسّنت حياة الموظفين بتجارب العمل المرن والهجين (حضورياً وعن بعد). كلها شواهد على أنّ الإرادة السياسية قادرة على تحويل الأفكار إلى واقع.
إنّ إعادة بناء العقد الاجتماعي ليست مجرد إصلاح إداري، بل هي فعل حضاري يعيد رسم علاقة الدولة بمواطنيها في زمن تتغير فيه قواعد اللعبة. إما أن نغتنم هذه اللحظة فنحوّل الذكاء الاصطناعي إلى شرارة نهضة، أو نهملها فننزلق إلى بطالة ممتدة، وتمزق اجتماعي، وتآكل في الثقة بالمؤسسات. إنها لحظة خيار وجودي: هل نجعل الذكاء الاصطناعي حليفاً للإنسان أم خصماً له؟
خامساً: حوكمة الأسواق ومنع الاحتكار
منطق السوق اليوم يقوم على أن "الفائز يأخذ كل شيء". ومع الذكاء الاصطناعي، يزداد الخطر لأنّ الفائز يحتكر المعرفة والبيانات والتأثير. لذلك تصبح الضوابط ضرورة لا ترفاً:
• الشفافية والمساءلة: إخضاع الخوارزميات الذكية للتقييم المستقل وكشف انحيازاتها.
• المعايير البيئية: إلزام مراكز البيانات بالاعتماد على الطاقة النظيفة وترشيد المياه.
• مكافحة الاحتكار: تشريعات تمنع سيطرة الشركات على السوق من خلال الاستحواذ على المنافسين أو احتكار البيانات.
• حماية المستهلك: منح الأفراد الحق في معرفة كيفية استخدام بياناتهم، والقدرة على رفض استغلالها.
سادساً: التعاون الإقليمي بين دول المشرق العربي ومع العالم العربي
التعامل مع هذه الموجة لا يمكن أن يتم على مستوى كل دولة بمفردها. المطلوب بناء جبهة عربية موحدة تجمع القدرات، وتؤسس لمراكز أبحاث إقليمية، وقواعد بيانات عربية تعكس الثقافة والقيم، وشبكات تعليمية وتدريبية عابرة للحدود.
وتبرز هنا أولوية التعاون بين دول المشرق العربي كقاعدة صلبة، تتكامل لاحقاً مع دول الخليج ومصر والمغرب العربي لتشكيل إطار عربي شامل، يوفّر وزناً تفاوضياً أكبر وقوة رقمية متماسكة في مواجهة القوى العالمية. ويشمل هذا التعاون قطاعات عدة:
• في التعليم والتدريب: إنشاء منصات مشتركة للتعليم الذكي، مع برامج إقليمية لتأهيل الشباب في المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
• في الصحة: إنشاء قواعد بيانات طبية وطنية وإقليمية، بما يخلق مرجعاً صحياً شاملاً يدعم التشخيص المبكر والعلاج عن بُعد.
• في الاقتصاد والعمل: إنشاء منصات تجارة رقمية موحدة، وأتمتة للخدمات الحكومية والمالية، وتعزيز قطاعات الإنتاج الذكية، وإحداث ممرات رقمية لوجستية تدعم التجارة البينية والترانزيت.
• في الإعلام والإبداع: تشجيع انشاء استوديوهات ومراكز محتوى رقمي لتطوير محتوى عربي منافس عالمياً، وصالح لتدريب منظومات ذكاء اصطناعي عربية.
• في الأمن والسياسة: تعاون سيبراني وتحليل بيانات مشترك في المشرق العربي لمواجهة التهديدات المباشرة، يتوسع لاحقاً ليشمل منظومة عربية متكاملة للأمن الرقمي.
• في البيئة والطاقة: شبكات ذكية لإدارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والنفط والغاز، من خلال مشاريع عابرة للحدود في كيانات المشرق العربي، ثم تمتد إلى ربط عربي أوسع، مدعوم بأنظمة إنذار مبكر للكوارث.
وفي هذا الإطار، تصبح الدبلوماسية الرقمية ضرورة للتنسيق بين دول المنطقة، بغضّ النظر عن الخلافات السياسية أو اختلاف الأنظمة، ومن أجل بناء موقف موحد في المحافل الدولية، وحماية المصالح المشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتنمية الحديثة.
ولتعزيز السيادة الرقمية، يجب التأسيس لتعاون مشرقي وعربي: عبر بنية تحتية تكنولوجية وسحابات مشتركة، وتشريعات موحدة، وقواعد بيانات تعكس الهوية والثقافة، بحيث تبقى ثروتنا الرقمية ملكاً لنا لا ورقة بيد الآخرين.
إنّ التعاون في المشرق العربي هو المدخل العملي، والتعاون العربي الشامل هو الأفق الاستراتيجي. فكما استطاع الاتحاد الأوروبي توحيد سياساته الرقمية، وتمكنت الآسيان من تنسيق جهودها رغم اختلاف أنظمتها، يمكن للعرب – من التكامل المشرقي الى التكامل مع البيئات العربية الأخرى – أن يصنعوا مكاناً لهم في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
الإطار الاستراتيجي المستقبلي للتعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي
لا بد من تخطيط إطار استراتيجي مستقبلي للتعاون العربي على مراحل:
• على المدى المباشر: تدريب الشباب على التفكير النقدي والإبداعي، وتمكينهم من كشف انحيازات الأنظمة الذكية وكيفية استخدامها بشكل فعّال وذكي.
• على المدى المتوسط: تطوير تطبيقات عربية هجينة تمزج بين المحتوى العربي الأصيل والمحتوى العالمي المنقّى من الانحيازات.
• على المدى الطويل: بناء منظومة ذكاء اصطناعي عربية متكاملة تشارك في إنتاج المعرفة الرصينة على انواعها، لا أن تظل مجرد مستهلك لها.
سابعاً: إعادة توزيع الثروة عالمياً
إن تأثيرات الذكاء الاصطناعي لا تقف عند حدود الدولة أو الإقليم، بل تتجاوزهما إلى النظام العالمي برمّته. فبينما تحصد الشركات العملاقة في الدول المتقدمة أرباحاً هائلة من امتلاكها للتقنيات الذكية والبنية التحتية والبيانات، تجد الدول النامية نفسها مستهلكة ومتأخرة، تتحمل كلفة البطالة والتحولات الاجتماعية دون أن تنال نصيباً من العوائد. هذه المفارقة تهدد بتكريس شكل جديد من "الاستعمار الرقمي" ما لم تُبذل جهود لتصحيح الخلل.
• نظام عالمي جديد: تبرز الحاجة ملحّة لإنشاء صندوق دولي للذكاء الاصطناعي يُموَّل بجزء من أرباح الشركات الكبرى، ويعاد استثماره في مشاريع تنموية في الدول النامية، مثل بناء شبكات الإنترنت والبنية التحتية التكنولوجية الحديثة، وتطوير التعليم الرقمي، ودعم الابتكار المحلي.
• ضرائب عابرة للحدود: لا بد من فرض نظام ضريبي عالمي على عمالقة التكنولوجيا، على غرار الضرائب البيئية المفروضة على الملوثين، يضمن إعادة توزيع عادل للثروة الرقمية بدلاً من تراكمها في مراكز محدودة.
• شراكات عادلة: يجب أن تكون الدول النامية شريكاً فاعلاً في صياغة المعايير والقوانين الدولية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، لا متلقياً سلبياً. إشراكها في هيئات الحوكمة العالمية يمنحها حقاً في تقرير مستقبل التكنولوجيا، وفي ضمان أن تكون القواعد الجديدة أكثر عدلاً وتوازناً.
إنّ مثل هذه الآليات وحدها قادرة على تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة لتعميق الفجوة بين الشمال والجنوب، وبين الدول المتطورة تكنولوجياً والدول النامية، إلى جسر يعيد وصل الإنسانية ببعضها، ويجعل من الثورة الرقمية فرصة للتقارب لا للتباعد، وللعدالة لا للهيمنة.
أخيراً، الإنسان في قلب المعادلة
الذكاء الاصطناعي ليس قدراً محتوماً، بل انعكاس للخيارات التي نتخذها. إذا تركناه لمنطق السوق والاحتكار، فسوف يجرّنا إلى عالم أكثر هشاشة واستقطاباً. أما إذا واجهناه بإرادة سياسية، وبحوكمة رشيدة، وبعقد اجتماعي جديد، فسوف يتحول إلى قوة نهضة تاريخية.
المعركة إذن ليست تقنية فحسب، بل أخلاقية وحضارية: هل نصوغ الذكاء الاصطناعي كأداة لتحرير الإنسان وتوسيع آفاقه، أم نسمح له أن يكون وسيلة لإقصائه وتهميشه؟ الجواب يتوقف علينا نحن، وعلى القرارات التي نتخذها اليوم، قبل أن يصبح الغد محسوماً.
نحن إذاً بحاجة لعقد اجتماعي جديد، حيث لا تُقاس قيمة الإنسان بإنتاجه الاقتصادي فقط، بل بقدراته الإبداعية والأخلاقية ومساهمته في الصالح العام. المطلوب عقد اجتماعي عالمي جديد يضمن أن فوائد الذكاء الاصطناعي لن تذهب لنخبة صغيرة، بل تُوزَّع بعدالة وديمقراطية، عبر مشاركة المجتمعات نفسها في صياغة القوانين الحاكمة لهذه التقنية، تماماً كما أراد روسو أن يكون "الإجماع العام" هو الضامن للخير المشترك.