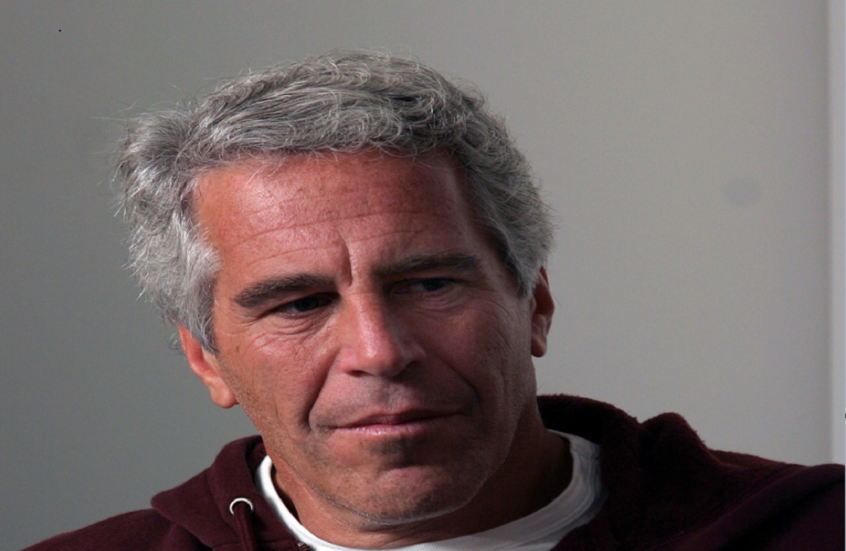محمد سامي الكيال/ القدس العربي
جدّدت وفاة الموسيقي اللبناني زياد الرحباني جدالات كثيرة، لم تنقطع يوماً، شديدة التسيُّس، حتى لو لم تلامس القضايا السياسية مباشرةً، واقتصرت على مسائل فنيّة وموسيقية. وهذا أمر متوقّع، إذ لم ينقطع الفنانون الناطقون بالعربية يوماً عن معالجة مسائل مثل الهوية والحداثة والوطنيّة، وكلها سياسية بالعمق، فما بالك بالرحباني الابن، ذي التصريحات السياسية النارية، الذي ارتبط اسمه باثنتين من أكثر القضايا إشكالية في الجدل السياسي العربي المعاصر: الحرب السورية والمقاومة اللبنانية. وقبلها ارتبط بأحداث وتواريخ لا تقلّ إشكالية، مثل الحرب الأهلية اللبنانية؛ الحركات الشيوعية؛ والتمرّد على ما سميّ «الصيغة اللبنانية»، سياسياً وثقافياً.
ترتفع دعوات كثيرة لعدم تسييس ذكرى الرحباني بعد وفاته، كونه موسيقيا أولاً وأخيراً، يُقيّم ويُستعاد على هذا الأساس، وما الإصرار على الجدل السياسي حوله إلا علامة غير صحيّة، على تسيُّس مفرط في الحيز العام العربي، يترافق عادةً مع صعود كل أنوع التطرّفات والشعبوية. إلا أن مثل هذه الدعوات لا تحترم رغبة الراحل نفسه، وطريقته في فهم وتقديم نفسه وأعماله، فهو دوماً رأى نفسه فناناً مُسيَّساً، يُضمِّن أعماله كثيراً من المحتوى السياسي، المباشر أو غير المباشر، حتى في أكثر الأغاني عاطفيةً، بل حتى في تعامله مع اللغة والطابع النَّغَمي. وهذا لا ينتقص بالتأكيد من قيمة أعماله، فالسياسة أحد المنظومات التي يتعامل معها الفن، تماماً مثل الدين والأخلاق وغيرها من أنظمة المجتمع، والمقياس هنا هو «اللغة الفنيّة» في التعامل مع تلك المنظومات، أي القدرة على تحويلها إلى شأن فني، وإعادة صياغتها ضمن ترميزات نظام الفن، المتعلّقة بالجماليات، لا أن يُعامل الفن وفق ترميزات أنظمة خارجة عنه. وكان الرحباني صاحب لغة فنيّة فريدة بكل المعايير، إلا أن بتر السياسة من أعماله، سيؤدي إلى قراءة وتلقٍّ فقير لها، يضيّع كثيراً من دلالاتها، وأيضاً جمالياتها.
المشكلة ليست في «التسييس» إذن، بل في «الفنيّة» المفرطة، والزائفة غالباً، في بعض محاولات التلقي، وهي بدورها ذات مغزى مُسيّس في العمق، إذ تحاول معارضة ونقد بيئة سياسية معيّنة، والتهرّب منها، نحو اختلاق أخرى، تعتبرها أكثر «صحيّة». وبالتأكيد، ليست جدالات الحيز العام العربي مَنْ سيّس فن الرحباني قسراً، بل ربما كان العكس صحيحاً، كان هو ممن ساهموا بشدة في تسييس جيل أو جيلين عبر الفن، وإدخالهما إلى جدالات الحيز العام وصراعاته، والتعامي عن ذلك خاطئ حتى من زاوية النقد الثقافي، الذي يجب أن يحقق، مبدئياً، نوعاً من الفهم الداخلي للظاهرة التي يعالجها.
يمكن تمييز عناصر متعددة في سياسيّة الرحباني، يجوز ردّ أغلبها إلى الشعبوية، وهي ليست تهمة أو شتيمة، بل هي تكتيك سياسي، لطالما كانت له تعبيراته الفنيّة عبر التاريخ، خاصة مع انتشار «الثقافة الجماهيرية»، بوصفها أحد أهم ظواهر التحديث، أياً كان الموقف الفلسفي منها. للراحل أعمال كثيرة، مثل ألبوم «أنا مش كافر»، يمكن تصنيفها ضمن البروباغندا، التي ليست بدورها شتيمة، وإنما شكل فنّي ساهم بشدة في تطوير الفنون المعاصرة، وصار جزءاً من الثقافة الجماهيرية في كل أنحاء العالم؛ فضلاً عن تخصص الرحباني بالسخرية السياسية والاجتماعية؛ أما الأعمال غير المباشرة سياسياً، فكانت تحوي مواقف واضحة، من مسائل مثل الهوية والتمدّن والطبقة ولغة التواصل. وفي أحيان كثيرة كان يقدّم توضيحات مبسّطة لغاياته الفنية/السياسية، كما في فيلم «هدوء نسبي»، الذي أنتجه بالتوازي مع ألبوم يحمل الاسم نفسه، يحوي «موسيقى صامتة»، وبعض الأغاني العاطفية، ليشرح أشياء كثيرة عن الهوية الموسيقية، وما سمّاه آنذاك «الجاز الشرقي» (تراجع عن التسمية في ما بعد)، وهوية لبنان (قرص فلافل على هيئة هامبرغر، حسب تعبيره)، والوضع السياسي والاجتماعي العام، وكأنه يريد القول: لا تظنوا أني تخلّيت عن القضية، حتى عندما لا أقدّم لكم كلاماً واضحاً، إلا أن تلك الشعبوية لم تكن تقليدية، أو حتى كلاسيكية (ربما ستصبح كذلك الآن)، بل يمكن وصفها بالمضادة، أي بالضد من الهوية السياسية والوطنية لبلده، ومفهومها عن «الشعب»، والتي ساهمت عائلته في صياغتها.
وصلت شعبوية الرحباني الابن المضادة إلى درجة التهكّم القاسي من «الشعب»، بل حتى تجريمه وإدانته والدعوة إلى محاسبته في بعض الأحيان، وخصص ثلاثة أعمال مسرحية بشكل كامل لهذا، وهي «فيلم أمريكي طويل»، «بخصوص الكرامة والشعب العنيد»، و»لولا فسحة الأمل». أراد زياد الرحباني أن يبني شعباً مضاداً لـ»الشعب»، وكلما أحسّ بعبثيّة ذلك ازداد سوداويةً وتهكماً، إلا أن شعبويته المضادة لم تذهب سدىً، فقد بات هناك كثير من «الزياديين»، شعب من الساخرين السوداويين، الذين يجمعون بين النقد الاجتماعي القاسي والالتزام الشديد بقضية ما، غالباً وطنية. ما يدلُّ بوضوح على أن نقد الرحباني للوطن والأخلاق والشعب، كان ينبع من موقف وطني وأخلاقي وشعبي مفرط. يمكن اعتبار محاولات وتجارب زياد الرحباني هذه من أفضل ما أنتجته المنطقة ثقافياً، في التعاطي مع أسئلة التحديث والهوية، إلا أنها تبدو، مثل سيرة حياة صانعها، كلما تهكّمت ازدادت التزاماً؛ وكلما شتمت «الشعب العنيد» التصقت به أكثر؛ وكلما تمرّدت أخلاقياً وفكرياً عادت إلى أحضان «المقاومة الإسلامية» وطقوس الدفن الكنسي. فهل يمكن بالفعل تجاوز الزيادية؟ أم أن كل محاولة لنقد الشعب والوطن، بكل مآسيهما، ستنتهي إلى «شي فاشل»، مهما بلغت نجوميته وعبقريته؟
غير شرقي
توجد في التراثات الدينية والأسطورية الشعبية، خاصة المسيحية منها، وضعية «غير الميّت»، أي الضائع بين عالمي الفناء والخلود، دون أن ينال الخلاص. وقد ألهم هذا أدب الرعب المعاصر بشدة، وصار ثيمة متكررة، في قصص الأشباح ومصاصي الدماء والموتى الأحياء، بكل دلالاتها الاجتماعية والتاريخية والنفسيّة. هؤلاء لا يموتون، ولكنهم لا ينالون النعمة الإلهية، التي تشكّل جوهر الحياة. قد يشعر «غير الميت» بنشوة في البداية، نظراً لكونه لا يفنى مثل بقية البشر، ولكن سرعان ما يدرك أنه فاقد للحياة والخلاص. وربما يكون هذا الترميز الأسطوري مناسباً لإدراك مأساة وملهاة زياد الرحباني، بوصفه «غير شرقي».
نَظَّر زياد الرحباني، بأسلوب شعبوي، لفكرة النَفَس غير الشرقي في الموسيقى، والهوية عامةً، حتى عندما يتعامل مع مقامات ونغمات شديدة الشرقية. «المضمون» هنا قد يكون شرقياً خالصاً، أو مزيجاً من ثقافات متنوّعة؛ ولكن عبقرية الشكل تكمن في «العالمية»، أي في التوزيع والأداء والمزج المناسب للأذن المعاصرة، الأقرب لـ»الغربية»، ما يكشف، في نهاية المطاف، أن لا فارق جذرياً بين شرق وغرب، وكله ممتزج على أرضنا، ومتقارب بشكل حميم. بإمكان زياد أن يكون شرقياً جداً، ولكن شرقيته هذه أقرب لمحاكاة ساخرة، كما تبدّت في ألبوم «في الأفراح»، وكثير من الأعمال اللاحقة. وهذه المحاكاة الشرقية ترسّخ صورة مُنتج المحاكاة بوصفه غير شرقي تماماً، دون أن يكون غربياً.
اعتُبرت «غير الشرقية» هذه، من قبل زياد وكثيرين غيره، جوهر مشروع الرحابنة، بكل أطواره، وكذلك جوهر التمرّد عليه، باتجاه تعميقه وتجذيره؛ بل ربما جوهر الهوية اللبنانية. وكانت فكرة شديدة الجاذبية لكثير من المثقفين، إلا أنها تكشّفت في ما بعد عن ثغرات كبيرة، فالمزج الموسيقي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى الاستسهال والنمطيّة، نظراً لعمله على الإلصاق المفتعل لعناصر مألوفة ومترسّخة، لإظهار «المزج»، وهو ما بدا واضحاً لدى معظم تلاميذ زياد الرحباني والمتأثرين به؛ أما «العالمية» فليست أكثر من مفهوم غامض، انقلب، في حالات كثيرة، إلى تقديم رخيص للذات والثقافة، في مؤسسات غربية تُعنى بـ»التبادل الثقافي»، وتسجن مثقفي المنطقة وفنانيها وناشطيها بأدوار محدودة، تتسم بالدونيّة، ولا ترقى إلى مصاف «الثقافة الرفيعة»؛ والأهم أنه لا يوجد ما هو «غير شرقي»، فلبنان، بكل «عالميته» و»مزائجه»، كان مثل غيره، موطناً لكل أشكال التطرفات، والمظاهر العالمثالثية الرثّة، وأحياناً في طليعتها، بما فيها الميليشيات الدينية، والإمارات الإسلامية، والاعتداءات الشاملة على الحريات. زياد الرحباني فهم هذا أسرع من غيره، ما قاده إلى مزيد من التهكّم والسوداوية، من الذات قبل الآخرين. لقد صار عالقاً في وضعية «غير الشرقي»، الذي شهد انحطاط كل المشاريع التي آمن بها، على كل المستويات؛ والذي لا يستطيع أن يلبس عمامة المقاوم، ولا أن يتمرّد على قضيته، ما يوقعه في تناقضات بالجملة، دون أمل بالخلاص.
هذه المأساة/الملهاة أكثر عمقاً من موقفه من «الثورة السورية»، الذي لم يعد يدينه اليوم، بعد توضّح المآسي التي أنتجتها، إلا أنه يظهر تناقض «غير الشرقيين» بأغلبهم: لكل منهم تطرفاته الدينية المُحبَّذة، فيصبحون في قمة التنويرية والإنسانية، عندما يهاجمون متطرفي المعسكر الآخر؛ وينسون منطقهم، عندما يدعمون هذا الزعيم الميليشياوي أو ذاك؛ ويحملون ثقافة «عالمية»، لا تفعل إلا أن تمسخ نفسها أمام «العالم»، الذي ترغبه وتلعنه في الوقت نفسه. والنتيجة «مزيج» غريب المذاق، وغير قابل للهضم، مثل قرص الفلافل الذي يدّعي أنه ليس كذلك، والذي تحدّث عنه زياد في «هدوء نسبي».
ضد الشعب
«غير الشرقي» يدين «الشعب» بقسوة، ولكن ليس للانفصال أو القطيعة معه، وإنما لكي يصبح شعباً كما يجب أن يكون. في مسرحية «لولا فسحة الأمل»، ارتدى الرحباني زيّاً عسكرياً ذي سمة فاشيّة، وانهمك في تقويم وإعادة تربية «الشعب العنيد»؛ وفي مقابلاته تغزّل أكثر من مرة بالدول المركزية الصلبة، والأجهزة الأمنية القوية. ربما كانت مشكلته الفعلية مع ذلك «الشعب» أنه «غير شرقي» بدوره، فلا هو ملتزم مثل المقاومة الإسلامية، التي كثيراً ما رآها الشيء الوحيد الذي يعمل بشكل صحيح في البلد؛ ولا هو واعٍ ومنتج، «كما في مدينة تورينو»، وإنما «يكشّ الحمام»، حسب قوله في أحد برامجه الإذاعية. ربما كانت مشكلة زياد الرحباني مع ذاته، وقد يكون هذا ما دفعه إلى يأس مديد، دفعه إلى التوقف عن الإنتاج الفني في سنواته الأخيرة. كان من الصعب على الرحباني بالطبع تجاوز «الزيادية»، ولكن السؤال ما يزال مطروحاً على الزياديين الكُثر، الذين فُجعوا بوفاته: هل أنتم، مثل زياد، من «الشعب العنيد» في نهاية المطاف؟ الإجابة غالباً نعم، وربما كانت عبقرية زياد الرحباني هي التي جعلته يدرك ذلك مبكراً، ويغرق بعدها في محاكاة ساخرة ويائسة لذاته، وكأنه، في كل مقابلة وحفلة، يمثّل أنه زياد، الذي لم يعد يؤمن به.
قد تكون هناك آفاق أخرى، لم يستطع زياد الرحباني تمييزها، نظراً لثقافته السياسية، وإرثه العائلي، ومكانته الرمزية، وانغماسه في كل الحوادث الكبرى التي شهدتها المنطقة. وتلك الآفاق توجد بالضرورة خارج المفاهيم، التي حاول التمرّد عليها من الداخل، وإعادة ترتيب عناصرها بشكل ساخر. وعلى الرغم من أنه ألّف وأعاد توزيع عدد من أجمل الألحان الكنسيّة (ما ينفي قطيعته مع الإرث المسيحي) فإنه لم ينتبه بما فيه الكفاية على ما يبدو إلى مفهوم «الخروج» Exodus، الأساسي في التراث اليهودي/المسيحي، أي الانسحاب، الهرب، من الدوران في دوائر استعباد مفرغة من المعنى؛ والعبور نحو معانٍ جديدة للوجود. وهذا قد يتطلب القطيعة الكاملة مع «الوطن» و»الشعب»، لا الشفقة عليهما، ومحاولة إعادة بنائهما كما يجب أن يكونا؛ وربما ابتكار بدائل، قد تكون «خيانة»، بالنسبة لمن لم ينجز الخروج.
يبقى لنا من زياد عدد من أجمل الألحان في تاريخ الموسيقى العربية، وطاقة متفجّرة على التهكّم، قد تكون معيناً على «الخروج». ربما نكون مخلصين له أكثر، إذا كسرنا دوائر يأسه، واستطعنا إنجاز ما عجز عنه: تخليص زياد الرحباني من «زياديته».