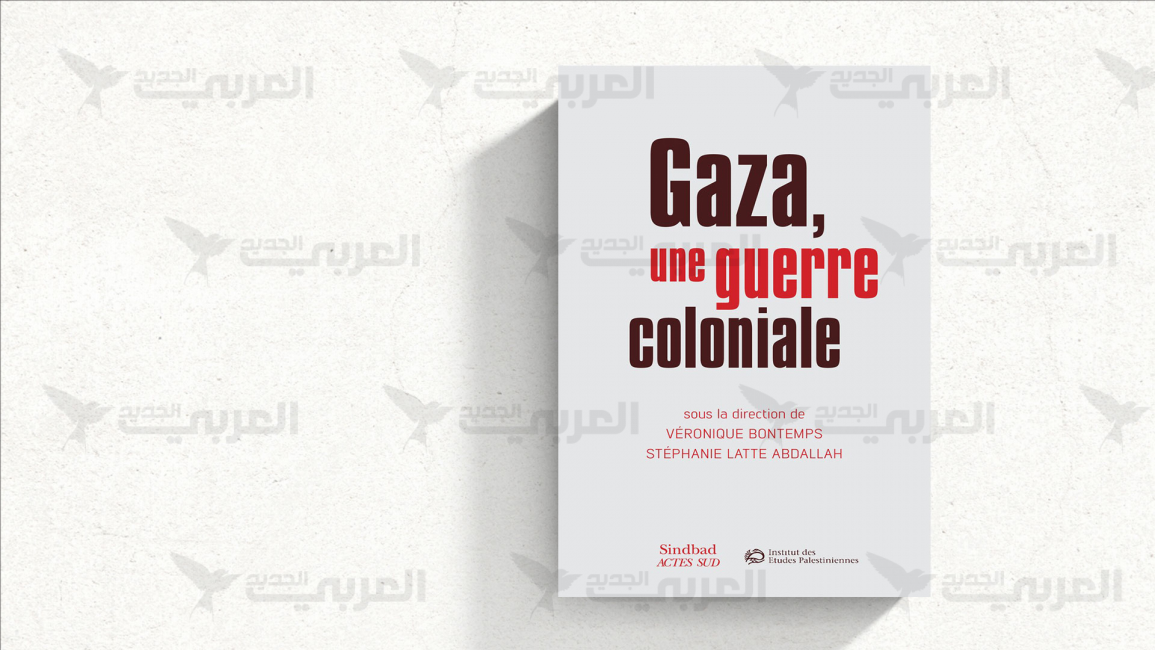سلام الكواكبي/ جريدة العربي الجديد
يُعدّ كتاب "غزة: حرب استعمارية" (دار أكت سود - سندباد ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، باريس، 2025) محاولة فكرية عميقة لإعادة تأطير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ضمن منطق استعماري بنيوي، بعيدًا عن التفسيرات السائدة التي تختزله في كونه "حربًا على الإرهاب"، أو مجرد "صراع غير متكافئ". يستند هذا الطرح إلى مقاربات "دراسات الاستعمار الاستيطاني"، ويطمح إلى تقديم قراءة شاملة تتجاوز الأحداث الآنية لتفكك البنية طويلة الأمد للعنف والاستعمار المفروض على الفلسطينيين في غزة، غير أن هذا الإطار النظري، رغم قوّته، ليس من دون ثغرات أو زوايا مظلمة.
الكتاب الذي أشرف على تنسيق الدراسات الواردة فيه كل من الباحثة فيرونيك بونتان، والمؤرخة والباحثة ستيفاني لاط عبد الله، يتميّز بقدرته على كسر السردية الإعلامية المسيطرة؛ إذ لا يركّز على المواجهات العسكرية فحسب، بل يحفر في الطبقات العميقة للعنف البنيوي، من الحصار والتجويع، وحتّى محاولات محو المستقبل الفلسطيني. من خلال مساهمات متعددة لباحثين وميدانيين، يعتمد الكتاب على شهادات حيّة ووثائق أرشيفية تُظهر كيف أن غزة ليست مجرد "مسرح حرب"، بل إنّها مختبر لعنف استعماري معاصر.
من أبرز ما يميّز هذا العمل رفضه للمنطق الاستثنائي الذي يُعامل غزة مكانًا فريدًا أو حالةً شاذة، إذ يصرّ على رؤيتها نموذجًا مكثّفًا لممارسات استعمارية معاصرة، ما يمنحه بُعدًا مقارباتيًا واسعًا، كما ينأى الكتاب عن المقاربات الدبلوماسية والإنسانية الشائعة في مؤلفات مفكّرين مثل نعوم تشومسكي أو إيلان بابيه، مفضّلًا مقاربة أكثر راديكالية تُشبه أعمال باتريك وولف أو لورينزو فيراشيني.
رغم ذلك، فإنّ اختيار مفهوم "الحرب" عنوانًا وركيزة لتحليل الحالة الغزّية يبدو إشكاليًا؛ فغزة لا تعيش "حربًا" بالمعنى التقليدي القائم على المواجهة بين جيوش نظامية، بل ترزح تحت حصار مستمر وعنف متقطّع لا بداية له ولا نهاية واضحة. استخدام مصطلح "الحرب" قد يُنتج توازنًا زائفًا بين قوة عسكرية هائلة كإسرائيل، وكيان محاصر بلا جيش كغزة، كما أنّه يُخفي البنية الزمنية للمعاناة، إذ ما تعانيه غزة هو استعمار مزمن مستمر منذ أكثر من 75 عامًا، وليس حملة عسكرية محدودة.
مقاربة راديكالية تُشبه أعمال باتريك وولف ولورينزو فيراشيني
من جهة أخرى، يفترض منطق الاستعمار الكلاسيكي وجود "متروبول" (مركز استعماري) يسيطر على "مستعمرة"، فيما تفرز الحالة الإسرائيلية – الفلسطينية شكلًا من "الاستعمار بدون متروبول"، بل إنّ المستوطنين أنفسهم أصبحوا سكانًا دائمين في الأرض المحتلة، ويُعتبرون "أصحابها الأصليين" قانونيًا واجتماعيًا، وهو تحوّل لم ينل حقّه من التحليل النقدي في الكتاب.
من الزوايا المغفلة أيضًا أن المنظومة الاستعمارية الكلاسيكية عادةً ما تسعى لتعظيم الأرباح الاقتصادية، في حين أن إسرائيل، كما تشير بعض التقارير، تخسر سنويًا نحو 18 مليار دولار لأغراض أمنية، إضافة إلى 15 مليار دولار من الفرص الاقتصادية الضائعة نتيجة استمرار احتلالها. وهذا يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء المشروع الصهيوني، التي ربما تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية إلى أخرى ديموغرافية وأيديولوجية، وهي مسألة لم يعالجها الكتاب بوضوح.
يتوسع الكتاب في عقد مقارنات بين غزة ومناطق أخرى مثل سريبرينيتسا وكولومبيا، إلّا أنّ بعض هذه المقارنات تبدو متسرعة أو مبالغًا فيها، خصوصًا حين يجري تجاهل السياقات المحلية والفوارق السياسية والديموغرافية والثقافية. فعلى سبيل المثال، لا تُستَحضرُ جوانب المقاومة المجتمعية داخل غزة على نحوٍ كافٍ، كأشكال الاقتصاد غير الرسمي أو الإنتاج الثقافي والفني المقاوم.
في مقالة ليلى سورا، الباحثة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس، يُعاد تأطير هجوم 7 أكتوبر بوصفه نتاجًا لسياق طويل من الحصار والتهميش، وتراه نتيجة حتمية لمسار تطرّف ناتج عن انسداد الأفق. تُبرز الكاتبة التحوّلات التي طرأت على حركة حماس، لا من زاوية أيديولوجية فحسب، بل عبر علاقتها المعقدة مع الحوكمة المحلية والمساعدات الخارجية أيضًا.
أما القسم الذي يعالج تدمير غزة، فيُظهر كيف أنّ العدوان الإسرائيلي لا يقتصر على الهجمات العسكرية، بل يسعى إلى محو كامل للمدينة والإنسان والذاكرة. ومن خلال مفاهيم مثل "قتل المدن" و"قتل المستقبل"، يجري تحليل هذا التدمير بوصفه مشروعًا لمحو الهوية الفلسطينية، ليس على المستوى الجغرافي فحسب، بل على المستويين الرمزي والزمني أيضًا.
غزة ليست مسرحَ حرب، هي مختبر لعنف استعماري معاصر
مع أن بعض التحليلات تدعم هذا المنظور عبر استشهادات قانونية وبيانات ميدانية، إلّا أنّ التوسّع في المقارنة مع حالات دولية أخرى قد يُضعف الطرح أحيانًا، خصوصًا حين يُغفَل الصمود المجتمعي داخل القطاع.
يتناول الكتاب أيضًا تفاصيل الحياة اليومية في ظلّ الحصار؛ من الزراعة الحضرية إلى الأشكال البديلة للثقافة، مبرزًا كيف يعيد سكان غزّة تشكيل حياتهم رغم القيود. وتُضيف مساهمات مثل تلك التي تعالج البُعد البيئي أو الثقافي بُعدًا إنسانيًا عميقًا. ومع ذلك، يُلاحظ غياب لافت لأي تناول نقدي لانتهاكات حركة حماس الداخلية، سواء عبر تلويث البيئة، أو تسليع الثقافة، أو حتّى القمع المجتمعي، ما يجعل الصورة أحيانًا غير متوازنة.
في الختام، يُوسّع الكتاب نطاق تحليله ليشمل البُعد الجيوسياسي، فيتناول موقف الدول العربية، والمحكمة الجنائية الدولية، والإعلام العالمي، والازدواجية الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية. وينجح المؤلفون في الكشف عن تواطؤ بعض الأنظمة وتوظيف غزة أداةً في لعبة النفوذ الإقليمي. ومع ذلك، فإنّ بعض هذه التحليلات تظلّ سطحية أو يغلب عليها التفاؤل، خصوصًا في ما يتعلّق بفاعلية العدالة الدولية في ظل ميزان قوى مختل ومهيمن.
يمكن القول إنّ كتاب "غزة: حرب استعمارية" يشكل مساهمة فكرية جريئة تذهب إلى عمق المأساة الفلسطينية، وتُعيد تأطيرها ضمن منظور طويل الأمد.