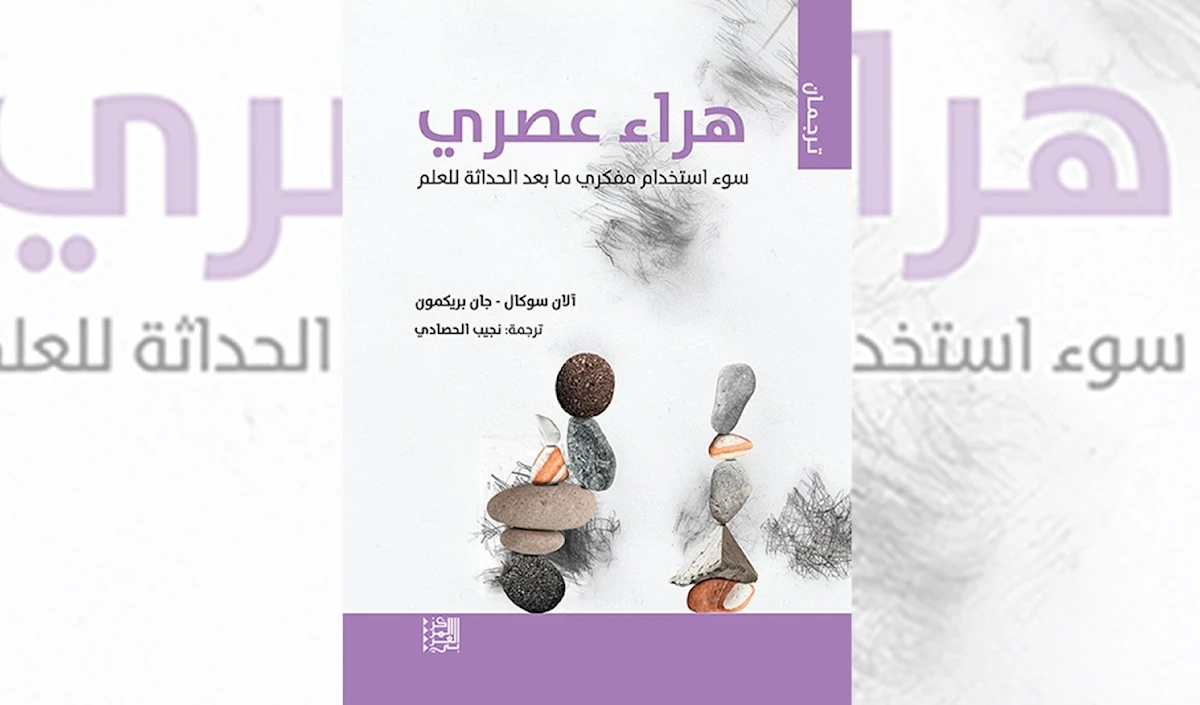سلوى دبوق/ جريدة الأخبار
يُبهرنا كثيرًا خطاب ما بعد الحداثة، بلغته المتأنّقة وأفكاره الخارجة عن المألوف، لكن ماذا لو كانت هذه «الثورة الفكرية» مجرد قناع؟ ماذا لو كان وراء كل ذلك الغموض البراق محتوى مكسو بمعادلات رياضية مبهمة لا يفقهها حتى من يُلوّح بها؟
خدعة سوكال وولادة «هراء عصري»
في عام 1996، فجّر الفيزيائي الأميركي آلان سوكال ما يشبه الفضيحة الفكرية، عندما كشف أن مقالًا علميًا نشره في مجلة Social Text الثقافية لم يكن سوى خدعة متقنة. جاء المقال تحت عنوان «تخطي الحدود: نحو علم تأويل تحولي للجاذبية الكمية». وقد صيغ بلغة تقنية معقّدة، مليئة بإحالات إلى فيزياء الكم والنسبية ونظريات ما بعد الحداثة.
زعم النص أنّ «الواقع المادي ليس إلا بناءً لغويًا واجتماعيًا». غير أن سوكال ألّفه عمدًا ليكون بلا معنى، في محاولة لكشف استعداد بعض الأوساط الأكاديمية لقبول خطاب فارغ وغامض، طالما أنه مُغلّف بمفردات علمية تبدو رصينة.
لم تكن خدعة سوكال سوى تمهيد لعمل أكثر شمولًا نُشر عام 1997 تحت عنوان «هراء عصري»، وقد صدر أخيرًا بالعربية عن «المركز العربي للأبحاث» بترجمة نجيب الحصادي.
ألّف سوكال الكتاب بالاشتراك مع عالم الفيزياء البلجيكي جان بريكمون، وجاء بمثابة هجوم نقدي واسع على تيار ما بعد الحداثة، ولا سيما على بعض الفلاسفة الفرنسيين الذين اتُّهِموا بإساءة استخدام المفاهيم العلمية بهدف إضفاء مسحة زائفة من العمق على نصوصهم.
لا يستهدف النقد الفلسفة بوصفها مشروعًا فكريًا قائمًا بذاته، بل يوجَّه إلى نمط من الكتابة يتزيّن برداء علمي لا يُتقنه، ويدّعي التحليل من دون أن يُقدّمه فعليًا. يشير المؤلفان إلى أنّ الغموض المُفتعل في هذا النوع من الخطاب لا يدلّ على عمق أو ابتكار، بل يكشف عن فراغ معرفي مُموّه بأسلوب لغوي متكلّف.
المفارقة أن بعض القرّاء، مدفوعين بالإعجاب أو خشية الاتهام بالجهل، يفسّرون عجزهم عن الفهم على أنه قصورٌ فيهم لا في النص، بينما الحقيقة أنّ كثيرًا من هذه الكتابات تخلو من أي معنى حقيقي. ولإثبات حجته، لا يتردّد الكتاب في تفنيد أفكار بعض أشهر مفكري ما بعد الحداثة، وسنقف عند أبرزهم.
تفكيك خطابات ما بعد الحداثة
يُعدّ جاك لاكان المحلل النفسي الفرنسي الشهير الذي يُصنَّف أحيانًا ضمن مفكري ما بعد الحداثة بسبب تأثيره الفلسفي، أحد الأهداف المحورية للنقد الذي يقدّمه كتاب «هراء عصري». يُكرّس المؤلّفان فصلًا كاملًا لتحليل كيف عمد لاكان إلى توظيف مفاهيم رياضية متقدّمة مثل التور، وزجاجة كلاين، وشريط موبيوس، في سياقات تحليلية نفسية، من دون مراعاة للدقة أو للفهم الحقيقي لهذه المصطلحات.
ذهب لاكان إلى أبعد من ذلك حين حاول توصيف الديناميكيات النفسية الجوهرية بأدوات رياضية بحتة، مثل «الفضاء الكمباكت» أو «الجذر التخيّلي للعدد -1». هذه التوليفات، بحسب سوكال وبريكمون، لا تفتقر فقط إلى الأساس العلمي، بل تفتح الباب أمام تأويلات رمزية فضفاضة، تُبهر القارئ بظاهرها المُعقّد بينما تخلو من مضمون دقيق. ويؤكد الكاتبان أنّ لاكان لم يقدّم في استخدامه لهذه المصطلحات أي دليل على فهمه الحقيقي لها، ما يجعل خطابه مثالًا صارخًا على الدجل الفكري.
يشمل النقد الذي يقدّمه الكتاب أيضًا الباحثة جوليا كريستيفا، التي وظّفت في أعمالها المبكرة مفاهيم مستمدة من الرياضيات والمنطق ونظرية المجموعات ضمن مقاربات أدبية تفتقر، بحسب المؤلّفَين، إلى أي سند علمي واضح. من بين الأمثلة التي يتناولانها، حديث كريستيفا عن «منطق 0-2» في مقابل «منطق 0-1» — أي المنطق الثنائي التقليدي القائم على ثنائية «صواب/خطأ» أو «وجود/غياب» — حيث تربط هذا التمايز بتجربة اللغة الشعرية التي تزعم أنها تتجاوز الحدود المنطقية المتعارف عليها، وتتّصف بالتعدّد واللانهائية.
تشير كريستيفا إلى أن اللغة الشعرية «تتجاوز الرقم 1»، بمعنى أنها تتجه نحو الغموض والانفتاح الدلالي. غير أن سوكال وبريكمون يريان في هذا الخطاب استعراضًا مفاهيميًا غامضًا أكثر منه تحليلًا عقلانيًا، ويؤكدان أن المشكلة لا تكمن فقط في سوء استخدام المفاهيم الرياضية، بل في غياب أي منهجية تجريبية تُبرّر مثل هذه الادعاءات.
يخصّص «هراء عصري» فصلًا لانتقاد جان بودريار، والذي يُعرف بأسلوبه الكثيف في تحليل الإعلام والسلطة. يستعير بودريار مفاهيم من الفيزياء، مثل الجاذبية والفضاء غير الإقليدي، ويُسقطها على الواقع الاجتماعي من دون التزام بالدقة أو الوضوح المنهجي. من بين أطروحاته الغامضة قوله إن «السبب يتراجع أمام النتيجة» أو أنّ «الزمن يلتفّ على نفسه كما في شريط موبيوس»، من دون أن يتبيّن للقارئ إن كان يتحدث مجازًا أدبيًا أم يُحاكي توصيفًا فيزيائيًا.
يرى سوكال وبريكمون أنّ هذا الخطاب يُنتج إيحاءً زائفًا بالعمق، ولا يستند إلى تحليل عقلاني بل إلى تراكمات لغوية ضبابية. كما ينتقدان معالجة بودريار لمفاهيمه المركزية مثل المحاكاة والواقع الفائق، حيث تُقدَّم بلغة توحي بالصرامة المفاهيمية، ولكنها في الواقع تفتقر إلى أي قابلية للتدقيق المنطقي.
يتناول الكتاب أيضًا أعمال جيل دولوز وفليكس غاتاري، حيث يركّز سوكال وبريكمون على الطريقة التي يوظّف بها الكاتبان مصطلحات علمية مستمدة من مجالات الفيزياء والرياضيات، مثل «التكامل»، و«التفاضل»، و«الطاقة»، من دون احترام للسياقات الأصلية لهذه المفاهيم أو توضيح دلالاتها الدقيقة.
هذا الاستخدام ــــ بحسب المؤلفين ــــ يؤدي إلى غموض بنيوي في النصوص، التي تفتقر إلى منطق فلسفي متماسك يربط بين المفاهيم العلمية والطرح النظري. بل إن هذه المصطلحات تُوظّف في كثير من الأحيان بطريقة اعتباطية، ما يجعل النص أقرب إلى مزيج من الكلمات التقنية منه إلى حجّة فلسفية واضحة أو مساهمة معرفية أصيلة.
يرى الكاتبان أنّ هذا الأسلوب يخلق نصوصًا عصيّة على الفهم بالنسبة إلى القارئ العادي، وغير مُقنعة للمتخصص، نظرًا إلى افتقارها إلى الدقة التي يتطلّبها أي خطاب فلسفي يستند إلى العلوم الطبيعية. بحسب سوكال وبريكمون، فإنّ هذا الغموض لا يُعد مجرّد أسلوب تعبيري، بل يشكّل إستراتيجية واعية تهدف إلى تحصين النصوص من النقد، حيث يمكن دومًا الردّ على أي اعتراض بالقول إن الناقد لم يدرك عمق الفكرة أو تعقيدها البنيوي.
الدفاع عن العقلانية
يطرح المؤلفان سؤالًا جوهريًا: لماذا يتبنّى بعض فلاسفة ما بعد الحداثة خطابات لاعقلانية؟ ويجيبان بأن الأمر لا يعود دائمًا إلى سوء نية، بل إلى نزعة ثقافية داخل الفلسفة المعاصرة تُمجّد الغموض وتوظّفه كأداة لإقصاء النقد. كما يشيران إلى أنّ جزءًا من اليسار، بعد خيبات سياسية وتراجع الحركات التحرُّرية، انساق إلى هذه الخطابات كبديل وهمي، فاستبدل العقلانية بتبريرات نسبية تُغرق التحليل في الضباب وتبتعد عن الواقع.
على نطاق أوسع، ينتقد الكاتبان «النسبانية المعرفية» التي تفترض أن الحقائق كلها نسبية، وأن المعارف بناءات اجتماعية لا تُفهم إلا في سياقها الثقافي. في قراءاتها المتطرفة، تصبح هذه الفكرة أداة لهدم أي محاولة لفهم موضوعي للعالم. ويؤكد المؤلفان أنّ الدفاع عن العلم لا يعني ادعاء الحقيقة المطلقة، بل التمسك بالمنهج العلمي كأفضل أداة لفهم الواقع.
«هراء عصري» ليس مجرد تفنيد لغوي، بل دفاع عن العقلانية العلمية ضد خطاب يساوي بين المعنى واللا معنى، ويشرعن أي تأويل مهما كان هشًا. أمام الغموض المتعمّد، يربط الكتاب الفلسفة بالوضوح والمنهج، لا بالإبهار اللفظي. ورغم أنّ بعض الفصول تتطلب إلمامًا بالعلوم، فإن القارئ النقدي قادر على التمييز بين الاستخدام الأصيل للعلم وتوظيفه الزائف. في النهاية، يشكّل الكتاب وثيقة فكرية جريئة تطرح سؤالًا جوهريًا: هل يُقاس العمق الفلسف بالغموض، أم بقدرة الفكرة على الصمود أمام النقاش العقلاني؟