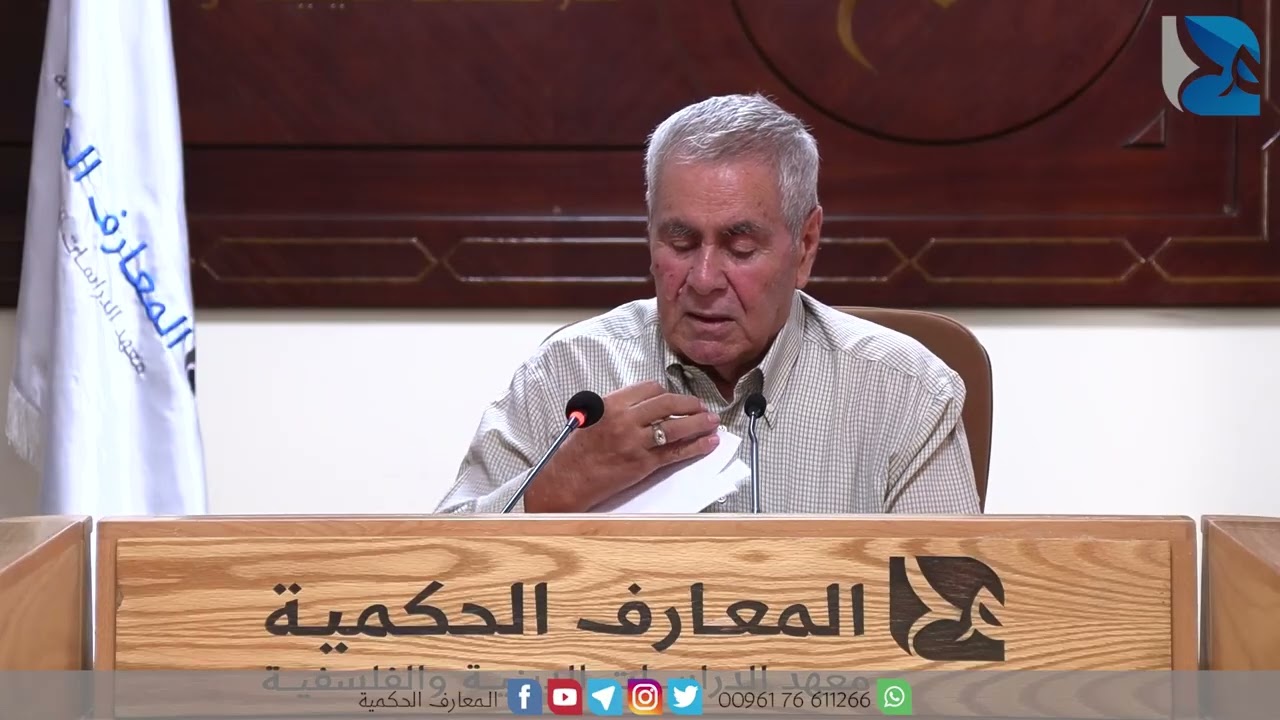أقام منتدى النقد الأدبي في معهد المعارف الحكمية، والملتقى الثقافي الجامعي، ندوة ثقافية حول رواية الأستاذ عدي الموسوي “ياقوت من خوابي الشقيف” في مركز المعهد بالسان تيريز، تناوب على الحديث في هذه الندوة كلٌّ من الأساتذة: البروفسور علي زيتون، الدكتورة درية فرحات، الدكتورة أمل بدرا، الدكتورة راغدة المصري، والدكتور علي جمعة، وأدارتها الدكتورة خديجة شهاب. وحضر الندوة مجموعة من المثقفين والمهتمين وأهل الاختصاص.
أفتتحت الدكتورة خديجة شهاب الندوة بالحديث عن الرواية، فحلّلت مفردات العنوان، وأشارت إلى أن خوابي الموسوي ملأى بياقوت متنوع من أزرق غامق إلى أصفر، فبرتقالي، وهو حجر كريم يضاهي الماس في جودته وارتفاع أسعاره، وأمّا الشقيف فهي تلك القلعة التي حجزت لها مكانة عالمية على المستوى العسكري، كرمز للصمود والتصدي.
بعد ذلك تحدث الأستاذ الدكتور علي زيتون فتناول في قراءته لرواية “ياقوت من خوابي الشقيف” الحضور القوي للكاتب برؤيته إلى العالم من خلال ثقافته وقناعاته وهمومه واهتماماته، ثم تطرق إلى الرؤية التي لنتعرف عليها يمكن الاستهداء بثلاثة عناوين: سيمائيّة عنوان الرواية، ووظيفية العتبات التي مهّدت للرواية، واللغة التي أفصحت عن هموم الروائي واهتماماته.
في ما يتعلق بـ “سيمائية العنوان”، يقول الدكتور زيتون: تستوقفنا في عنوان الرواية كلمة (ياقوت) التي تلفت انتباه القارئ إلى الأحجار الكريمة التي تدغدغ تفكيره، ليس من جهة قيمتها المادية فحسب، ولكن من جهة علاقتها بالقداسة أيضًا. وأن يُستخرَج الياقوت من الخوابي إشارة دالّة، تبطن علاقة ذلك الياقوت بالضروري من المؤن.
أضاف، الخابية عند الريفيّ حمّالة مؤونة عام كامل، وهي صالحة باستمرار، لحمل مؤونة أيّ عام جديد. إنّها المخبأ الأمين لأيّة مؤونة. وربط الياقوت الجميل بالمقدس بالمؤن يعني دورًا وظيفيًّا لا يضعنا أمام خابية واحدة. ذلك أنّ الجمع (خوابي) يواجهنا بالوافر من الجمال والقداسة، خصوصًا أنها خوابي حصن تتجاوز بمحمولها الجميل والمقدّس والمفيد إلى التاريخ الموسوم بجميع المعارك التي خيضت دفاعًا عن ذلك الحصن، أو محاولة لتحريره ممّن دنّسه باحتلاله إفرنجيًّا كان أم صهيونيًّا.
أما في وظيفة العتبات، اعتبر الدكتور زيتون أن القارئ لا يستطيع سلوك دروب هذه الرواية من دون الارتكاز على تلك العتبات السابقة للنصّ الروائي واللاحقة به.
أشار إلى أن الرواية تطالعك بقائمة تحدّد لك أبرز الشخصيات الحقيقية من ابن الخشاب إلى مناحيم بيغن. تليها خارطة تقدم لك جغرافية المكان الذي جرت فوقه الأحداث، وتحرّكت على دروبه الشخصيات، ولعل أهم تلك العتبات هي تلك التي وسمت بعنوان: “سلالة الياقوت” والتي تقدم لك علاقات القربى والنسب التي تصل بعض الشخصيات ببعضها الآخر. لافتًا إلى أن ذلك يعني أننا أمام رواية على علاقة متصلة اتصالًا وشيجًا بالتاريخ، التاريخ المتمحور حول قلعة الشقيف، بما يومئ إلى حضورٍ لما هو موضوعي يعطي أحداث الرواية زخمًا غير عادي.
تطرق الدكتور زيتون إلى تعدّد الساردين، معتبرًا أن هذه التعددية لم تترك أحداث الرواية تجري على هونٍ أمام ناظري المتلقّي، ولكنها حفّزته على مشاركة الروائي في الهموم التي حملها وهو يستجمع مادة روايته هذه، همومه المتعلقة بتاريخية الأحداث أو بالتحالفات التي كانت تقوم خلالها بين المشرقيّين أنفسهم مرة، وبين بعض المشرقيّين والفرنجة مرة أخرى.
في ما يتعلق باللغة المفصحة عن الهموم، رأى الدكتور زيتون أن هذه الرواية التي نجحت في أسر المتلقي إلى عالمها، بما خُطِّط لها من قبل مؤلفها، فإنها أسرته بلغتها أيضًا، وبالوظائف التي أسندتها إلى الحوارات التي انبثّت في طول الرواية وعرضها. ولفت الدكتور زيتون إلى أن عديّ الموسوي لم يحضر في روايته من خلال النَّفَس الذي حمّله لبطله بشارة الصّبان، والهمّ الذي وضعه على كتفيه تمسّكًا بحرّيّة الأرض العربيّة، ولكنه حضر بشكل مباشر من خلال أحداث راهنة تعطي الرواية دفقًا تاريخيًّا واقعيًّا وليس متخيّلًا.
ختم الأستاذ الدكتور علي زيتون مداخلته بالقول: ويبقى أنّ تجربة عديّ الموسوي الأولى في الكتابة الروائيّة، على ما أعرف، قد جاءت تجربة مبشّرة بخير عميم.. لقد بدا هذا الأديب ومن خلال تجربته هذه أديبًا غير عادي يجعلنا ننتظر منه الكثير. وهذا ما يدعوه إلى إطّلاع واسع على النتاج الروائي عربيًّا كان أم عالميًّا. معتبرًا أن ما يحمله من مؤهّلات كتابيّة يدعوه إلى تملّك ثقافة عصرنا، وإقامة حوار دائم معها ليصل إلى القدرة على طرح الأسئلة الصعبة عليها، وذلك تمهيدًا لإبداعات غير عاديّة في العمل الكتابيّ.
بعد ذلك كان الكلام للدكتورة درية فرحات متناولة عنوان: “البعد التّاريخيّ والتّعالق النّصيّ في المتخيّل السرديّ لرواية ياقوت من خوابي الشّقيف“، فاعتبرت أن الرواية التاريخية تشكل عنصرًا جوهريًّا في مسيرة الحضارات، وجسرًا يربط الحاضر بالماضي، تنقل عبره الأجيال تجارب الأمم، وعِبَر الشعوب، وسِيَر العظماء.
أوضحت، بأن الرواية ليست مجرد حكايات تُروى للتّسلية أو التّرفيه، بل تحمل بين سطورها دروسًا عميقة، وتوثّق أحداثًا شكّلت مسار البشرية. ومن خلال هذه الرّواية، نغوص في تفاصيل الزّمان والمكان، ونتأمّل في صراعات الإنسان وتطلّعاته، ونتعلّم من نجاحاته وإخفاقاته.
لأهمية الرواية التاريخية أكّدت الدكتورة فرحات أنها تؤدي دورًا مهمًا في حفظ الهوية الثّقافيّة، فهي تسرد حكاية الوطن، وتُذكّر الأجيال بجذورها، وتُعرّفهم بتاريخ أجدادهم، ما يعزز شعور الانتماء. كما تساعد هذه الرّواية في تكوين رؤية نقديّة للتّاريخ؛ فبدلًا من تلقي المعلومات بوصفها حقائق جامدة، تتيح الرّواية المجال لفهم السّياقات وتحليل الأحداث ومقارنة الماضي بالحاضر.
رأت الدكتورة فرحات أنه وفي الزمن الذي تشهد فيه الرّواية العربيّة انفتاحًا غير مسبوق على التّاريخ والذّاكرة، تأتي رواية “ياقوت من خوابي الشّقيف” لعدي الموسوي لتطرح خطابًا سرديًّا فريدًا يتقاطع فيه التّخييل مع التّوثيق، ويتداخل النّصّ التّاريخيّ مع النّصّ الأدبيّ عبر رؤية فنيّة تستنطق الماضي في سبيل فهم الحاضر.
رأت الدكتورة فرحات أن رواية ياقوت من خوابي الشّقيف للكاتب اللّبنانيّ عدي الموسوي تنهض على رؤية سرديّة تستند إلى توظيف واعٍ وعميق للتّاريخ في بنية النصّ الرّوائيّ، من خلال التّناص مع وقائع وشخصيّات وأزمنة تاريخيّة متعدّدة.
أما التّناص مع الحروب الصّليبيّة، فلفتت الدكتورة فرحات إلى أن هذه الحروب تمثل المحور الزّمنيّ الأقدم في الرّواية، فيبرز استدعاؤها من خلال شخصية “مافي جقمق”، الفارس التّركمانيّ الذي حارب في صفوف المسلمين. الاسم ذاته ينهض بتناص لغويّ وتاريخيّ يُحيل إلى الحقبة المملوكيّة أو الأيوبيّة، ما يفتح أبواب التّأويل حول مدلول الفروسيّة والمقاومة.
أشارت إلى أن قلعة الشّقيف تمثل نقطة التقاء بين التّناص التّاريخيّ والرّمزيّ، إذ تستعاد الواقعة الحقيقيّة لصمود مقاومين لبنانيين داخل القلعة في أثناء الاجتياح الإسرائيليّ العام 1982، لكن تُقدم داخل الرّواية بطريقة تُخضِع التّاريخ لمنطق الأسطورة.
قالت الدكتورة فرحات: إن الشّقيف قلعة شهدت محطّات تاريخيّة مهمة، ومن هنا فإنّ لها رمزيّتها، وهي لا تُروى بوصفها مكانًا، بل بوصفها نصًّا حيًّا تنطق بلسان أرواح الشّهداء، وتتلبّسها الذّاكرة المركبة.
أما التّناص الدّينيّ والأسطوريّ، فأوضحت الدكتورة فرحات أن الياقوتة تتبدّى عنصرًا رمزيًّا حاملة للزّمن ذاته، تمرّ من يدّ إلى يد، وكأنّها نصّ خفيّ يحمل في داخله رموز المقاومة، وهي تنتقل عبر الأزمنة وتتّخذ طابعًا شبه مقدّس فتذكّر بالرّموز الدّينيّة، كالآثار النبويّة، والأحجار الكريمة في التّصوّف، وهي تحمّل بالدّلالات الرّمزيّة. وأكّدت أن دراسة شخصيات ياقوت من خوابي الشقيف تكشف عن استراتيجية روائيّة تُعيد تعريف الشّخصيّة بوصفها كيانًا رمزيًّا يتجاوز دوره في الحبكة، ليشكّل لبنة من لبنات الذّاكرة الجماعيّة.. بذلك، تصبح الشّخصيّات في الرّواية مرايا متقابلة لزمن مقاوم، يتكرّر من دون أن يفقد جوهره.
ختمت الدكتورة درية فرحات كلامها بالقول: تُعدّ رواية ياقوت من خوابي الشّقيف للرّوائيّ عدي الموسوي أنموذجًا متفرّدًا في تفاعل السّرد مع التّاريخ، إذ تنصهر العناصر التّخيليّة بالتّجربة التّاريخيّة في نسيج روائيّ يُعيد تشكيل الذّاكرة الجماعيّة. هذا العمل لا يقدّم مجرد حكاية، بل يصوغ خطابًا سرديًّا مفعمًا بالتّعالق النّصيّ والاستدعاء الرّمزيّ، مستندًا إلى بعد تاريخيّ متين.
أما الأستاذة الدكتورة راغدة المصري فقد تناولت الرواية من الناحية الرمزية والدلالات التاريخية، فاعتبرت أن عنوانها “ياقوتٌ من خوابي الشقيف” يفصح عن أسراره للقارئ، إذ يظهر تعبير “ياقوتٌ من خوابي الشقيف” كاستعارة مثالية لوصف رواية تاريخية من خلال إضفاء معاني عميقة على كل عنصر من عناصرها، حيث لا يقتصر الوصف على كونها مجرد قصة، بل يربطها بالندرة، والأصالة، والعمق التاريخي. والياقوت كما ترى الدكتورة المصري هو جوهر القصة ذاته في سياق الرواية، إنه ليس مجرد سرد للأحداث، بل هو الحكاية النادرة والمضيئة التي تستخرج من بين صفحات التاريخ الكثيرة. وتعبير “ياقوتٌ من خوابي الشقيف” يمنح الشخصيات والأماكن التاريخية دلالات عميقة تتجاوز مجرد الوصف السطحي، حيث تتحول هذه العناصر إلى رموز حية وغنية بالمعاني.
ثم تنتقل الدكتورة المصري إلى الحديث عن رمزية الشخصيات التاريخية في الرواية، فتوضح، بأن الياقوت الإنساني لم تكن الشخصيات مجرد أسماء في كتاب تاريخ، بل هي “الياقوت” نفسه. واعتبرت أن هذه الشخصيات نادرة وذات قيمة عالية، لم تُكتب قصصها وحتى لم تُعرف بالقدر الذي تستحقه.
ذكرت أن رمزية الياقوت في الرواية برزت: كشخصية استثنائية، وكفكرة رائدة، كذلك كلحظة تاريخية فارقة أو حدث صغير في التاريخ. وتابعت الدكتورة المصري، بأن الياقوت يحمل لنا رائحة التاريخ وصمود الأجداد والتراث العريق، أيضًا يحمل الجمال الذي يزين قلعة الشقيف رمزًا للصمود والقوة في وجه التحديثات.
أوضحت الدكتورة المصري أن “خوابي الشقيف” تأخذ في هذه الاستعارة معنى المصادر التاريخية التي يعتمد عليها الروائي ليس فقط كتب التاريخ المألوفة والمصنّفة فقط، والتي اعتمدها وذكرها في الرواية، بل هي تلك المصادر الأقل شيوعًا وتمتلك قيمة كبرى، من: مخطوطات قديمة، مذكرات شخصية، رسائل متبادلة، وغير ذلك.
لفتت إلى أن دور التاريخ الاجتماعي الاقتصادي في الرواية لم يقتصر على كونه خلفية جامدة، بل هو القوة الدافعة التي تشعل الصراعات، وتشكّل مصائر الشخصيات، وتجعل من “الياقوت” قصة ذات معنى عميق يتجاوز مجرد سرد الأحداث.
رأت أن رمزية القيمة الخفيّة والكنز المجهول في كلمة “خوابي” (الأوعية الفخارية) توحي بأن شيئًا ما مدفون ومحفوظ بعناية في مكان سري. ثم تسلط الدكتورة المصري الضوء على أهمية حصن الشقيف عبر الأزمنة، وفي الواقع، وفي الرواية، ومثله نهر الليطاني الذي لا يحلم الغزاة اليوم بأكثر من طرد المدافِعين من جنوبه إلى شماله! وحصن الشقيف” قلعة شهيرة في جبل عامل تمثّل رمزًا للصمود في وجه الزمن والاحتلالات المتعددة، وجبل عامل – الذي ينتمي الكاتب إليه – ويسمّى أيضًا “بلاد بشارة”؛ هذه التسمية عائدة إلى الأمير حسام الدين بشارة العاملي الذي حملت اسمه الشخصية الروائية “بشارة الصبّان” تيمنًا به.
أوضحت، بأن اعتبار الرواية بمثابة تأريخ أدبي للمقاومة يمنحها بعدًا يتجاوز مجرد سرد الأحداث، وتصبح الرواية هنا وعاءً للذاكرة الجماعية، تسجل التحولات التي طرأت على المقاومة وأشكالها المختلفة عبر الزمن.
وأشارت الدكتورة المصري إلى أن الروائي قد أبدع في تقديم صورة إنسانية للمقاومين، بدلًا من تقديم المقاوم ككيان مجرد، أو بطل أسطوري.. هذا البعد الإنساني يكسر الصور النمطية ويجعل قضية المقاومة أكثر قربًا وتأثيرًا على القارئ.
اعتبرت، أن فكرة إبراز دور المقاومة الشعبية في رواية “ياقوت” تمثل جوهرًا إنسانيًّا وتاريخيًّا بالغ الأهمية. إنها تمنح صوتًا غالبًا ما يتم تهميشه في الروايات التاريخية الكبرى التي تركّز على القادة والجيوش النظامية.
في معرض حديثها عن تاريخية الرواية تناولت الدكتورة المصري عدة زوايا يمكن من خلالها قراءة الرواية من المنظور التاريخي، فبدأت من تصوير الحقبة التاريخية التي تتضمن: التركيز على جبل عامل وحصن الشقيف، ثم استعراض فترات تاريخية متعددة، وإبراز دور المقاومة الشعبية. وقالت الدكتورة المصري: إن الرواية تقدّم نوعًا من “إعادة كتابة التاريخ” على أسس نمط التاريخ الاجتماعي الاقتصادي من خلال التركيز على قصص هؤلاء “الأبطال المجهولين”، حيث يصبح عامة الناس هم محور السرد، وتُروى الأحداث من منظورهم وتجاربهم.
صنفت الدكتورة المصري رواية “خوابي الشقيف” لعدي الموسوي بأنها رواية تاريخية بامتياز، لأنها تستمد أحداثها وشخصياتها من وقائع حقيقية، وسياق تاريخي محدد، وهو فترة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان والمقاومة ضده. ختمت الأستاذة الدكتورة راغدة المصري كلامها قائلة: لقد مثّلت الرواية دعوة صريحة لإعادة قراءة الماضي من منظور جديد، يركّز على الصمود الاجتماعي، والمقاومة الثقافية، ويسلط الضوء على أن الذاكرة الجماعية للشعوب هي أثمن كنوزها، وأن إحياءها هو بحد ذاته فعل مقاومة ضد النسيان. معتبرة بأن “ياقوتٌ من خوابي الشقيف” تبقى شاهدًا أدبيًّا على أن النور يمكن أن ينبعث من أعماق الظلمة، وأن الكنوز الحقيقية هي تلك التي تحمل في طياتها صدى الإنسان.
أما الدكتورة أمل بدرا فقد قاربت روايةِ “ياقوتٌ من خوابي الشقيف” للروائيّ عَديّ الموسوي من الناحية السيمائيّةٍ، مشيرة إلى أنّ العنوان شكّل مِفتاحًا أساسيًّا من مفاتيح النصّ الذي يبدو معلنًا مفتوحًا في الظاهر، لكنه في الحقيقة يُضمر الكثيرَ في المضمون. فالياقوتةُ الحمراء رمزٌ للإرثِ المقاوم وبطولاتِه… أما الحصن فهو ذلك الصّرحُ الصخريُّ الشاهق يعانقُ سحبَ الأعالي، لا يحدّه زمان، ولا يُقيّده مكان.
رأت الدكتورة بدرا، أنّ رمزيةَ المكان جعلت الحصن يفجّرُ مكامنَ الشعور العميقة، فجعل الرواية عابرة للزمان نستطيع إسقاط أحداثها مع اختلاف الشخصيات، كما استطاع أن يفسح المجال أمام بعض الحقائق الإنسانية المبطّنة للعبور إلى الانكشاف، أما زمانُ الرواية فكان ذا طبيعةٍ ديالكتيكيّة، يضمن انتقالًا تصاعديًّا من وعيٍ محدود إلى وعيٍ غيرِ متناه للعَلاقات الإشكاليّة الكبرى، وقد تأرجح بين التقهقر والصعود للوصول إلى الارتقاء.
أوضحت بأن الروايةُ جسّدت واقعيّةَ العالم العربي منذ عام 1240 للميلاد حتى يومنا هذا، وشكّلت دعامةً أساسيّةً من أعمدة الرواية العربية في تشخيص ظواهرِ المقاومة عند الشعوب، حاول الكاتبُ من خلالها أن يسلّط الضّوء على مجموعةٍ من القضايا والآفات الاجتماعية التي سيطرت على المجتمعات العربيّة في حِقباتٍ تاريخيّةٍ مختلفةٍ بأسلوبٍ فنّيٍّ مميّز.
لفتت الدكتورة بدرا إلى أن الكاتب قد جمع بين سليقةِ الأدب، وصنعةِ التأليف التاريخي بأسلوب شيّقٍ دون أن يغفل الجانبَ المقاومَ والإنسانيَّ منه، وجسّد لنا أبطال الرواية مقاومين لا يبالون بعذابات الأيام، ينكبّون على سيفِهم، لا يستسلمون للموت، يفيضون شجاعةً لا تضاهى، ويبذلون مهجهم فداءً للوطن. واعتبرت الدكتورة بدرا أن الروايةُ سلطت الضّوءَ على معاناة الشعوب في ظلّ أطماع الاحتلال والاستعمار، ما انعكس قلقًا عليها في تقرير مصيرها، وكيفيةِ الحفاظ على وجودها وهويّتها، والبحثِ عن الاستقرار المفقود،… مشدّدة أنّ المقاومةَ ليست حكرًا على فئةٍ أو زمنٍ معيّن، بل هي نتيجةُ ردِّ فعلٍ إنسانيٍّ يتجدّد عبر العصور.
أشارت إلى أن الروايةُ قد اتخذت منحى ثلاثيَّ الأدوار: الراوي، المروي له، والحكاية المرويّة، وجمعت بين الذاكرةِ الفرديّة المعاصرة، وذاكرةِ الأسلاف.
تابعت، وقد استند الكاتب إلى مرجِعيّاتٍ من التاريخ والبطولات، دعّمها بذاكرته الفرديّة وحكايات الناسِ ووقائعَ من زمانه شكّلت خلفيّة عالمٍ روائي، بأسلوبٍ سرديّ واقعيّ مشوّق. و أضافت، لقد أطلق الكاتب العنان لما تختزنه لغته من خصوصيّةٍ جماليّة واقعيّة، وما يكتنفه من مفارقاتٍ وأسرار وغموضٍ وعِبر، فأسّس لنا سرديّته بأسلوبٍ سيمائيٍّ مبدعٍ في تقطيع المشاهد والأحداث، وتوزيعِها عبر الأمكنة والأزمان.
رأت الدكتورة بدرا، بأن ثقافةُ الكاتب لم تقتصر على معلوماتٍ تاريخيّة أدبيّة، بل كان ذا ثقافةٍ موسوعيّةٍ، أضفى على روايته بعضًا من رسوماته التي وُشّحت بها وعبّرت عن أحداثها بريشةٍ بديعةٍ يتجاذبُها الإقبال البصريّ والفكريّ معًا.
في سردها لمزايا الكاتب وعمقه المعرفي اعتبرت الدكتورة بدرا، بأننا لو سبرنا أغوار الرواية أكثر، وولجنا إلى أعماقها، لوجدناه يطلّ على الحياة بعين المتأمّل البصير، أضفى على الرواية طابعًا صوفيًّا، مع ما يختلج في النفس البشريّة من تناقضات، ونقلَنا إلى بعدٍ آخر من الأبعاد التي تجتمع فيها همومُه مشترَكة مع هموم شخصيّات الرّواية، ألا وهو البعد الوطني، سلّط من خلالها الضوء على القضايا الوطنيّة وجسّدها لأهداف توعويّة في منظورٍ واقعيّ، فأرسى قواعد حقيقيّة للرواية. ومن وجهة نظر الدكتورة بدرا فإن الكاتب قد ارتكز على مرجعيّات التاريخ وذاكرته، وأطلّ علينا بعين المتأمّل البصير، نقل لنا قلق الصراع الوجودي هادفًا استنهاض الوعي الجمعي لأبناء الوطن ليبقوا على لحمتهم الوطنية، ويثبتوا على عقيدتهم الكربلائية.
ختمت الدكتور أمل بدرا كلامها قائلة: وهكذا يبقى الياقوت محفورًا بين ثنايا الذاكرة، شاهدًا أزليًّا على أنّ فكرةَ المقاومة ليست مرحلةً عابرةً، بل هي قضيّة جوهرية مشروعةٌ تفيضُ حياةً كلما رويت بدماء أهل الأرض، هي وصيّة خالدة في ضمير الشرفاء، وأمانة مصانةٌ في أعناق الأوفياء، حتى يولدَ الضوءُ من رحم الحصن وتبزغ تباشير النصر من جديد.
الدكتور علي جمعة آخر المتحدثين فأفاض في عباراته التي غاصت في خوابي الرواية واصفة الراوي بأنه حين يُمسَك القلم بيدٍ تعرف الذاكرة، ويُجيد الفكر الإصغاء لصوت الحجارة، تتحوّل الرواية من سردٍ إلى شهادة، ومن حكايةٍ إلى مرآةٍ تعكس وجوه الذين عبروا التاريخ حاملين سيوفهم ووصاياهم. معتبرًا رواية “ياقوت من خوابي الشقيف“، بأنها جاءت لا لتُروى فحسب، بل لتُستعاد، وتُستجوب، وتُحاور القارئ في وجدانه، وتُوقظه على همٍّ لم يخفت، وإن غطّاه غبار الزمن. وقد أثنى الدكتور جمعة على الراوي عديّ الموسوي، وقد اعتبره بأنه وفي تجربته الروائية الأولى، لا يكتب من خارج التاريخ، بل من قلبه النابض، ومن خوابي حصنٍ لا يزال يحتفظ بأجساد المجاهدين، وبأسرار الأرض التي لا تنسى أبناءها.
لفت الدكتور جمعة إلى أن هذه الدراسة تسعى إلى تحليل نسيج الرواية، واستكشاف بنياتها الفنية والفكرية، من خلال قراءة في لغتها المفصحة عن الهموم، وفي رموزها التي تنطق، وفي سردها المتعدد الأصوات، وفي صورتها البصرية التي تُكمل المعنى. إنها محاولة لفهم كيف يتحوّل الأدب إلى مقاومة، وكيف يُصبح الحصن رواية، والياقوت ذاكرة، والكاتب شاهدًا لا يغيب.
أضاف، في روايته “ياقوت من خوابي الشقيف”، يقدّم عديّ الموسوي عملًا سرديًّا متفرّدًا، لا يكتفي بتقديم حكاية، بل ينسج رؤية فكرية ووطنية عميقة تتخللها طبقات من الرمزية والدلالة التاريخية.
أما في ما يتعلق بسيمائية العنوان: “ياقوت من خوابي الشقيف” فقد رأى الدكتور جمعة بأنه يحمل دلالة رمزية كثيفة، تتجاوز المعنى الظاهري إلى أبعاد روحية ووطنية. وتابع، بأن لفظة خوابي تحيلنا إلى كثافة دلالية تشير إلى وفرة من الرموز، إلى أجساد المجاهدين، إلى تاريخ الحصن الذي احتضنهم، وإلى الأرض التي ارتوت بدمائهم.
رأى أن فرادة رواية “ياقوت من خوابي الشقيف” تتجلى في قدرتها على تحويل العتبات النصية من عناصر تمهيدية إلى بنيات دلالية لا غنى عنها لفهم النسيج السردي. وتحت عنوان العتبات بوصفها خرائط سردية، يتحدث الدكتور جمعة عن أبرز العتبات تلك التي وُسمت بعنوان: “سلالة الياقوت“، والتي تكشف عن شبكة علاقات النسب والقربى بين الشخصيات، وتُضفي على الرواية طابعًا سِيَريًّا يُعمّق البعد الإنساني والتاريخي.
يتابع، في ضوء هذه العتبات، يمكن القول: إن رواية “ياقوت من خوابي الشقيف” لا تُقرأ من سطحها، بل تُستكشف عبر طبقاتها، وكل عتبة فيها هي مفتاح لفهم أعمق، ودعوة إلى تأمل التاريخ من خلال عدسة الأدب.
أما في يتعلق بالشخصيات، فمن وجهة نظر الدكتور جمعة، أن الشخصية الروائية تعدّ حجر الزاوية في البناء السردي، فهي الوسيط الذي تتشكّل من خلاله الأحداث، وتُعبّر عن الرؤى، وتُجسّد الصراعات الداخلية والخارجية في النص. وأضاف، وتتنوّع الشخصيات في الرواية بين نماذج نمطية، وأخرى مركّبة، بين شخصيات فاعلة، وأخرى هامشية، وبين من تمثّل الذات، ومن تُجسّد الآخر.
أما البنية الزمنية والسرد التاريخي، فأوضح الدكتور جمعة أنه في “ياقوت من خوابي الشقيف“، لا يسير الزمن في خط مستقيم، بل يتشظّى ويتداخل، ليخلق نسيجًا سرديًّا متعددًا الطبقات، حيث الماضي لا يُروى بوصفه حدثًا منتهيًا، بل يُستعاد بوصفه حاضرًا متجددًا، والمستقبل يُستشرف من خلال وصايا الموتى وأحلام الأحياء.
لفت إلى أن أحداث الرواية تمتد من لحظة قدوم الفرنجة إلى بلادنا، مرورًا بكل المعارك التي خيضت دفاعًا عن حصن الشقيف، وصولًا إلى وقائع القرن الحادي والعشرين.
يرى الدكتور جمعة بأن التاريخ في الرواية لا يقدم بوصفه خلفية للأحداث، بل بوصفه جغرافيا سردية تتخلل النص، وتُحدّد مسارات الشخصيات، وتُضفي على كل مشهد طابعًا وثائقيًّا. واعتبر أنه من خلال هذه البنية الزمنية المركّبة، تتحوّل الرواية إلى وثيقة فنية، تُعيد كتابة التاريخ من منظور شعبيّ، إنسانيّ، مقاوم. وأشار إلى أنه في رواية “ياقوت من خوابي الشقيف“، لا تُستخدم اللغة بوصفها أداة سردية فحسب، بل تتحوّل إلى كيان حيّ ينبض برؤية الكاتب، ويعبّر عن همومه، وهواجسه، وموقفه من التاريخ والواقع.
تطرق الدكتور جمعة إلى العبارات العامية الواردة في رواية ياقوت من خوابي الشقيف، فيراها تتسلل إلى نسيج السرد كما تتسلل الذاكرة إلى الحلم، لا بوصفها انزياحًا لغويًا عن الفصحى، بل كنبض شعبي يُضفي على النص حرارة الواقع، ويمنحه نكهة محلية لا تُستعار من القواميس، بل تُستمد من أفواه الناس.
من وجهة نظر الدكتور جمعة، فإن العامية تؤدي دورًا مزدوجًا: فهي من جهة تُحدّد ملامح الشخصية، وتُرسّخ انتماءها إلى بيئتها، ومن جهة أخرى تُكثّف اللحظة السردية، وتُضفي عليها طابعًا واقعيًا يُقرّب النص من القارئ دون أن يُفقده هيبته الأدبية.
أضاف، وهكذا، يُثبت الكاتب أن العامية ليست نقيضًا للفصحى، بل شريكة لها في بناء المعنى، وأن الرواية لا تكتمل إلا حين تتكلم بلغتين: لغة الحكاية، ولغة الناس. فـياقوت من خوابي الشقيف ليست فقط رواية عن المقاومة، بل عن اللغة التي تقاوم النسيان، وتُعيد للقول الشعبي مكانته في الأدب، لا بوصفه هامشًا، بل بوصفه قلبًا نابضًا بالحياة.
لفت الدكتور جمعة إلى أن الرواية مشبعة بالرموز التي لا تُستخدم للزينة البلاغية، بل تؤدي وظائف فكرية وتاريخية. فالرمز في هذه الرواية ليس مجرد استعارة، بل هو حاملٌ للمعنى، ووسيطٌ بين الواقع والمتخيّل، بين الذات والجماعة، بين الماضي والحاضر.
يتطرق الدكتور إلى مفهوم التناص حيث يُعدّه من أبرز المفاهيم النقدية الحديثة التي أسهمت في إعادة تشكيل فهمنا للنص الأدبي، إذ لم يعد النص يُنظر إليه بوصفه وحدة مستقلة ومنغلقة، بل ككائن حيّ يتغذّى من نصوص سابقة، ويتفاعل معها ضمن شبكة من العلاقات الثقافية والتاريخية والدينية. ثم يذكر الدكتور جمعة أنواع التناص الواردة في الرواية، فيعددها على الشكل التالي: التناص التاريخي، ثم التناص الديني، والتناص الأدبي والشعبي.
يختم الدكتور علي جمعة كلامه بالقول: لقد نجح الموسوي، في تجربته الروائية الأولى، أن يمنح اللغة صوتًا، والصورة ذاكرة، والرمز حياة. وجعل من الحكاية جسرًا بين الماضي والمستقبل، ومن الرواية وثيقةً لا تُقرأ فقط، بل تُحفظ، وتُتداول، وتُقاوَم بها. معتبرًا بأن ياقوت الشقيف ليس حجرًا كريمًا فحسب، بل هو قلب الرواية، وضميرها، وصرختها في وجه النسيان. ومن خوابيها، تخرج الحكاية، كما يخرج الضوء من العتمة، وكما يخرج الصوت من القبر، ليقول: أنا منها، حقًّا، أنا منها.