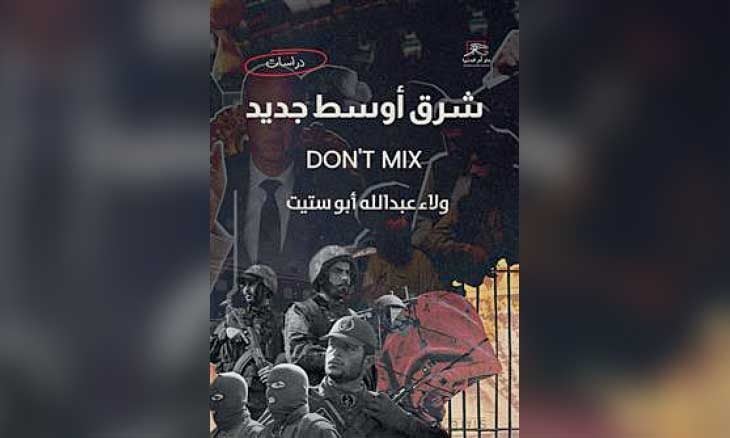كمال القاضي/القدس العربي
مما لا شك فيه أن ما حدث خلال السنوات الماضية وما أطلق عليه الربيع العربي ، قد ألقى بظلاله على المنطقة العربية بأكملها وترك أثرا واضحا على المستوى السياسي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ، حيث وقفت مُعظم الدول ولا تزال على صفيح ساخن منذ انطلاق شرارة محمد بوعزيزي ، الشاب التونسي الذي أشعل النار في جسده احتجاجا على سوء المُعاملة الأمنية ، فاشتعلت معه الثورة التونسية ، وكانت بداية لثورات مُتتالية في مُعظم الدول العربية التي انتفضت شعوبها سعيا لتغيير الأوضاع المأسوية بحسب منظورها آنذاك .
لكن ثمة حقائق ظهرت جليه بعد ذلك تؤكد أن ما جرى لم يكن انتفاضات شعبية جاءت كرد فعل للإحساس بالقهر أو الظُلم ، وإنما قامت الثورات وفق خُطط إستخباراتية استغرق إعدادها عدة سنوات أفنتها الأجهزة المعنية في نثر بذور الفتنه في المنطقة العربية ، وحين بلغت البذور مبلغها من النمو بدأت عمليات التحريض والاشتعال تأخذ مجراها وتُحدث الأثر المطلوب على أرض الواقع .
في كتابها الأحدث في هذا الصدد جمعت الكاتبة الصحفية المصرية المُتخصصة في الشئون الخارجية ، ولاء عبد الله أبو ستيت ، مجموعة من الأوراق والوثائق التي تحصلت عليها بحُكم عملها كمحررة تمتلك من الخبرة والإمكانية ما يؤهلها للربط بين بعض الملفات السياسية ذات الصلة بقضايا الشرق الأوسط ، وما يتعلق منها على وجه الخصوص بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي اقترحه المُستشرق اليهودي برنارد لويس المولود في 31 مايو 1916 والمتوفى في 19 مايو 2018 ميلادية . ويُشير المشروع الشرق أوسطي والذي تم طرحة في شهر مارس 2004 إلى ضم كافة الدول العربية في كيان واحد تحت مُسمى الشرق الأوسط الكبير أو الجديد ، إضافة إلى ضم كل من تركيا وفلسطين وإيران وباكستان وأفغانستان وبعض الدول الأخرى في مرحله تالية ، من بينها إندونيسيا وبنجلاديش وغيرها من دول أسيا الوسطى مثل أوزباكستان وكازاخستان .
قبل اشتعال الثورات العربية تحدثت كوندليزا رايس وزير الخارجية الأسبق بالإدارة الأمريكية عن ما أسمته بالفوضى الخلاقة تعزيزا لفكرة مشروع الشرق الأوسط الجديد ، وفق المقاييس الأمريكية ، وبالطبع تبنت هيلاري كيلنتون بعد توليها منصب وزير الخارجية في فترة حُكم باراك أوباما عام 2009 نفس الفكرة وعملت على تطبيق المشروع بعد التمهيد له عن طريق دعم الثورات العربية والوقوف بجانب العناصر المُتمردة ، لولا أن التقديرات السياسية خانتهم بفعل ما تجدد من أحداث لم تكن في حُسبانهم ، خاصة في القاهرة . وفي سياق مُتصل أشارت ولاء أبو ستيت في كتابها « شرق أوسط جديد « الذي يعتمد على الوثائق والمُستندات وبعض الأوراق المهمة إلى الكثير من المُعضلات والمُعوقات التي واجهت الولايات المُتحدة الأمريكية وحالت دون إتمام المشروع بالطريقة التي تم إعدادها ، وأبرزت أبو ستيت من بين المُعوقات ، قوة الجيش المصري وتنبُه الجهات المُخابراتية إلى المؤامرة الكُبرى التي كانت تُحاك ضد المنطقة العربية ، واستدعت العناية بتسليح الجيش وتنوع مصادر السلاح وإقامة تحالفات مع القوى الرئيسية المُتمثلة في روسيا والصين وبعض الدول الأخرى المتفوقة عسكريا وتكنولوجيا .
غير أن مصر قامت بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول المؤثرة في المنطقة كإيران وتُركيا ، وأزالت أسباب الخلاف وسوء التفاهم مع بعض أشقائها لتقوية الجبهة العربية في مواجهة أي خطر مُحتمل من أي جهة . وتحت عنوان الإطار النظري المفاهيمي ركزت الكاتبة على ردود الأفعال العربية التي تُشكل الرأي العام إزاء أي من القضايا السياسية المطروحة ، فالرأي بحسب ما ذكرت يعني في اللغة الاعتقاد والعقل والتدبر والنظر والتأمل ، بينما تعني كلمة عام ، العام من كل أمر يخص المجموع ويتجاوز اهتمام الفرد . وبرغم الاتفاق على مفهوم الرأي العام اصطلاحيا ، إلا أنه لا يدل في جوهرة على الحقيقة واليقين ، وتنطلق الكاتبة من هذا التعريف إلى فكرة التشكيك في إمكانية الوقوف على مفهوم مُحدد للرأي العام سواء العربي أو العالمي ، فما يُعتقد أنه ثابت اليوم يُمكن أن يتغير غدا ، وما كان ثابتا بالأمس صار مُتغيرا اليوم ، ففي السياسة تحديدا لا يُمكن الجزم بالحقيقة على مستوى الآراء النظرية .
كذلك توضح الدراسة أو الكتاب أنماط الرأي العام وتُقسمها الكاتبة الصحفية ولاء أبو ستيت إلى أنماط إيجابية، تتمثل في أشكال التعبير السلمي عن الرأي كالوقفات الاحتجاجية المُكتسبة بحكم القانون ، والندوات والاجتماعات وحلقات النقاش ، إضافة إلى الاستخدام الطبيعي لوسائل الإعلام في التعبير عن الآراء ووجهات النظر .
أما الأنماط السلبية فتلك التي تقوم على مبدأ المُقاطعة وعدم التفاعل والإضراب عن العمل ، ويأتي قياس الرأي العام كجزء مُنفصل مُتصل مُتضمنا في تحليل الخطاب الإعلامي ووصف وتحليل الدور السياسي للفرد والمجموع . وتختلف المُجتمعات في تعاملها مع الرأي العام باختلاف مستوى الديمقراطية فيها ودرجة الوعي الخاص بكل مُجتمع ، فالمجتمعات الديمقراطية على سبيل المثال تتميز بكل تأكيد عن المُجتمعات التي تحكمها أنظمة استبدادية .
وبالقطع تأتي النتائج مُتغيرة في كل مُجتمع عن الآخر وفق مبادئ التعامل السياسي من جانب الأنظمة مع الشعوب .