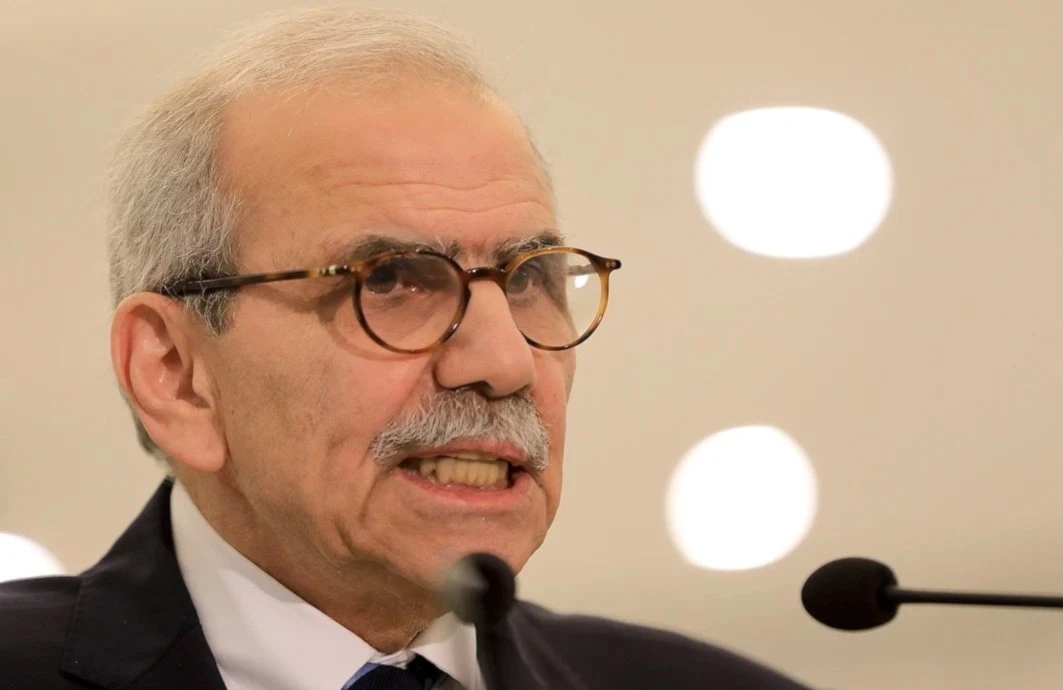إبراهيم الأمين (الأخبار)
صحيح أنّ اللبنانيين ليسوا مُجمِعين - لم يتفقوا يومًا - على موقف واحد من الوصايات الخارجية. فالانقسام كان دائمًا قائمًا بين من يؤيّد ويرحّب، وبين من يعارض ويقاوم. وليس في ذلك أي لغز. فكلّ وصاية خارجية وُجدت لأنها كانت تخدم مصلحة طرف داخلي ما، ولولا ذلك لَما استطاعت أي وصاية أن تصمد أسبوعًا واحدًا.
لكن، وبعدما جرّب اللبنانيون كلّ أشكال الوصاية، بات السؤال الذي لا مفرّ منه: هل يستطيعون فعلًا العيش بلا وصيّ؟
بعيدًا عن الشعارات المُستهلكة عن السيادة والاستقلال والحرية، فإنّ هذا الإجماع لم يحصل يومًا، ولن يحصل. والسبب بسيط ولا يحتاج إلى كثير من التحليل: لا يمكن للبنانيين أن ينعموا باستقلال كامل، ما داموا غير متّفقين على هوية وطنية جامعة.
فثمن هذا الاتفاق يتجاوز قدراتهم، كما أثبتت التجارب. فلا هم في وارد إنتاج اقتصاد مستقلّ حتّى بحدوده الدنيا، ولا يمتلكون قوة عسكرية تحمي هذا الاستقلال.
وعدم تحقّق هذين الشرطين لا يعني أن لا فرصة لتحقّقهما، بل إنّ مسار التجارب منذ نشوء الكيان يؤكّد وجود تباين عميق حول نمط العيش، وبالتالي حول صياغة الهوية الوطنية نفسها، وهو ما يقود حكمًا إلى العجز عن توفير مقوّمات المناعة الاقتصادية والقوّة العسكرية الدفاعية.
وإلى أن تحين اللحظة التي تُجبِر اللبنانيين، عبر ثورة حقيقية أو عبر انقلاب قسري، على تغيير سلوكهم، ستبقى الجماعات اللبنانية غارقة في انقساماتها. وكما جرى في كلّ مرحلة سابقة، سنعيش لحظات ذروة من الاحتراب الأهلي، سواء اتّخذ طابعًا سياسيًا أو اقتصاديًا أو حتّى عسكريًا. وهي حالنا اليوم بالفعل. فمجرّد مراجعة سريعة لخطب ومواقف القوى السياسية ذات التمثيل الشعبي الواسع تكشف بوضوح مدى عمق هذا الشرخ.
ومع ذلك، يبقى السؤال المُلِحّ أمام الجميع: كيف يمكن تفادي الأسوأ؟ والأسوأ هنا هو الانزلاق إلى احتراب عسكري جديد، من خلال حروب أهلية متنقّلة بين منطقة وأخرى، وبين طائفة وأخرى، وبين جماعة وأخرى؛ حروب خبرها اللبنانيون مرارًا، ويبدو أنهم لم يتعلّموا درسها بعد.
وفي هذه الأيام، نشهد جولة جديدة من الصراع الداخلي. وإذا كان البعض يعتقد بأن الخلاف بين أكثرية وأقلية قادر على حسم المشهد، فهو لا يفهم طبيعة لبنان. ففي هذا البلد يكفي أن تمتلك أي جماعة جمهورًا مؤمنًا بقضيتها، حتّى تبقى الساحة مفتوحة لسجالٍ ظاهر أو مكتوم؛ سجال سرعان ما يتغذّى على أي تطوّر إقليمي، ليعيد لبنان إلى نقطة الصفر، وكأنّ شيئًا لم يتغيّر.
هذه حقيقة، وليست وهمًا أو خيالًا. ألم يظنّ اليمين اللبناني، بعد قيام كيان العدوّ عام 1948، أن الأمور حُسمت لمصلحته، فانصرف إلى إدارة عقيمة للوضع الداخلي تقوم على إرضاء الغرب ومعاداة العرب ولو سرًّا؟
ولم تمضِ عشر سنوات حتّى انفجرت أحداث 1958، ومع أنها سمحت ببعض التعديلات في طبيعة الحراك السياسي، إلا أن الوضع لم يستقرّ، لأن اليمين نفسه ظلّ متعنّتًا، غافلًا عن أهمية العامل الإقليمي في المسألة اللبنانية، خصوصًا ما يتصل بالصراع مع "إسرائيل".
وما افتُرِض أنها تسوية راسخة لم تُعمِّر عقدًا إضافيًا، إذ جاءت تطوّرات ما بعد نكسة 1967 لتفتح لبنان على موجة جديدة من الاضطرابات التي دفعت البلاد، خلال سنوات قليلة، نحو الحرب الأهلية عام 1975.
ومع ذلك، قاتل اليمين اللبناني بشراسة غير مسبوقة، وطرق كلّ الأبواب الخارجية، وباع نفسه لكل "شياطين" العالم، وصولًا إلى الذروة مع الاجتياح "الإسرائيلي" عام 1982.
ويومها، اعتقد بأن الأمور عادت لتستقرّ وفق ما يناسبه، وتصرّفت غالبية لبنانية، بما فيها جمهور القوى التي هُزمت، وكأنّ هذا قدرٌ محتوم للبنان. لكنّ سنوات قليلة كانت كافية للعودة لا إلى الحرب الأهلية فقط، بل أيضًا إلى كسر الاحتلال "الإسرائيلي" نفسه، وإلى خروجٍ قسري لكل القوى الدولية التي جاءت لحماية "المُنتَج" "الإسرائيلي" الجديد.
غير أن الهزيمة القاسية التي مُني بها اليمين اللبناني لم يُقابلها نجاح باهر للقوى المقابِلة. فهذه القوى نفسها بقيت محكومة بقواعد اللعبة ذاتها في النظام اللبناني، وسارعت بدورها إلى الاستعانة بسورية لحماية مكاسبها. ومع ذلك، لم ينجُ أيّ طرف، من اليمين ذاته إلى القوى المقابِلة في الشارع الإسلامي، من الانخراط في أتون حروب أهلية متنقّلة لم تُبقِ حصانة لمنطقة أو جهة أو جماعة.
وكانت الذروة في الاقتتال الذي اجتاح الشارع المسيحي، قبل أن تأتي "المعجزة" من تطوّر إقليمي كبير عصف بالمنطقة بعد مغامرة صدام حسين في الكويت وما تلاها من أحداث دفعت اللبنانيين قسرًا إلى اتفاق الطائف. يومها أدرك الجميع أن هذا الاتفاق لا يمكن تطبيقه بلا وصاية خارجية، فتمّ التفاهم بين سورية والولايات المتحدة والسعودية، مع ترك الإدارة التفصيلية لدمشق من دون أن يكون الطرفان الآخران خارج المشهد.
وتمثّلت الحصة الأميركية - السعودية في الموقع والدور اللذين تولّاهما الرئيس الراحل رفيق الحريري، قبل أن يأتي الانقلاب من الخارج مرة أخرى بعد أحداث 11 أيلول والغزو الأميركي للمنطقة كلّها، سواء في الدول التي اجتاحها مُدمِّرًا كالعراق وأفغانستان، أو تلك التي سلّمت من دون قتال كدول الخليج العربية ومصر، بينما عاندت سورية فنالت نصيبها من الحصار والضغط.
وعندما قرّر التحالف الأميركي - السعودي الانقلاب على الصيغة التي قامت قبل أكثر من عقد وطيّ الصفحة التي كانت باسم رفيق الحريري، جاءت ذروة أخرى مع حرب "إسرائيل" المجنونة عام 2006، التي كان يُفترض أن تحقّق ما لم يتحقّق قبل ثلاث سنوات: كسر المقاومة من جهة، وإخضاع سورية بالكامل من جهة أخرى. ودفع نجاح المقاومة الإسلامية في صدّ العدوان وإفشاله الجميع إلى البحث مُجدّدًا عن صيغة حكم مستقرّة للبنان، فكان "اتفاق الدوحة"، أو النسخة المُعدّلة من الطائف، تسويةً كان واضحًا للجميع أنها قائمة على توازنات خارجية ولا قدرة لها على الحياة بمفردها.
وإلى أن يأتي مؤرّخ قادر على شرح العناصر الأساسية التي أطلقت موجة الحراك الشعبي عام 2011، وما أدّت إليه من انقلابات هائلة في دول عربية مركزية مثل مصر وليبيا واليمن وتونس، ومن ثمّ سورية، سنبقى ننتظر حلّ "أحجية الربيع العربي" لندرك أن نصيب لبنان منه كان الدخول في مرحلة الفوضى الكبرى.
فالحكم لم يعد مستقرًا، والاقتصاد لم يعد قادرًا على العيش بشكل طبيعي، ولم تعد هناك قوة تكبح موجة الشدّ الطائفي والمذهبي بين اللبنانيين. وهي مرحلة تخلّلتها أحداث كثيرة كشفت عمق الخلاف حول الهوية الوطنية، وأظهرت العجز عن إنتاج إدارة اقتصادية عاقلة لموارد الدولة أو حتّى لموارد الأفراد داخلها.
وإذا كانت المقاومة، مُمثّلة بحزب الله، تشكّل القوّة الأكثر حضورًا في المشهد العام خلال هذه المرحلة، فإن ذلك لا يعني أنّ الحزب كان يُظهر اهتمامًا خاصًا بالشأن الداخلي. فهو قبل بالتسويات انطلاقًا من قاعدة عدم المسّ بأيّ من أعمدة النظام اللبناني، في ما كانت خلاصة تفكير قيادته تقول، إن لا أحد قادرٌ على معالجة المعضلة اللبنانية. وهذا يعني أنّ المقاومة كانت مُستعِدّة لعقد التسويات الداخلية بما ينسجم مع حماية مشروعها المتعلّق بالصراع مع "إسرائيل".
وقد دفعت هذه المقاربة الأمور تدريجيًا نحو مزيد من التشابك، وصولًا إلى "طوفان الأقصى"، حين واجهت المقاومة امتحانها الأكبر. ومع ذلك، اختارت مقاربة اعتقدت بأنّها عبر "حرب الإسناد" تقوم بواجبها تجاه الفلسطينيين، وتجنّب لبنان في الوقت نفسه تبعات الحرب الكبرى. غير أنّ اللعبة لم تكن بيد طرف واحد، وهو ما قاد إلى الذروة الجديدة: الحرب "الإسرائيلية" الكبيرة قبل أكثر من عام، والتي انتهت برسم توازن جديد تحوّل فيه حزب الله والمقاومة إلى طرف غير أساسي في المعادلة الحاكمة.
وإذا كان البعض قد توقّفت عنده الحياة يوم استشهاد القائد الأممي السيّد حسن نصر الله، فإن ذلك لا يعني أنّ التحالف الأميركي - السعودي قرّر التوقّف عن تنفيذ خطّته للاستيلاء مُجدّدًا على لبنان. وعندما قبلنا باتفاق وقف إطلاق النار بالشكل الذي جرت عليه الأمور في نهاية تشرين الثاني من العام الماضي، كنّا قد وقّعنا، عن وعي أو عن ذهول، على الدخول في مرحلة جديدة. ومن ارتضى بطريقة اختيار العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، كان قد وقّع بيده وقلمه على إعلان جديد، عنوانه سقوط "اتفاق الدوحة"!