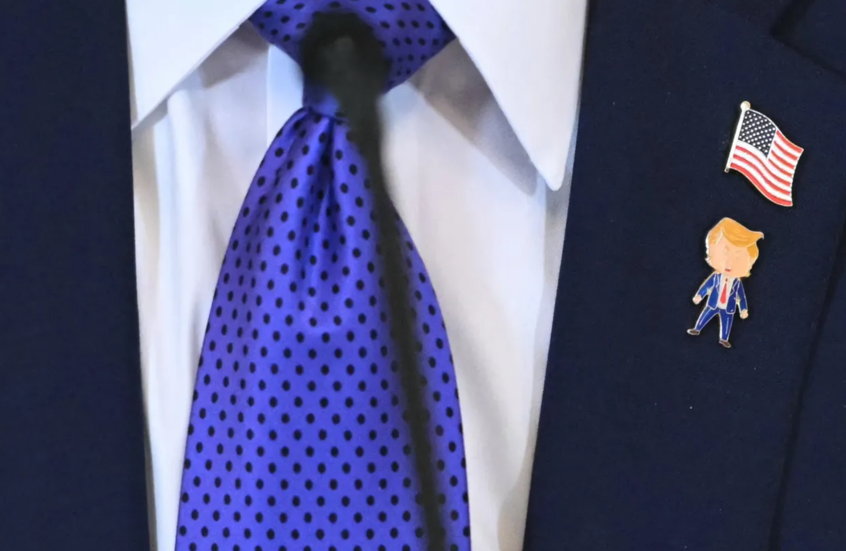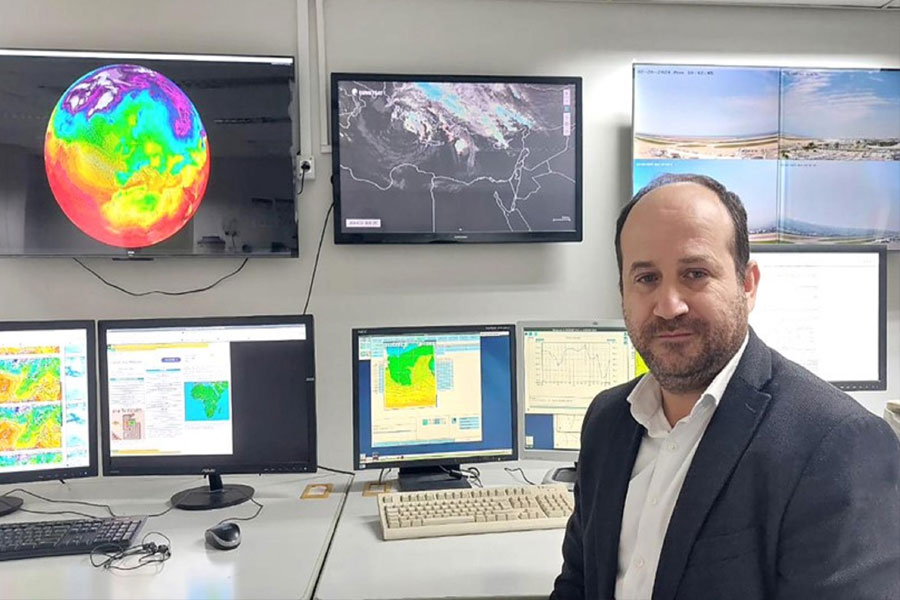محمد حسن سويدان/The Cradle عربي
إن هناك حربًا نفسية تُشن لجعل التطبيع مع إسرائيل يبدو أمرًا لا مفر منه، ولكن مقاومة لبنان ليست في ساحة المعركة فحسب، بل هي أيضًا في معركة الإدراك.
منذ توقُّف الحرب في لبنان في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، يتعرّض اللبنانيون لحملةٍ إدراكيةٍ ضاريةٍ تُسوِّق لفكرة التطبيع مع دولة الاحتلال
بعد كلام أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم الجمعة في 18 نيسان الجاري أصبح واضحًا أن معظم ما يُروّج في الإعلام اللبناني ليس إلا تعبيرًا عن أحلام ضائعة. فلفترة طويلة شاركت شخصيات سياسية وإعلامية إلى جانب وسائل الإعلام في الترويج لسرديّات حول حتميّة خيار نزع سلاح المقاومة في لبنان وذهاب لبنان نحو التطبيع مع كيان الاحتلال. إلا أن كلام الشيخ قاسم كان واضحًا: السلاح لن يُنزع وإسرائيل عدو أبدي.
استراتيجية إسرائيل الإدراكية للوصول إلى التطبيع
تشير ورقةٌ بحثية صادرة عن حلف شمال الأطلسي إلى أنّ جوهر الحرب الإدراكية لا يقتصر على «الانتصار من دون قتال»، بل يتعدّاه إلى شنِّ هجومٍ على ما يفكِّر فيه المجتمع، وما يحبّه، وما يؤمن به، عبر إعادة تشكيل رؤيته للواقع ذاته. إنّها معركةٌ على المجال الذهنيّ تهدف إلى تفكيك البنية المنطقية التي يستند إليها الوعي الجمعي، وكسر المحرَّمات التي طالما حكمت سلوكه السياسي. وما إن تُهشَّم هذه الأسوار النفسية حتى يُصبح تمريرُ أجندة الطرف المعادي مسألةَ وقتٍ لا أكثر، لأنّ أيّ تبدّلٍ جذري في سياسات الدولة يتطلّب حدًّا أدنى من قبول الجمهور؛ فإذا غاب هذا القبول ظلّ التغيير هشًّا ومعرَّضًا للارتداد.
منذ توقُّف الحرب في لبنان في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، يتعرّض اللبنانيون لحملةٍ إدراكيةٍ ضاريةٍ تُسوِّق لفكرة التطبيع مع دولة الاحتلال بوصفه «خيارًا عقلانيًا» و«مصلحةً وطنية». يقود هذه الحملة مجموعة من الفاعلين: سياسيون، ونخب، ومحطّات إعلامية محلية وأجنبية، تعمل بتناغمٍ ملحوظ على إعادة تأطير الصراع ومفاهيمه. وكما في أيّ حربٍ أخرى، لا يمكن الصمود بلا فهمٍ دقيقٍ لاستراتيجية الخصم: تفكيك خطابِه، رصدُ أدواته، ثمّ بناءُ خطةِ دفاعٍ معرفيةٍ تُحصّن الوعي، وتُفشل محاولة اختراقه.
بعد متابعة دقيقة للخطوات المعتمدة من قبل مُروّجي التطبيع وقراءة دقيقة للنظريات العلمية المرتبطة بالمعركة الإدراكية تبيّن أن ما يحدث في لبنان من ترويج للتطبيع ليس عشوائيًا، بل هو عبارة عن "سلسلة عمليات" تعتمدها الشبكات الحليفة لواشنطن لجرّ المجتمع نحو التطبيع. ثماني خطواتٍ متتابعة، تبدأ بإعادة تأطير المفاهيم، وتنتهي بمحاولة إضفاء الشرعيّة الأخلاقية على العلاقات مع الاحتلال، تشكّل خريطة الطريق التي يتقدّم عليها هذا الهجوم الإدراكي. بإضاءة كلّ خطوةٍ وشرح آلياتها، نرصد كيف يُنسَج خطابٌ جديد يُهمّش سجلات الصراع، ويُجمِّل صورة الاحتلال، ويُعيد تعريف المصلحة الوطنية بما ينسجم مع أجندة الخارج. إنّ فهم هذه المراحل الثماني، بما تحمله من أدواتٍ وأطرافٍ ومسارات تأثير، هو الشرط الأوّل لإبطال مفاعيلها ووضع استراتيجيّة دفاعٍ معرفيّة تقي اللبنانيّين الوقوع في فخّ "التطبيع المُحتَّم".
1. المرحلة الأولى: التأطير وتشكيل السرد (إعادة التأطير المعرفي)
تعتمد إعادة التأطير على فكرةٍ بسيطة: طريقة عرض أي قضية هي التي تُحدِّد كيف يفهمها الناس. يشرح روبرت إنتمن في "نظرية التأطير" (1993) أن الإطار يشبه عدسة الكاميرا؛ يقرّب بعض التفاصيل ويُغفل غيرها، فيُوجِّه الانتباه من كلماتٍ مثل «العدو» و«الاحتلال» و«المقاومة» إلى مفاهيمٍ أكثر هدوءً مثل «التعايش» أو «التكامل الإقليمي». حين يتغيّر هذا الإطار، يتغيّر شعور الجمهور بما هو ممكن، فتترسّخ أفكارٌ جديدة عن المصلحة الوطنية، وتصبح الأرضية مُهيّأة لتبديل الموقف السياسي.
لتنفيذ هذا التحويل، يعمل المُروِّجون بخطواتٍ متدرجة. أولًا، إدخال أطر إيجابية تركّز على مكاسب التطبيع: ازدهار اقتصادي، استثمار أجنبي، فرص عمل، واستقرار أمني. ثانيًا، استخدام لغةٍ عاطفية تبعث على الأمل بدلًا من لغة الخوف: فبدل «الخطر الوجودي» يُقال «فرصة التعايش»، وبدل «عدوٌ دائم» يُقال «شريكٌ محتمل». تُدعَم هذه اللغة بأمثلة ملموسة، مشاريع كهرباء عابرة للحدود أو ممرات تجارية، ويُردِّدها سياسيون وإعلاميون وخبراء اقتصاد حتى يعتاد الجمهور سماعها. ومع كثرة التكرار، يخرج التطبيع من إطاره القديم، ويدخل في إطار سردي جديد يصوَّره كخيار منطقي يجلب الرخاء، بدلًا من تصويره كتراجع يهدد الهوية.

2. المرحلة الثانية: إزالة الحساسية المعرفية تدريجيًا (تأثير التعرّض المتكرر)
تقوم هذه الخطوة على مبدأ نفسي بسيط وضعه العالِم زاجونك عام 1968 والذي يقول إنه كلّما رأى الناس فكرةً أو صورةً مرّاتٍ متتالية، خفَّ ردُّ فعلهم الانفعالي تجاهها، واكتسبت صفة المألوف بدل الغريب أو المهدِّد، فيميلون إلى تقبّلها أكثر. تمامًا كما يختفي شعور الرهبة من شارعٍ جديد بعد المرور فيه يوميًّا، يخفُّ الرفض تجاه فكرةٍ كانت مرفوضة حين تظهر في الإعلام بصورة هادئة ومتكرّرة. بعبارة أبسط، التعوّد يقتل النفور: ما كان يثير القلق بالأمس يصبح اليوم مسألةً عاديّة، وغدًا قد يغدو مقبولًا، بل وربّما مُحبَّذًا.
أمّا على أرض الواقع، فيُطبَّق هذا الأسلوب عبر «تقطير» فكرة التطبيع في مختلف القنوات الإعلاميّة، حتى تصبح جزءًا من الضجيج اليومي. على سبيل المثال، نشاهد هذه الخطوة اليوم في الدعوة التي وُجِّهت مطلع آذار 2025 إلى وفودٍ سياسيّة لبنانيّة وإسرائيليّة لعقد اجتماعات غير مباشرة برعاية أميركيّة لدرس ترسيم الحدود البرّيّة وتسوية النقاط الثلاث عشرة المتنازَع عليها. وفي كل فترة يتعرّض الجمهور للفكرة ذاتها مرّةً جديدة: «التطبيع» لا بوصفه تنازلًا، بل كخطوة تقنيّة لحلّ مشكلة الحدود. هذا التكرار، في الشاشات، وفي الأعمدة الصحافيّة، وفي منصّات وسائل التواصل، يُنفِّذ بدقّة مبدأ التعرّض المتكرّر؛ فكلّ ظهورٍ جديد يلمّع الفكرة ويُخفّف مقاومتها، إلى أن تصبح مألوفة لا تُثير سوى فضولٍ عابر، وهو الشرط النفسي الضروريّ لتمريرها سياسيًّا لاحقًا.
3. المرحلة الثالثة: تعديل الهوية الاجتماعية (تفاعل المجموعات)
تستند هذه المرحلة إلى "فرضية التفاعل بين المجموعات" التي وضعها عالِم النفس غوردون ألبورت عام 1954. تقول الفرضية إن اللقاءات الإيجابيّة المنظَّمة بين أعضاء جماعتين متخاصمتين، وفي ظروفٍ متوازنة ومحايدة، تُخفِّف التحيّز المتبادل، لأنّ الأفراد يكتشفون أوجُها مشتركة تجعل صورة «الآخر» أقل تهديدًا وأكثر إنسانيّة. مع تكرار هذه التجارب ينتقل الإحساس بالانتماء من إطار «نحن ضدّهم» إلى إطارٍ أوسع مبنيٍّ على مصالح وقيم مشتركة، فتتغيّر الهويّة الاجتماعيّة تدريجيًا من هوية صِدام إلى هوية تعاون.
لتفعيل هذا التحوّل تُفتَح قنوات تواصل غير سياسيّة بين لبنانيّين وإسرائيليّين عبر أطرٍ دوليّة محايدة: مؤتمرات علميّة، ورش عمل حول البيئة، أو برامج إغاثيّة يشارك فيها باحثون وأطباء من الجانبين. على سبيل المثال، شهد مؤتمر «أزمة المناخ في شرق المتوسّط والشرق الأوسط» الذي استضافته لارنكا في أيلول 2024 مشاركة 250 عالِمًا وصانعَ قرار من 22 دولة، من بينها لبنان و"إسرائيل"، للتباحث في حلول مشتركة لأزمة المناخ. هدف مثل هذه النشاطات أن يترسّخ في ذهن الجمهور أن التعاون العلمي ممكن، بل مُفيد، وبذلك تُعاد صياغة الهوية الجماعيّة لتقبل التواصل، فتُزال إحدى أهم العقبات النفسية أمام التطبيع.
4. المرحلة الرابعة: السلطة وتأييد قادة الرأي
يعتمد مهندسو التطبيع في هذه المرحلة على تحيّزَين نفسيَّين اثنين. الأوّل هو انحياز الناس للطاعة، حين يصدر التوجيه من شخصيةٍ نافذة (Authority Bias) كما أوضحه ستانلي ميلغرام في تجربته الشهيرة عام 1963: مجرّد وجود "شخصٍ ذو سلطة" يجعل كثيرين يراجعون قناعاتهم لئلّا يظهروا معارضين له. التحيّز الثاني هو الدليل الاجتماعي (Social Proof) الذي درسه روبرت سيالديني (1984)، ومفاده أنّ الفرد يميل إلى محاكاة الرأي السائد إذا شعر أنّ "الجميع" يسيرون في الاتجاه نفسه. ومن ثم، عندما يتبنّى بعض من في السلطة، أو ممثّليهم، ويُصار إلى هجمة إعلامية تروّج للتطبيع وكأنه مطلب الأكثرية تصبح الأفكار التي كانت شائكة، مثل التطبيع، أقلّ كلفة نفسيّة على الجمهور، فتتآكل مقاومة الناس الداخلية، ويصبح التأييد مجرّد خطوة إضافية في مسار يبدو طبيعيًا ومتوافقًا مع إجماع النخبة.
مثلًا، من يسمع حديث الإعلامي مارسيل غانم الذي قال فيه إنّ "المعادين لإسرائيل قلّة قليلة على كوكب الأرض"، طارحًا التطبيع كاتّجاهٍ عالميّ لا يُقاوَم، يعتقد أن أغلب اللبنانيين يؤيّدون التطبيع وأن من يرفض هذا الطرح هم قلّة قليلة. إلا أن الحقيقة في مكان آخر. فقد أظهر استطلاع للرأي للدولية للمعلومات أن هناك شبه إجماع لبناني على اعتبار اسرائيل عدوًا أولا (75.3%). ولكي يتمظهر خداع مارسيل غانم بشكل أكبر يمكننا الاستناد إلى استطلاع رأي نشره الباروميتر العربي يظهر أن قلّة قليلة من الناس في غرب آسيا يؤيّدون التطبيع مع دولة الاحتلال، لا تتجاوز 13%. وعليه فإن حديث غانم لا يُمثّل سوى نسبة ضئيلة جدا من اللبنانيين، ومن سكان غرب آسيا.
5. إدارة التنافر المعرفي (التغيير السلوكي التدريجي)
عندما يتصرّف الإنسان بطريقةٍ لا تنسجم مع قناعاته يشعر بعدم ارتياحٍ نفسي يسمّيه علماء النفس «التنافر المعرفي». وبحسب ليون فستنجر (1957)، يسعى الفرد تلقائيًا إلى حلّ هذا التوتّر إمّا بتغيير سلوكه أو، وهذا ما يهمّنا هنا، بتعديل أفكاره حتّى تبدو أفعاله منسجمة معها. يستغلّ مهندسو التطبيع هذه الآليّة بتشجيع اللبنانيّين على خوض تجارب تعاون صغيرة وغير مباشرة مع أطرافٍ إقليميّة بينها إسرائيل. فمجرّد المشاركة في مشروعٍ مشترك، ولو بيئيًا أو إنسانيًا بحت، يخلق فجوة بين السلوك (تعاون) والموقف المسبق (رفض التطبيع). ومع تكرار السلوك يصبح من الأسهل على الفرد أن يُليّن موقفه كي يرفع عن نفسه التوتّر الداخلي.
يُطبَّق هذا الأسلوب عمليًّا عبر إدخال مبادرات إقليميّة «محايدة» تُطرح بصيغة إنسانيّة. مثلا، في شباط/فبراير 2024 نشر الاتحاد من أجل المتوسّط (UfM) تقريره عن مبادرة GreenerMed 2030، مبيّنًا أنّ لبنان شارك إلى جانب دولة الاحتلال في مشاريع بيئيّة إقليميّة تشمل مكافحة التلوّث البلاستيكي في البحر المتوسّط. هذه المشاريع، التي تُموَّل وتُشرف عليها جهات أوروبيّة، تجمع فرقًا بحثيّة ومنظّمات مجتمع مدني من البلدين في ورش عمل ودورات تدريب ومسوحات ميدانيّة مشتركة. في هذه المشاريع، تُقدَّم المشاركة اللبنانيّة بوصفها "مسؤولية بيئيّة" لا علاقة لها بالسياسة، لكنّها في الواقع توفّر "سلوكًا تعاونيًا" صغيرًا يخلق تنافرًا داخليًّا لدى المشاركين والجمهور: كيف نستطيع رفض أيّ تواصل مع إسرائيل، بينما نتقاسم معها منصةً دوليّة لحماية البحر؟ ومع تكرار هذا النمط في مؤتمرات وفعاليات لاحقة، يصبح من الأسهل نفسيًا تعديل الموقف القديم لإزالة التناقض، فتترسّخ تدريجيًا فكرة أنّ التعاون، حتى مع المحتل، يمكن أن يكون "طبيعيًا" إذا صيغ بغطاء إنساني أو بيئي.
6. المرحلة السادسة: التدرّج وتقنية "القدم في الباب"
ترتكز هذه المرحلة على مبدأ «القدم في الباب» الذي عرضه فريدمان وفريزر (1966): إذا وافق الناس على طلب صغير غير مُكلف، ترتفع احتمالات قبولهم لاحقًا طلبًا أكبر ذي دلالة سياسية. الفكرة بسيطة: كلّ خطوة متواضعة تفتح الباب نفسيًّا لخطوة أوسع، لأنّ الفرد يفضّل الاستمرار في مسارٍ بدأه بالفعل بدل أن يناقض سلوكه السابق. فمثلًا، المشاركة في مناسبات علمية مع وفود الاحتلال الإسرائيلي تفتح المجال لتوسيع المشاركة وحتى "التعاون" في ملفات أخرى.
7. المرحلة السابعة: الحدّ من التهديدات المُتصوَّرة
في علم النفس الاجتماعي، تنخفض مقاومة الناس لأية فكرة عندما تتقلّص مشاعر الخوف المصاحبة لها؛ يسمّى ذلك خفض التهديد المدرك. فإذا تحوّل العدو من صورة «الخطر الوجودي» إلى شريكٍ محتمل في قضية نافعة، تتراجع الحاجة الدفاعيّة، ويصبح التفاوض معه أقلّ استفزازًا. ولذلك يعمد مروّجو التطبيع في لبنان على نقل إسرائيل من خانة الطامع في مصالح لبنان إلى خانة "الشريك المحتمل لتحقيق التكامل الإقليمي".
8. المرحلة الثامنة: التطبيع الاجتماعي وتأثير الأقران (إعادة تشكيل المعايير الاجتماعية)
تُبنى هذه الخطوة على مبدأ التأثير الاجتماعي المعياري الذي كشفته تجارب سولومون آش في خمسينيات القرن الماضي: يميل الأفراد إلى تبنّي الموقف الذي يبدو شائعًا داخل مجموعتهم الاجتماعية، حتى لو تعارض مع قناعاتهم الأوليّة. عندما يرون أقرانهم أو شخصيّات يحترمونها تتصرّف وكأنّ التعاون مع الطرف الآخر أمرٌ عادي، يشعرون بضغطٍ خفيّ للتماشي مع «المعيار الجديد» كي لا يظهروا شاذّين أو متخلّفين عن الركب. وهذا بالضبط ما كان مطلوبا من النائب وليد البعريني عندما قال "نعم للتطبيع إذا كان يحمي من الاعتداءات… نعم للتطبيع إذا كان يمنح لبنان سلامًا وازدهارًا". فالهدف كان خرق مجموعة اجتماعية وهي "الطائفة السنية" من خلال تصريح نائب سنّي يدعو للتطبيع.
.png)
ممّن يجب أن نحذر؟
إنّ الترويج لـ«سلام» مع كيان إسرائيليّ مُحتلّ ليس مجرّد رأيٍ سياسيّ عاديّ؛ إنّه فعلٌ يقع صريحًا في خانة خيانة الدولة، ويُعرّض صاحبه للمُلاحقة الجزائيّة في لبنان. لقد ثبُت قانونيًا أنّ أي صلات مع إسرائيل محرَمة، إذ يتناول قانون العقوبات مسألة التعامل مع أراضيه، حيث تنص المادة 285 على أنّ كلّ لبناني أو مقيم في لبنان، يُقدِم أو يحاول، بصورة مباشرة أو عبر وسيط، على إجراء أيّ صفقة تجارية—شراء أو بيع أو مقايضة—مع أحد رعايا العدو أو أي شخص يقيم في بلاده، يُعرَّض نفسه لعقوبات جنائية. كما يحظر القانون رقم 1/1955 (قانون مقاطعة إسرائيل) على أيّ شخصٍ طبيعيّ أو معنويّ عقدَ أيّ اتفاقٍ «من أيّ نوعٍ كان» مع أفرادٍ أو هيئاتٍ مُقيمة في إسرائيل أو تعمل لمصلحتها، ويقضي بعقوبات جزائيّة وإداريّة تصل إلى السجن ومصادرة الأموال.
من هذه الزاوية القانونيّة الحاسمة، يصبح أيّ دعوة إلى التطبيع أو «السلام» غطاءً لفظيًّا لخرقٍ فادحٍ لسيادة لبنان، إذ تُضفي شرعيّة على كيانٍ استيطانيّ عدوّ ما زال—حتى هذه اللحظة—يعتدي على الأرض والشعب اللبنانيّ، ويشنّ حرب إبادة ضد شعبنا العربيّ في فلسطين. إنّ المطالبة بمدّ اليد لقاتلٍ متلبّسٍ بدماء الأبرياء هي طمسٌ متعمَّد لجرائمه وإقرارٌ ضمنيّ بحقّه في اغتصاب الأرض. من منظور الأخلاق السياسيّة والقانونيّة، يُنزِل هذا الموقف بصاحبه إلى درك العار الوطنيّ، لأنّ اللبنانيّ الأصيل عزيزٌ في أرضه: لا يساوم على دم شهدائه، ولا يهادن من طَمِعَ في ثروته أو سيادته.
لهذا كلّه، فإنّ الأصوات الداعية إلى «سلامٍ» مع إسرائيل لا تُسيء إلى نفسها فحسب، بل تتطاول على التضحيات الغالية التي قدّمها الجيش والمقاومة دفاعًا عن الكرامة الوطنيّة. إنّها تُحاول—عبثًا—تطبيع ما لا يُطَبَّع، وتغليف الاحتلال بجلباب «التعايش» بينما المقابر الجماعيّة في غزّة ومشاهد الدمار في جنوب لبنان تشهد على حقيقة العدوان المستمرّ. وسيبقى القانون، ومعه ضمير الأكثريّة الساحقة من اللبنانيّين، بالمرصاد لكلّ من يتجرّأ على منح الكيان مكافأةً سياسيّة مقابل جرائمه. في الميزان الوطنيّ، هؤلاء وصمة عار؛ أمّا لبنان الحقيقي، فسيظلّ عصيًّا على التطويع، متشبّثًا بحقّه في المقاومة والكرامة والسيادة.